بقلم/ محمد سرور
خاص/مجلة القدس، للأسف الشديد،تعاني منظومة القيم في مخيماتنا شرخاً عميقاً ومزمناً، لأننا اعتدنا استحضار الأسلوبالقبلي والعشائري في التعامل مع اختلافنا وخلافنا على أية قضية تعنينا. دائماً نضيعالبوصلة ونقلب عربة أولوياتنا، حتى "شعرة معاوية" التي كان كبارنا وحكماؤنايتشددون في الحفاظ عليها لا نعيرها اهتماماً، رغم كونها تشكل ألغباء الدبلوماسي في عالمي الفكر السياسي والاجتماعي علىالسواء.
تجاوزنا في انقساماتناوأحقادنا الحدود التي كانت تشكل ضابطاً وردعاً على المستويين الأخلاقي والإنساني، ممايدل على خطورة المسار الذي وصلته ثقافاتنا وممارساتنا بحق بعضنا البعض.
المشكلة تبدو جليةحين نُجري مقارنة بين عينات الصراعات التي جرت وتجري في العديد من بلداننا العربية،أكانت هذه الصراعات بين نظام الحكم ومعارضيه أو بين فئات من الشعب أو قواه السياسيةأو الطائفية والمذهبية، فإن القاسم المشترك ألقيمي، الذي ندعيه ونشتدق بتمايزه وقوةنفوذه، سرعان ما ينهار تماماً، ويأخذ مكانه الخطاب العصبي المتوتر والخارج على أدبياتالاعتدال والتوازن والشفافية، كأن أسهل الدروب والأساليب في التعامل مع الآخر المختلفهو نبذه وفتح مصاريع الهجاء على آخرها، وبالتالي استباحته على المستويات كافة.
للأسف، يوجد لهذهالظروف فلاسفتها ومروجوها وخطباؤها الذين تملأ ثرثراتهم وصيحاتهم أثير بلداننا ومسامعمجتمعاتنا، ونتيجة الانقسامات المتعددة الأشكال والأنواع والمصالح والنوازع نرى هؤلاءمطمئنين إلى الفئة التي يخاطبونها والتي لا تحتاج أصلاً لمن يصف لها واقع الحال أو كيفية التعامل معه السببالتدجين السياسي والطائفي والمذهبي الذي تجاوز حد القدرة على التفكر والاستدراك.
بعض الذين يجرؤونعلى الاعتراض والامتعاض من واقع الحال الرديء أو غير المنسجم مع آرائهم وتطلعاتهم لاتعفهم لغتهم العقلانية والمنطقية والمسالمة دائماً من استسهال قدحهم وذمهم بالتخوينوالتهديد وتصنيفهم كأفراد محسوبين على الفريق الآخر أو منتمين إليه، وبالتالي تتلوثوتنهار فكرة النية الحسنة الحريصة على تبريد التناقضات ولم الشمل بين أهل البلد الواحدأو القضية الواحدة.
إن مجرد وجود هذهالعيِّنة القليلة في مجتمعاتنا ينظر إليها بعين الشك والخطورة. جريمتها أنها خارج النمطالعصبي ومعترضة عليه، ورغم محدودية مفعولها يرى سادة الانقسام والإيقاع الاستفزازيوالغاضب أن هؤلاء مزعجون، وإن تمادوا أكثر سوف يصبحون خطرين، كونهم يحاجون بلغة العقلومصالح الأكثرية الصامتة الخطب والمواقف المؤججة للمشاعر والغرائز، وبالتالي يتكاثرونككرة الثلج.
ولأننا نستهل مغادرةقيمنا والذهاب إلى الغوغاء والضجيج يلزم أهل هذه الطريق شيئاً من التمهيد واستحضارالعناصر التقليدية للهجاء والذم والاتهام، لأنهم وبحسب علاقتهم مع واقع مؤجج سلفاًيفترضون أن ادعاءاتهم بحق أنفسهم والآخر أيضاً لا تحتمل النقد والاعتراضلجهة صدقها وقداستها.
الغريب العجيبأن بيننا من منح لنفسه امتياز العصمة والنقاء الإيماني والصفاء السلوكي، وبذات الوقتأصبح له حق تصنيف الناس ومعاقبتهم تبعاً لما يسقط عليهم من تهم وفرضيات، هنا لا يكونالضحايا من المنتمين لأفكار وثقافات علمانية أو ليبرالية ويسارية فقط، بل وبسبب الاعتراضالسياسي أو تناقض المصالح يصبح المنتمون للملة والمذهب والدين الواحد ضحايا أيضاً.فهل يعني نصر هؤلاء انتصارا للمصدر الروحي الملهم؟ ماذا لو هزم هؤلاء... هل يعني ذلكاندحار المصدر ذاته؟
ما الذي يلزمناتحديثه، وهل يكفي التواضع للعودة إلى القيموالمثل السامية التي تدعي ثقافاتنا الانتساب إليها؟
من واجبنا أن نتقبلفكرة وجود أسباب جوهرية عميقة لأزمة العصاب الذي نعانيه في علاقتنا فيما بيننا. فمنجهة نعاني أزمة ثقة بهوياتنا- رغم المدائح التي نغرق بها بلداننا وانتماءاتنا ورغمالفصائل التي تعلن امتلاكها وانتسابها لأفكارنا. ومن جهة أخرى نواجه عجزاً مزمناً تجاهحل الأهم من قضايانا- قضية فلسطين وغيرها من قضايا التنمية والتحديث والديمقراطية.فالذي وضع هذه الأزمات والضرورات في ثلاجة الوقت الميت هو نظام شمولي مستبد أحاط بهجدار فولاذي من المحاسيب والحراس الأمناء والأقلام المأجورة والسلطات المشكلة على الطرازالذي يحمي هرم النظام، لدرجة أننا بالغنا في الإيمان بهذه النماذج واعتبرنا وجود البلدأو الحزب أو الهوية موجودين بفضله، وأن غيابه يعني تفكيكهم واندثارهم.
للأسف، كلنا متشابهونفي علاقاتنا ومفاهيمنا الثقافية والسلوكية تجاه بعضنا والاخر وإنما بنسب ترتبط بموقعومستوى تأثير كل منافي المعادلة العامة للواقع. ولكنا مدانون- وإن بتفاوت- حيث لا معصومونولا أنبياء بيننا. كلنا ومنذ خرجنا طوعاً أو طمعاً من منظومة قيمنا أصبحنا تائهين فيغياهب النزوات والمصالح الخاصة. فالجريمة الأصلية والأصيلة بدأت منذ تعرينا من الصدقوالنزاهة والصراحة والتسامح والعدل والمساواة، فلا عجب إن أصبح كل شيء بعد ذلك متاحاًومبرراً، ومن لا يلتحق بركب الجشع واستغلال الفرص وتضخيم الأنا لديه بات في نظر الكثيرين عاجزاً أو مجنوناً. فهل يوجد أرضأكثر خصوبة من تلك التي يؤمنها تجار الانقسام ومشروع النبذ وسفك الدماء؟
عند محاولتنا التعبيرعن اختلافنا واعتراضنا نستحضر أدبيات النظام الشمولي البائد، الذي عاديناه وكرهناهوهجيناه، ومع ذلك لا نتميز عنه بكيفية تعريفنا ونظرتنا للآخر.
فحين نستجمع كلطاقاتنا ومواهبنا وقواميس شتائمنا لكي نلقي بها على الذي نختلف معه، نتصرف حياله كأنلا جسور توصل بيننا، ولا شراكة معه في المصير والهوية والوطن والإنسانية، حينذاك نقعفي مأزق عميق، خاصة عند نضوج الظرف الموضوعي للمصالحة وإنتاج التسوية. في تلك الحالنصاب بتهتك في كبريائنا، إذ نبدو قاصرين عن استيعاب اللحظة وعن توجيه ما يلائم خطايانامن نقد واعتراف بالذنب وتجاوز لحدود خلاف واختلاف لا يستحق ذلك الإمعان في التأجيجوافتعال التصعيد الذي تفوق الأسلحة المستعملة فيه حجم المشكلة بكثير. كم يلزمنا منوقت ووساطة لكي نطبع علاقتنا الأولية لكي نعتز بها على اللقاء المشوب بالشك والحذروالنوايا الملتبسة؟
كأن ثقافتنا وأفكارنابنيت على أسس حديدية لا تستجيب لاهتزازات الواقع وارتدادات حراكه الدائمة، بحيث لمنعد نستطيع افتراض وجود حصانات وضوابط للسيطرة على الاهتزازات وارتداداتها، وهنا ننكشفعلى ضعف وقصور في قراءة شخصيتنا وتحديد ماهية جهازنا العصبي وعلاقته مع منظومة العقلالذي نحمله في كياننا الفردي والجمعي.
من السهل استشارةغرائزنا وتنصيبها على رأس أفكارنا وسلوكياتنا، وإحاطتها بحاضنة متينة من الأسباب والمبرراتالتي توحد آلية أفعالنا وردود أفعالنا في حال النزاع والخلاف. فيما يبدو صوت الحق والمنطقخجولاً ومحبطاً لأنه لا يلقى الضجيج الذي تحدثهُ لغة الغرائز.
بسبب كوننا انفعاليينتغيب من مفكراتنا البرامج العلمية والخطط المرحلية والراهنة غالباً ليكون جلَّ ما تقومبه ردود أفعال تحسبها انتصارات أو انجازات، وهي دائماً فئوية وذاتية تختزل من فعالياتهاالآخر وتتعمد إقصاءه من إمكانية المشاركة والتفعيل الإضافي لتكريس الانتصار أو الإنجازالمفترض.
وبدل أن يسهم ماننجزه في تحضين الواقع وتنظيم الأولويات نرى أننا نستعلي على بعضنا ونتفرد باستثمارنشوة مؤقتة على حساب الموقف أو الخطاب المختلفلنعود إلى استعمال المنجز كوسيلة لفرض وقائع إضافية تزيد من خلل العلاقة بالآخر منا،فتستنزف القيمة المادية والمعنوية للمنجز بسبب انكفاء العقل السياسي إلى العصبية الفئوية،لأن بوصلة أولوياتنا موجهة دائماً صوب البيئة التي نتواجد فيها، وحفاظاً على حصصناومواقعنا فيها، ولأننا نخاف من بعضنا أكثر من خوفنا من العدو الأصلي الذي ندعي جميعاًعداوته. لذلك لا يظن أحد أن الإقصاء والإلغاء لأي مكون سياسي- اجتماعي- ديني أو مذهبييمكن أن يمنح الكيان الذي نعيش فيه قوة أو مناعة تبرر ذلك. بل على العكس، ومن أجل أننخفف من شطحة انفعالاتنا وتماديها في العبث المجاني ينبغي التمعن في الموقف الآخر وقراءتهجيداً وأخذ المشترك منه في الاعتبار، بل والتأسيس عليه لمراكمة المزيد من أسباب التقاربوالتفاعل الإيجابي لما لذلك من مصلحة تفيد الجميع، لأننا بذلك نزيل بعض أسباب الاحتقانالداخلي الذي يلهي الجميع ويحرف أنظارهم عن التركيز على الأوليات التي تأسست عليهاالبنية الفكرية والسياسية للسلطة أو للجماعاتالسياسية المتواجدة في البيئة الواحدة.
يؤلمنا مثلاً وعندحدوث عمل إجرامي على يد العدو ما يتم تداوله من تصريحات ومواقف وخطب إتهامية وتخوينيةتحرف الأنظار عن إرتكابات العدو ومسؤوليته عنها، لنصير جميعاً الضحية والجلاد معاً،لأننا نستعمل مضموناً لغوياً يعفيه من المسؤولية عن جريمته.
كما أننا نمنحعدونا الغاصب- المحتل والمجرم مساحة أخلاقية واسعة في العالم حين تتجاوز ارتكاباتناوحماقاتنا ضد بعضنا مستوى منسوب جرائم العدو اليومية بحق شعبنا وأرضنا.
يغيب عن بالنامسألة في غاية الأهمية وهي أن تناقضات العالم التي تدار بالتنافس وفرض موازين القوىتحسم في نهاية الأمر بتسويات ضامنة للحقوق والمصالح المتبادلة، مع الحفاظ على نية العلاقةوتكافئها لصالح الأطراف المعنية بها. فيما تعمل هذه الآلية عندنا بطريقة ارتجالية لاتنتج إلا الخيبة واستمرار القفز في المجهول،بحيث نادراً ما نجد التزاماً بالتعهدات والاتفاقات التي تتم وتوقع بين الفرقاء المنتمين لواقعنا، وإن حصل وأعلن عن اتفاق ما، فإن هناك منيتربص شراً لإفشاله وإلغائه. لماذا؟ لأن لمصالح الفئات والأفراد أولوية تفوق المصالحالعامة. ولأن التعقيدات السياسية والثقافية تفترض وجود استثمارات خارجية في مساحة الواقعالمحلي تستطيع الضرب على الطاولة بمطرقة الفيتو الذي يعني نهاية الاتفاق إلى الفشل.لماذا أيضا؟ لأن مسرح الواقع في المنطقة يجب أن يغلق، وبالتالي يجب أن تبقى الأمورالمتعثرة على ما هي عليه دائماً.
"قالت الأعرابُآمنا قلْ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان إلى قلوبكم" صدق اللهالعظيم.




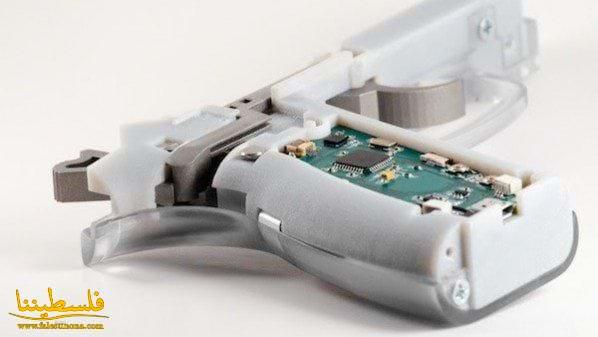




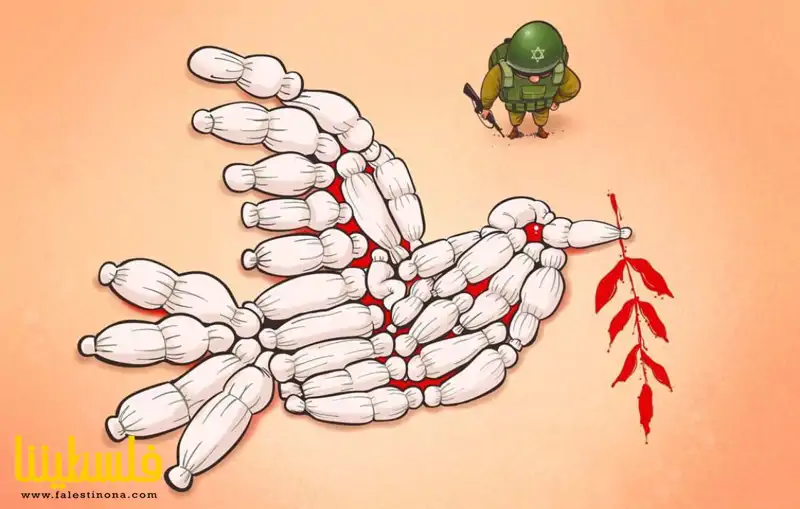



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها