الشاعرة الفلسطينيَّة نهى عودة
بعْدَ مَشقَّة الطريق والمعاناة الكبيرة التي مرَّ بها جميع اللاجئين وهم في طريقهم إلى لبنان، اتَّجهتْ عائلةُ والدتي نحو ضَيْعة (بنت جبيْل)، وهي في مُحافظة (النَّبطِيَّة) في الجنوب اللبناني، لكن إقامتَهم لم تدم بها إلاَّ لعدَّة شهورٍ فقط. ولم تكن أحوالهم سهلةً، فهُمْ لم يستوعبوا ما حلَّ بهم وبدِيارهم، ومتى ستدقُّ أجراسُ العودة إلى ما تركوه خلفهم من تاريخ وعادات وتقاليد وأحِبَّة في القبور.
مكثوا في قرية (بنت جبيل) في العراء، كان بابهم وسقفهم ومنتصف خيْبتِهم خيمةٌ لا تُنصِفهم من بردٍ ولا من حرٍّ. انتقلوا بعدها إلى (حمانا)، وهي إحدى القرى اللبنانية في قَضاء (بعبدا) في مُحافظة (جبل لبنان)، مُتحمِّلين عناءَ وتعبَ الطَّريق، وموْتَ عددٍ ليس بقليلٍ من اللاَّجئين خلال مشوار تشرُّدهم. لكن إقامتهم لم تدُمْ طويلاً في (حمانا) أيْضًا. وقد جاء أحدُ الأقرباء إلى جدِّي وأقنعَه بالانتقال إلى بلدة (برجا) في قَضاء (الشوف) في محافظة (جبل لبنان)، وهي قريةٌ قريبةٌ في طِباع أهلها وعاداتهم من أهل فلسطين، فأقام فيها جَدِّي وعائلته ومن كان معه، من عام 1949 إلى عام 1961. وفي هذه البلدَة وُلِدَ أخوالي الأربعة، وبعدها توجَّه جدِّي وعائلته إلى مُخيَّم "شاتيلا" في العاصمة "بيروت".
في مُخيَّم "شاتيلا" تجددَّتْ مُعاناةُ الفلسطيني فهو لم يسكن المنازل مثل أيّ إنسانٍ يعيش حياةً طبيعيَّةً، بل أَقام في الخِيام، وتُسمَّى الشَّوادر، ولم يكن يُسمَح له بعمارة بيتٍ له سقفٌ وجدرانٌ وبابٌ ومفتاحٌ، يحفظُ خصوصيَّةَ العائلة ويُشعِرُها بأنَّها تقيمُ في شيءٍ اسمه "الدَّاخل" لا يسمحُ بخروج الأصوات إلى الخارج.
الحمَّاماتُ ودُور المياه كانت مُشتركةً بين المُقِيمِين في الخِيام، ولم يُسمَح لهم بإيصال المياه إلى داخل الشَّوادر، كأنَّ الأمرَ رسالةٌ إلى المُقيم حتى لا ينسى أنَّه لاجِئٌ يحْيَا على هامش الزَّمن، وليس له حقٌّ في الأحلام إلاَّ حُلم العودة إلى أرضه ودياره في فلسطين.
كنتُ دومًا أتساءل: كيف للاجئٍ من المرْضى أو الأطفال أو النِّساء، أنْ يتوجَّه إلى حمَّامات منعزلةٍ وبعيدةٍ عن الخِيام المُنتصبة كأشباحٍ في مهبِّ المآسي، لا سيما في ظُلمةِ اللَّيل الشَّتوي الذي تنبحُ فيها الرِّيح اللاَّدغة للعَظْم؟ وكمْ حاولتُ أنْ أتخيَّلَ معاناةَ أمِّي في هذه المأساةِ اليوميَّة، أمْ أنَّ اللُّجوءَ "مدرسةٌ" يتعلَّمُ فيها اللاَّجئُ أنْ يكتُمَ آلامه، ويدُسَّ خميرةَ الصَّبر في خُبزِه المُرِّ، ويغالبَ كل الظُّروف لتستمرَّ الحياة...؟ "مدرسةُ" اللُّجوءُ علمَّتْ الفلسطينيين أنْ يكون جسدًا واحدًا، يُصنِّعون الفرَحَ حتى لا تفقد ملامحُهم قدرتَها على الابتسام والضَّحك. كما علَّمتهم أنْ يصوغوا من أحزانهم مواويلَ الحياة..
تأمين القُوت اليوميِّ من أيّ عملٍ، كان رهانًا يرفعه اللاَّجئون كلَّ صباحٍ. لم يكن سهْلاً أن يتقبَّلوا واقعَهم الجديد، وكأنَّما حياتهم المُطمئنة السعيدة في أرضهم ووطنهم كانت أمرًا وهْمِيًّا استيقظوا منه في خيام اللُّجوء. لم يكن سهْلاً عليهم أنْ يفتقدوا إلى أذان الصَّوامع الفلسطينيَّة، وليالي السَّمَر تحت سماء فلسطين.. لم يكن سهْلاً أن يخلعوا عنهم الماضي الجميل، ويلبسوا كوابيس اليقظة في حاضِرٍ يصعبُ تصديقُ تفاصيل أيَّامه..
يقولون أنَّ "الإبداع وليدُ الحاجة"، المعنى صحيحٌ جدًّا، ولكن هناك فرْقٌ بين من يفهمُ المعنى بذهنه وتفكيره، وبين من عاش المعنى على أرض الواقع. جدِّي من الذين عاشوا المعنى، بل نحتوا أبجديته من صخرة الحياة، فقد توجَّه إلى قرية "الجية" الساحلية، واستثمرَ مع إخوته أرْضًا فلاحيَّةً، ومنَحَها كلَّ وقته وجهوده، بينما بقيَتْ جدَّتي مع أطفالها في المُخيَّم. كما اشتغل جَدِّي في تجارة السَّاعات والقِطَع الحِرَفيَّة وأشياء أخرى كثيرة. واشتغلَ أيضًا في تجارة البطِّيخ، وقبْلها امتلكَ مَحمصًا صغيرًا.. لم يهتمَّ جدِّي، مثل كثيرين غيره من اللاَّجئين، بنوع العمل ومجاله، فقد كان المُهِمُّ هو ضمانُ القُوت للعائلة وبعض أساسيات الحياة الأخرى، إضافةً إلى محاولة التَّكيُّف مع واقع اللُّجوء وتحدِّي كلّ ما فيه من معناةٍ وقهرٍ..
التَّخلُّص من الخيمة وامتلاك بيتٍ له جدران وسقفٌ وباب ومفتاح، كان الهدفَ الذي كافحَ من أجله اللاَّجئُ الفلسطينيُّ في لبنان. وكان عام 1969 هو العام الذي بدأ فيه اللاَّجئون يتخلَّصون من الخيام، وذلك بعْد ميلاد الثَّورة الفلسطينيَّة والتَّنظيمات التي آمنت بالمقاومة المُسلَّحة. غير أنَّ السَّكن في البيوت لم يُسقِط حلمَهم بالعودة إلى فلسطين، فلا أرضَ تعادلُ أرضَ الوطن، ولكن استمرَّوا في العمل على تحسين ظروف حياتهم، من أجل أطفالهم الذين كان يتوجَّبُ تعليمهم والاستجابة إلى بعض طلباتهم الطُّفولية، حتى لا يقعُوا فَرِيسةَ الانكسار والعُقَد النَّفسيَّة..
وفَّرتْ البيوتُ نوعًا من الأمان وحفظ الخصوصية لعائلات اللاَّجئين، وكان جيلٌ جديدٌ ينشأ تحت سقوفِها بشعورٍ أكثرَ اطمئنانٍ.. غيْر أنَّ جدَّتي، التي لازَمها الحُزنُ منذ طفولتها، فُجِعتْ بفقْد أخيها الوحيد عام 1972 دون أنْ يُخلِّفَ أولادًا تراهُ في عيونهم. وحكى لي أخوالي بأنَّ جدَّتي غنَّتْ على قبْر أخِيها أغاني فلسطينيَّة، وقالتْ له "مُعاتبةً" كيف لها أنْ تتركه في هذه الأرض الغريبة، وتعود وحيدةً إلى فلسطين حيث قبورُ أجدادِهما.. كانت جدَّتي، برغم كل العذابات، تُؤمن إيمانًا يقينيًّا بأنها ستعود إلى بيْت عائلتها وأرضها في فلسطين، وهناك تموتُ وتُدفن، غير أنَّ موتَ أخيها أيقظها من "يقينها"، فلبِستْ السَّواد سنواتٍ طويلةٍ.. حُزنًا على أخيها، وربَّما حُزنًا على حُلمها بالعودة الذي فقَد يقينيَّته، ولكنه لم يمُت ولن يموت لأنَّها ورَّثته لأبنائها وأحفادها، وها أنا حفيدُتها ما زلتُ أؤمن بكل يقينٍ بأنَّ العودة إلى فلسطين آتيَةٌ لا ريْبَ فيها.


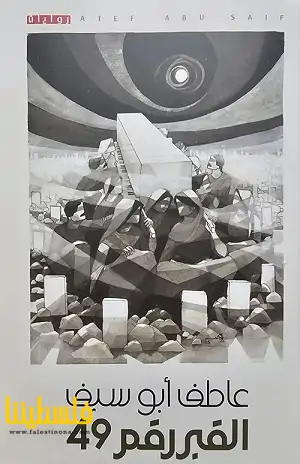

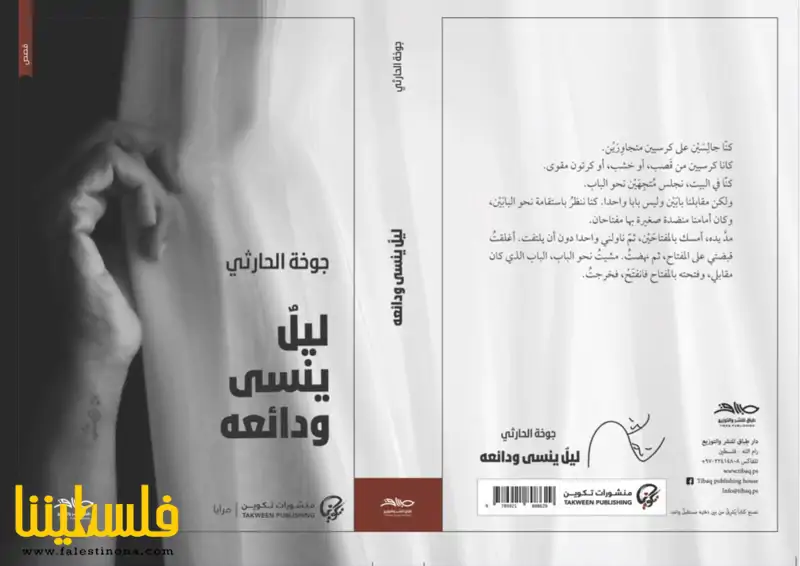











تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها