نحنُ، الشعب الفلسطيني، لم نُعادِ الولايات المتحدة الأميركية يومًا، ورضينا بها راعيةً ووسيطًا لعملية السلام لعدة عقود، بالرغم من أنَّ لدينا يقينًا بأنَّها منحازة للمشروع الصهيوني المتمثِّل بـ(إسرائيل)، والذي هو مشروعها بالأساس، وكنّا باستمرار نستقبل بحرارة الرؤساء الأميركيين ومبعوثيهم ونتعامل معهم بكل احترام، بغض النظر عن الاختلافات الكثيرة والعميقة أحيانًا في وجهات النظر، وكنَّا كذلك لأنَّنا نؤمن أوّلاً بحتمية انتصار قضيّتنا العادلة، ومن هذا الإيمان نثق بقدرتنا على إحداث التغيير في أي موقف كان بشأن قضيتنا حتى لو كان منحازًا ضدَّها.
كلُّ الإدارات الأميركية السابقة، تعاملت هي الأخرى مع القيادة الفلسطينية حسب الأصول المرعية، واحترمت بالحد الأدنى، ولو علنيًّا، ما كان يُتَّفق عليه، وكان المسؤولون في هذه الإدارات يحاولون الالتزام بنوع من التوازن، قدر الإمكان من موقعهم كوسيط. هذا الواقع بما فيه من هبوط وصعود بقي مستمرًّا إلى أن جاءت إدارة الرئيس ترامب، هذه الإدارة لم تنتهك كلَّ الخطوط الحمراء المتعلِّقة بأيِّ تسوية واقعية ومنطقية وعادلة بقدر مُعيّن فحسب، بل انتهكت بشكل مفضوح القانون الدولي وكلَّ قرارات الأمم المتحدة المتعلِّقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي تصرّفت تمامًا كما تتصرَّف حكومة نتنياهو، ووضعت نفسها في خدمة هذه الحكومة بما لديها من أهداف متطرّفة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتبنَّت تمامًا -كما أقصى اليمين الصهيوني- مسألة تصفية القضية الفلسطينية، لذلك رفض الفلسطينيون أن تستمر هذه الأداة كوسيط وكراعٍ منفرد لعملية السلام.
المسمار الأخير الذي دقَّته إدارة ترامب لدورها كوسيط هو دمج القنصلية الأميركية في القدس بالسفارة الأميركية، التي نقلها ترامب للتو من تل أبيب إلى القدس المحتلة، عبر اعترافه المشؤوم بأنَّ القدس عاصمة لـ(إسرائيل).
لماذا نقول إنَّ عملية النقل هي المسمار الأخير؟
علينا أن ندرك أنَّ القنصلية الأميركية التي دمجها ترامب بالسفارة، لم تكن مكتبًا قنصليًّا وظيفياً، بل كانت من الناحية العملية وبالممارسة بمثابة سفارة تعمل رسمياً مع السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994، وتتابع الشأن الفلسطيني بشكل مستقل عن السفارة الأميركية في اسرائيل، هذا الدمج يعني من بين ما يعني أن السيادة في القدس حصريًّا لإسرائيل، وهو ما ينسجم وقرار ترامب بأنَّ القدس عاصمة للشعب اليهودي، ويعني أيضًا إنهاء أي تعامل أميركي مستقل مع الشأن الفلسطيني وتحويله كملحق بـ(إسرائيل) وعبرها كدولة احتلال، بمعنى أن حل الدولتين الذي كانت الإدارات السابقة، والمجتمع الدولي داعمةً له، قد انتهى وانتهت معه المطالب الفلسطينية السياسية والحقوقية، إنه بالفعل مسمار ترامب الأخير في نعش عملية السلام.
ولمَن لا يعرف فإنَّ هذه القنصلية قد افتتحتها الولايات المتحدة في فلسطين وفي القدس عام 1844، وهي أقدم قنصلية أميركية في المنطقة، ومنذ مؤتمر مدريد وما سبقه من اتصالات بدأت القنصلية تلعب دورًا سياسيًّا نشطًا كجهة أميركية مسؤولة عن التواصل مع الفلسطينيين، وهو الدور الذي توسّع وتعمّق بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية على الأرض الفلسطينية، وأصبح القنصل الأميركي بمثابة السفير لدى الرئيس والسلطة الوطنية.
إنَّ أيَّ حديث عن صفقة تاريخية تتحدَّث بها إدارة ترامب وتعتقد أنَّها قد تصلح لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد أنهته الإدارة بقراراتها وخطواتها قبل حتى أن يرى النور. المشكلة مع هذه الإدارة ليس في كونها لا ترى الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل هي حتى لا ترى إسرائيليين ويهودًا يعتقدون أنّه من الخطأ الفادح لـ(إسرائيل) أن يتمَّ نسف مبدأ حل الدولتين، والإنكار الكلي والشامل لحقوق الفلسطينيين، والأغرب أنَّ هذه الإدارة تعتقد أنَّ بإمكانها تصفية القضية الفلسطينية، وأنَّ بإمكانها أن تمنع وتقمع أي احتجاج فلسطيني، أي صوت يعترض على سياساتها التي لن تجلب السلام لأحد.










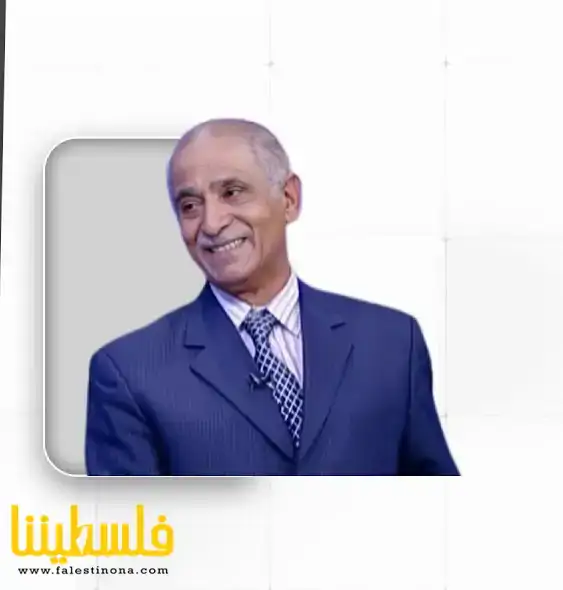





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها