لم ينف أحد، من أولي الأمر في العالم العربي، عن نفسه، ما ذكرته تسيبي ليفني، عندما قالت في مقابلة متلفزة قبل أيام، إنها زارت خلال الخمسين يومياً الأخيرة، أحدَ عشَرَ بلداً عربياً والتقت مسؤولين فيها. فأولئك الذين أحسنوا استقبال وضيافة ليفني، واستمعوا اليها؛ سكتوا جميعاً عن الكلام المُباح، وحمّلوا أنفسهم مجاناً، شُبهة يفترضها المثل الشائع بأن كل مخبأ بندوق. كان بمقدورهم أن يشرحوا الأمر باعتباره اتصالاً مع حكومة المتطرفين لنُصحها وإسماع رأيهم العربي في مجريات المسائل والمسعى الأميركي. وحدها، تسيبي ليفني التي أخذتهم بالجملة، فقالت ما ينبغي أن يدحضه مستضيفوها، وهو أنهم جميعاً يتفقون معها من حيث المبدأ حول موضوع القدس. فلم ينبس واحد منهم ببنت شفة، ليقول إنه من جانبه قد التقاها فعلاً، لكنه لا يتفق معها حول موضوع القدس التي ترى ليفني أن ضمها الى إسرائيل لا رجعة عنه!
في اللغة السياسية التي يعتمدها الأميركيون؛ كثيراً ما أجابوا الشهيد ياسر عرفات والرئيس أبو مازن بأن موضوع العرب اتركه لنا ونحن نؤمن لكم دعماً سياسياً إن استجبتم للطروحات الأميركية. وحيال هذه الجزئية بات التذرع بالموقف العربي ضعيفاً أمام الأميركيين. وكلما استنكف الإخوة العرب عن مساعدتنا، وتبدى الشُح وصيغت الشكوى من أوضاعهم المالية؛ كان الأميركيون في حال اقتناعهم بأن مساعدتنا ضرورية، هم الذين يتولون تأمين التغطية العربية لبعض الاحتياجات الفلسطينية. لقد بتنا أمام الحقيقة المريرة التي يجسد مأزقها بيت شعر الطيب المتنبي: وسوى الرومُ خلف ظهرك رومُ/ فعلى أي جانبيك تميلُ/ قَعَد الناس كلهم عن مساعيكَ/ وقامت بها القَنَا والنصولُ!
موضع الألم في التشكي الذي أرسله أبو الطيب المتنبي قبل ألف وستين عاماً، أن الرجل الذي خذله الأقربون؛ رأى البديل في القنا والنصول، أي في عصا الرمح ويده الحديدية. لكن الأقربين في تجربتنا، هم الذين رأوا عقماً في ثورة المستحيل الفلسطينية، المسلحة بالقنا والنصول، ودفعونا الى طريق التسوية وضيقوا علينا هوامش الطريق الآخر وخنقوا منصات ارتكازها وتهيؤها، وقالوا إن طريق التسوية هي الممكن الوحيد والواقعي والمثمر حتماً. غير أن العودة الى الثقافة العربية نفسها، لا الى دهاليز السلاطين، تعطينا التوصيف الأدق لما استقر عليه خيارنا، وهو خاطئ حتماً في ظل حكومة إسرائيلية معتوهة لا تفهم سوى لغة القوة التي ما تزال متاحة، من الوجهة الاستراتيجية العربية الشاملة، لو تصرفنا كأمة لها أرض شاسعة وجوار قريب للقدس وشعوب مؤمنة بقضية الحق والكرامة، لديها فرضيتنان قائمتنان متناقضتان، استشعار الضعف الراهن، والإحساس بمكامن القوة. ولكي لا نخرج من إرث المتنبي نفسه، نستذكر إنه القائل: وَوَضْعُ الندى في موضع السيف بالعُلا/مُضرٌ كوضع السيف في مَوْضِع الندى!
لقد وضعنا الندى في موضع السيف، في التعاطي مع محترفي قتل، حتى بات ما لحق بنا من الضرر، يضاهي ما يلحق بأي سيف من فولاذ، يُطرح أرضاً فيهترئ بمفاعيل رطوبة هذا الندى. إننا كأمة، لا نقوى الآن على حمل سيفنا المهترئ. وليت سيفنا وحده، هو الذي تصدع، وإنما كذلك مجتمعاتنا التي تُركَ كل مكوّن منها لكي يعود الى خصوصيات تشكّله الأولى، والى قوقعته والى خيمة أوهامه، وتراجعت الثقافة القومية بأفاعيل الفاعلين.
كان طبيعياً، في هذه الحُلكة الطاغية والزمن الأغبر، أن يأتي خيط الإضاءة الذي يكشف واحدة من حقائق أوقاتنا، بلسان امرأة، كانت اتخذت من فتنتها كأنثى سبيلاً الى أداء مهام لمشروع صهيوني لا يحلل أصحابه ولا يُحرّمون.
أحدَ عشر وجيهاً عربياً محرجاً، التقوا تسيبي ليفني خلال الخمسين يوماً الأخيرة قبل لقائها المتلفز. ليتهم تحلوا بالشجاعة وأعلنوا قبلها أنهم يلتقونها في إطار مساعٍ لإقناع الطرف الذي يعربد، بأن العربدة لا تفيده، وأن الطريق الصحيح الى السلام الذي يريدون، هو التحلي بشيء من المنطق ومن الإحساس بالعدالة. كان بمقدورهم أن يطرحوا تعليلهم لأسباب اللقاءات، وأن يؤكدوا على روايتهم بدل أن تختصرها تسيبي ليفني بما هو شائن. فحين يفعلون فعل المصارحة، يحمون أنفسهم، على قاعدة القول الدارج بصيغة الأمر: افضح الشرع.. يسترك. لكنهم ربما أحسوا، أن الشرع في واد، وما قالوه لتسيبي ليفني في وادٍ آخر غير ذي زرعٍ.











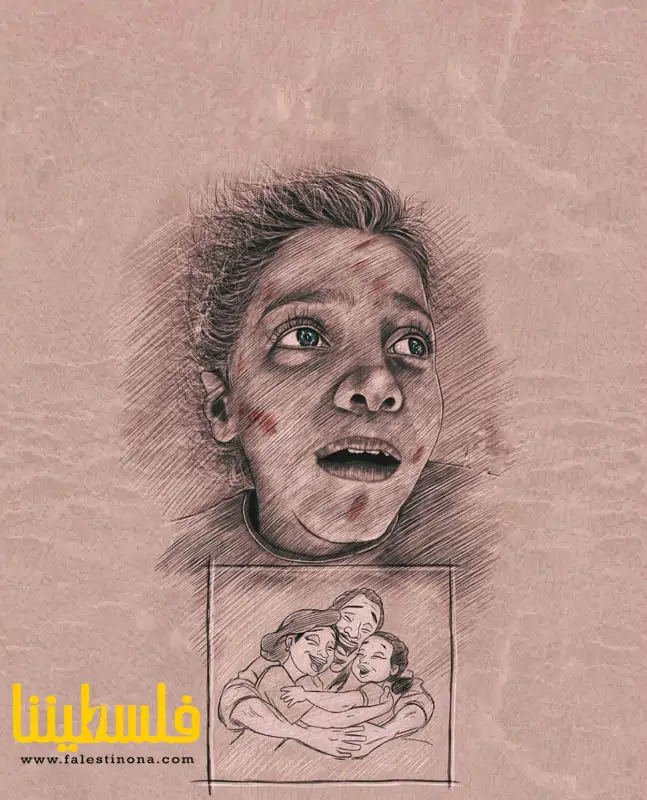



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها