من لم تحفزه مشاهد وصور الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ والكهول والشباب الفلسطينيين مع الدمار اللامسبوق عالميًا، ومن لم تحضه بصيرته لتوسيع دائرة البحث عن الحقائق، وأبعاد وأهداف حملة الإبادة الاستعمارية الصهيونية الدموية على الشعب الفلسطيني، ومن لا يريد أن يعلم أن 7 أكتوبر/2023 كانت كلمة السر والذريعة لإعادة تشكيل الاحتلال والاستعمار الصهيوني الديني والسياسي لكل أرض فلسطين التاريخية فعليه البحث عن عقله المسلوب، وأحاسيسه ومشاعره وعواطفه المتحجرة، وعمن سلبه قدراته الانسانية وأهمها التفكير، وتركه عاجزًا عن تطبيق قواعد استخلاص العبر والأحكام، وجعل من شهاداته الجامعية والأكاديمية العليا مجرد ورقة في اطار على حائط، تكاد حجارته تنطق من شدة أهوال وفظاعة المجازر، فيما صاحبها كأسطوانة عالقة في جهاز "معطوب" يكرر ذات العبارات والنغمات الرديئة.
لا يمكن أن يكون كل الناس علماء، لأن المرء لا يولد عالمًا، وإنما وحده الذي يتقصى الوقائع والأحداث اللحظية واليومية، ويراكم التجارب، ويتوصل إلى نتائج مقنعة – وفق قوانين المعرفة والعلم – ويقدمها للناس دون تمييز، يصبح علامة انسانية، لكن ما حجة المرء الذي يكاد يمتلك معظم معارف وعلوم العالم في كتاب ذكي الكتروني يكاد لا يزيد عن حجم كفه، وبإمكانه خلال دقائق - إن لم يكن ثوان – استحضار ما شاء من المعلومات والصور ذات العلاقة، فيرى ويسمع، ويتابع لحظة بلحظة، ليس الأحداث وأخبارها بين قطبي الأرض، ومشرقها ومغربها وحسب، بل كل ما له علاقة بحياته الشخصية، وحياة المجتمع الإنساني، وكذلك قوانين الطبيعة، والقوى الفيزيائية والكيميائية الخارقة الحافظة لديمومتها، وبذلك يكتشف القوانين العقلانية المنطقية الحافظة والضامنة لوجوده وديمومته كإنسان فرد في مجتمع إنساني يعرف باسم "الشعب" على بقعة من أرض الدنيا تسمى "الوطن"، وسيدرك أن الحفاظ على هذا الثلاثي أمر مقدس، لا يتطلب أكثر من تفعيل قدرات عقله الكامنة والمكتسبة ايضا، وهنا لا حجة لأحد، إذ لا فرق بين قارئ وأمي، أو بين مواطن صاحب لقب أكاديمي أو سياسي أو اجتماعي، وبين آخر لا يحمل أكثر من لقب "مواطن"، وبذلك يتم الحفاظ على الوجود والاستمرار بالحياة.
قد يقول قائل إن خللاً ما بهذه القدرات قد تؤدي بالمرء إلى رؤية مغايرة وخلاصات تتضارب مع الكل، أو الأغلبية العظمى أو المطلقة، وهذا صحيح، لكن الكارثة ستكون الخلاصة الطبيعية الحتمية، إذا أصبح هذا الخلل العلامة الأبرز لدى الأغلبية العظمى والمطلقة. وهنا تصير التوقعات بالنجاة، كالضرب في المندل، أو كإدعاءات المنجمين، أو كالإبحار في بحيرة، بينما الهدف الأساس، هو الوصول إلى أعالي البحار، أو الوصول إلى كل شواطئ العالم لإبلاغ ناس بلادها الرسالة. ونخشى أننا لسنا بعيدين في حالتنا الفلسطينية والعربية عن تشكل مثل هذه الصورة القاتمة السوداوية، والسبب ما حدث لنا خلال قرون سابقة، حيث سبقت الاحتلال والاستيطان والاستعمار، تعاليم ومفاهيم مضادة لمنطق الحياة والحرية، تميزت بإرهاب المفكرين، واعتبرت حرية التفكير، وإبداع النظريات العلمية والمعرفية كفرا وزندقة، وتوارثها الناس خوفًا وطمعًا، فضعف إيمان الناس بقدراتهم العقلية، فسلموا طوعًا وصاغرين أمور حياتهم الدينية والدنيوية لمن ادعى امتلاك تكليف مقدس بالتفكير وتقرير نمط حيواتهم نيابة عنهم وليس عليهم إلا الالتزام، ولم يغفل هؤلاء تطويق الناس بصور الجحيم اذا لم يطيعوا بلا تردد. وهذا تمامًا ما يحدث لنا في حقول السياسة والاجتماع والثقافة مع اختلاف مصطلحات الارهاب التي يقذفون بها من لا يتبعهم أو يفكر خارج صندوقهم، فيحكمون عليه وهم لا يملكون الشرعية أصلاً، " بالخيانة" و"الكفر" و"الالحاد" كل هذا ونحن في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. لذلك يسهل على وسائل اعلام تحمل علامات وبصمات هؤلاء، دفع المضللين إلى مربع الفناء، وهم يهللون ويكبرون ويمجدون، قبل وقفة تفكير واستخلاص نتيجة بأن المحتلين والمستعمرين الغزاة، قتلة أطفال الشعب الفلسطيني، قد شاركهم أصحاب العلامات إياها في تدمير عقولهم كمقدمة لإبادة الجميع في الوطن.















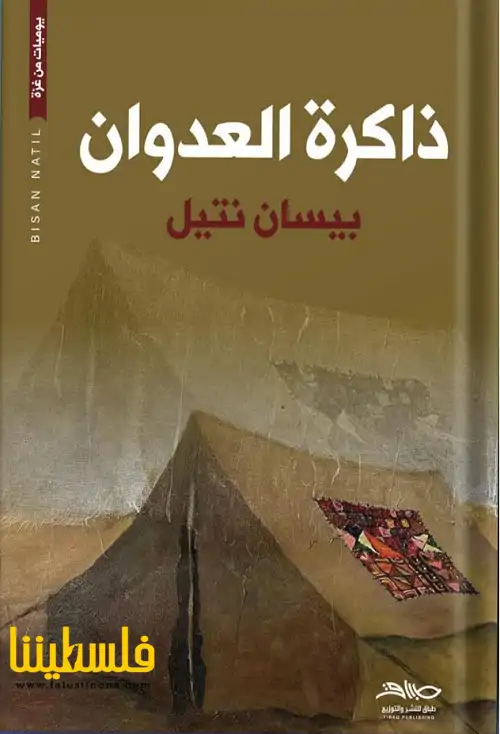
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها