أن تكتب عن بدايات الحركة الأسيرة، بعد نكسة حزيران 1967مباشرة، وتواكب ولادتها وتصاعدها، وكيف استطاعت أن تنتزع حقوقها من فم الغول الاحتلاليّ، وصولاً إلى تقعيد المجتمع الإعتقالي.
هو، تماماً، ما قام به قائدٌ رائدٌ من أبطال الحركة الأسيرة الشهيد قدري أبو بكر، الذي واكب تلك المرحلة الرجراجة، وعايشها، وكان موجهاً لها، وحادياً لذلك المقطع التاريخي الأكثر صعوبة، عبر ما كتبه في هذه الصفحات الساخنة، التي تعتبر أرهاصة نوعية على طريق تأصيل سرديّة الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي شهدت حيوات ونتوءات وأحداثًا جساماً، وشهدت عليها أدبياتٌ حاولت أن تحفظها للذاكرة، حتى لا تُصاب بالعدميّة القومية.
ويقال؛ من السّيء أن تتذكّر الماضي، أحياناً، وخاصة إذا كان مُوجِعاً، لكنّ الدم الملعون لم يتخثّر، والكراهية ما فتئت تمدّ لسانَها المسموم، والعنف يتفشّى مثل كابوس مخيف، والاحتلال الاسرائيلي، صاحب ورشة الشيطان والإبادة المصوّحة، ما زال يُعيد إنتاج الموت، بكلّ صوره، على حياتنا، في المدن والمعتقلات وعلى الحواجز وفي الحقول، حتى بان الهواء ملغومًا بالديناميت والغاز والرصاص المجنون. الأمر الذي يؤكّد أنّ هذه الأرض ستبقى مِنصّة للنعوش والفجائع وتصادم الأكتاف الدامية، ما دامت دولة الاحتلال سادرة في مشروعها العنصري وتقوم بدورها الوظيفي، في مصادرة مستقبلنا وتكريس المُغايرة فينا، والعمل على تذويبنا واستلابنا وشطبنا من سجلّات الحياة.
وربّما من المفيد أن نؤرّخ لكل ما مرّ بنا من أحداث، بهدف تأصيل روايتنا وحفْظ حقوقنا، وحتى لا تظلّ ذاكرتنا عُرْضة للفناء والعذرية والعدم.
ولعل انتفاضة الحركة الأسيرة المتتالية، عبر عقود قاسية، هي واحدة من المحطات الصعبة التي ركبنا عرباتها المشتعلة، ولا بدّ من تسجيل أحداثها، وآن الأوان ليطّلع عليها التاريخُ الشاهدُ، وتمتلئ بها مدارك الأجيال الفلسطينية الصاعدة. كما أن اجتراحات الأسرى؛ أظْهرت فذاذة الرجال الذين أسسوا لغير مرحلة جديدة، تجاوزوا من خلالها تلك السياسات المُستبدّة القاتلة، وأقاموا مجتمعًا ثوريًا مسبوكًا، أضاء بسبيكته الصلبة الذّهبية حياتهم المحاصرة، لتصبح ذات فضاءات أكثر رحابة ومعقولية.
وأشير إلى أنّ هذه الشهادة/الكتاب الذي نشره الشهيد القائد قدري أبو بكر، قبل سنوات، قد حظي باهتمام لافت، يستحق أن يتكرر، لتعميم الفائدة، والاحتفاء بتلك البطولات المدهشة.
وأعتقد بأن ثمة نقصاً جارحاً نعاني منه، نحن الفلسطينيين، يتعلّق بتأصيل تاريخنا النضالي والثقافي وحتى الاجتماعي وغيره، الأمر الذي يستحيل معه جمع كلّ أو أهم ما يتّصل بالفلسطينيين في ظلّ وجود "مناطق" فلسطينية متعددة، في فلسطين التاريخية (فلسطين 1948، الضفة الغربية التي تعجّ بالمستوطنات، وقطاع غزة الذي يُباد، والقدس التي يتمّ أسرلتها بوتيرة مفزعة) وفي الشتات العربي، وعلى مستوى الجاليات المتناثرة في العالم. فمثلاً، لم تتوفر معلومات شافية حول المجازر التي اقتُرِفت بحقّ شعبنا ولا نعرف الكثير عن المعارك، التي خاضها مجاهدونا وثورتنا في العديد من المواقع، لم يتمّ جمع مُجمل الخسائر التي لحقتنا، وعلى كل الصّعد، ونجد صعوبة بالغة في التعرّف على نتاجنا الثقافي والفكري والفني، ولم نحفظ التي تمّ تبديدها، وإحلال جغرافيا مكانها، ليبقى الحق والحلم الفلسطينيان قائمين على أرضية راسخة. لهذا؛ أرى من واجب كلّ مَن يستطيع حمل القلم، والذين يستطيعون الكتابة، بمستوياتها الميدانية اليومية والإبداعية، أن يشاركوا شعبهم، في جمع شظايا الحكايات والأحداث والإحصاءات، وأن يقوموا بتسجيل ما يرون ضرورة تسجيله، اعتقاداً منّي أنّ كل فرد منّا مسؤول، من جانبه، عن سدّ الثغرة التي يتولّاها. ولو أن كل مثقف أو كاتب صرف جُهداً إضافياً في ذلك، لوجدنا رواية فلسطينية ثرية بمعطياتها، تجعل الباحثين أكثر قدرة على دراستها وتصنيفها وتقديمها وتعميمها.
ولعل سرديّة قدري الدامغة أو كتابه هذا؛ لا يسعى إلى أن يكون بحثاً أو تأريخاً أو شاحذاً، بقدر ما يرغب في الإدلاء بشهادته للتاريخ، بما عرفه وأحسّه وصنعه وعايشه أو تجمّع لديه، ليكون رؤية، ستساهم في توضيح بعض الزوايا الخافية أو المسكوت عنها، وإضاءة ما ينبغي إظهاره. إن الكاتب منّا ليس حياديّاً تجاه أرضه وشعبه وقضيته، ولا ينبغي له ذلك.
وإن ما يدفع الواحد منّا للكتابة هو ذلك العامل الاحتلالي الفاعل، الذي يهدف إلى إلغاء كل معانيات شعبنا وإخفائها وطمس معالم جريمته، بل يهدف ذلك العامل إلى تحويل ضحيته إلى مجرم، وما نقوم به، بالتأكيد، يحول دون ذلك.
كما أننا مطالبون، فيما نكتب، بإعادة المصطلحات إلى ظلالها الحقيقية، والمسمّيات إلى جذورها، لأن ثمة طغياناً مُريباً يسعى إلى استبدال المصطلح، أو ربطه بمَعانٍ جديدة، وإعطائه دلالات تروق له، وتسيء إلينا. وثمة أمر آخر مرتبطً بذلك، وهو قلب الحقائق وتقديمها كاملة التزوير والادّعاء والتعميم، حتى أن هناك منظومة كاملة واستراتيجيّات حاسمة تقف وراء خطاب نقيضناوعدوّنا الصهيوني، ولديها آليات هائلة وقادرة ونافذة وتعتمد نظريات التكرار والنفاذ والتصديق والموافقة والانتقاء والتزوير والانتشار.
وغني عن القول؛ إنه من دون تأصيل تاريخي فإننا لن نمتلك هويتنا، ولن نحفظ شخصيتنا، بكل مكوّناتها، ولن نشرف على المستقبل. غير أننا مطالبون كذلك بإعادة الأمور إلى نصابها، حتى لا نكون مبالغين، أو مُحابين أو نجذّف عكس التيار، بل أمناء على الحقيقة كاملة. ومعلنين بكل وضوح أنه لن تثنينا وجهة نظر نقيضنا فينا، ولا تغيّر في قناعاتنا شيئاً، كما لا يهمّنا إلا إبداء رأينا فيما يجري دون قصد الإساءة أو التشهير، بقدر ما يدفعنا حرصنا الأكيد وانتماؤنا لقضايانا، إلى عَجْم الظواهر، وسبْر غور ما يحدث بهدف الترميم والإصلاح والمواجهة المتقدمة، حتى لا نكون من أولئك الذين يغطّون الهاوية بستارة مبهرجة. وهذا وأكثر ما قام به الكاتب هنا.
وينبغي أن نمعن النظر جيداً، في تلك المعجزات التي دبّت في السجون والزنازين، على امتداد القمع الصهيوني. مع أن هدف الكتابة ليس المديح، بقدر ما هو كشف للواقع المعيش وتجاوز له، وتزويد المتلقّي بجرعة معرفية تساعده على صيانة معنوياته، وتمتين مناعته الوطنية.
إن مهمة المثقف الثوريّ ودوره يختلفان عن دور ومهمة السياسي المحكوم بموازين القوة، والممكن وغير الممكن، وتتحكّم فيه اللحظة التاريخية. أمّا المثقف الثائر الذي يتمثّل في قدري عبر كتاباته، فهو حارس الحُلم، والمؤكد على الثوابت، بمعنى أنه الاستراتيجي، الذي لا يحكمه موقعٌ أو منصبٌ أو أيّ تفاهمات لم تذهب بنا إلا إلى العدم والضياع. وبهذا المعنى، فإن السياسي الجيد هو الذي يقترب من المثقف والثائر. والمثقف ينبغي ألا يتبع السياسي أو يبرّر له، وعليه لا يحق للمثقف الحقيقي أن يسقط، بشكل ساذج أو مقصود، فيما يُسمى بالتفاوض أو التطبيع أو الحوار أو الإعلان عن قبول حلّ منقوص بدعوى الواقعية السياسية وما تُملية اللحظة التاريخية الراهنة، أو أن يُبدّل أقواله أمام محكمة التاريخ. وهذا لا يمنع أن تكون للمثقف رؤيته السياسية أو انتماؤه الحرُّ غير الضيّق. غير أن على المثقف، الذي يساهم نتاجه وإبداعه في إنتاج وتكوين الفرد والمجتمع، عليه أن يدرك خطورة الهبوط إلى اليومي والآنّي على حساب النموذج الذي ينبغي العمل للوصول إليه. كما على المثقف أن يعمل داخل نسيج مجتمعه لتمتينه وصيانته، وخلق كوابح داخله تحول دون هرولة السياسي، بل تعمل على جذبه إلى ثوابته ومنطلقاته وروحه، وهذا هو هدف هذه الصفحات الحاسمة.
كان قدري أبو بكر، القائد والموجّه في الباستيلات الصهيونية، وعلى مدار عقدين، شجرة الأسطورة المتجددة، وعاصفة في المعنى الواضح، وحرّاً كما ينبغي للفداء.
كان شهيداً مع وقف التنفيذ أيام الاعتقال، التي قدّها لتكون رايةً فوق القلاع التي صارت تضجّ بالحياة ونبض الإرادات، بعد أن حاول الاحتلال لأن يجعلها مقابر للأسرى. والصحيح أن الأقبية قد أخذت من عمره أجمل وردة، لكنه خرج شهيداً مُحتملاً وهو ينخرط ثانيةً في العمل الفدائيّ بعد صفقة التبادل، وإلى أن عاد إلى حضن أُمّه الأرض والبيت والأهل، لينغمس في العمل الوطني والاجتماعي والسياسيّ عبر مواقعه المتقدّمة، وليواصل اندفاعته المنتمية الواثقة، رجلاً من رجالات الوطن على امتداده المذبوح الساحر.
إن السجون الإسرائيلية، هي معاقل الرّعب التي حققت "العالم الجديد والشجاع" كما تصوره الدوس هكسلي بقمعهِ ووحشيتهِ وسلبهِ روحَ وإرادة الإنسان، وتحويله إلى مجرد هيكل عظمي دون أدنى مقومات.
ومن عجب أن العقلية الاستعمارية الامبريالية تشرب من نبع واحد؛ إذ إن كل المعتقلات الصهيونية، دون استثناء، هي ما يشبه،أو هو ذاته، عالم الدوس هكسلي، وهو ذاته جزيرة العقاب كما تصورها فرانز كافكا. العقلية الإمبريالية الاستعمارية تعتقد واهمة أنها تستطيع حمل الإنسان إلى نقطة يتخلّى فيها عن روحه وإرادته وأحلامه وطموحاته. باستعمال القوة، العزل، التجويع والترويع، التعذيب، القمع، زرع اليأس في النفوس، تذويب الإحساس بالتمييز، قتل الإبداع، إنهاك الجسد من أجل إنهاك الروح.
- سجون الاحتلال هي مدن الدوستوبيا الجهنمية غير الفاضلة
وآخر ما وصلت إليه عقلية فاشية عنصرية من أساليب في تنميط جزيرة عقاب بعيدة ومنعزلة، مستفيدة من سرمدية الزمهرير وأبدية الشمس.
كلّ منها معسكر اعتقال، أو قل سجن مزنّر بالأسلاك والكلاب ومدافع الغاز والرصاص وأبراج المراقبة، إنها معسكرات تجميع تشبه معسكر تربلنكي أو أوشفيتس، الذي أريد له أن يكون تقطيراً لكل معسكرات الامبرياليات السابقة، وتركيزاً لكل تجارب إجهاض الثورات والشعوب، من خلال هذا الاحتكاك اليومي بين القاتل وضحيته، بين السجّان وسجينه.
- مدينة جهنمية كاملة!
كان على الأسرى أن يطوّعوا أجسادهم أولاً، وكان عليهم أن يحصّنوا إرادتهم، وكان عليهم أن لا يروا من خلال عيونهم، وإنما من خلال تلك الأرواح التي تسكنهم لتجعل من أجسادهم لا تشعر بِحَرٍ أو بقرّ،ولتحتمل الكهوف الرّطبة الخانقة القارسة الموحشة، وليدرّبوا الحياة لتستقيم معهم. وقد استقامت.
وقدري واحدٌ من أوائل الذين قوّموا الحياة وأقام صَّلاتها. وهو نفسه الأسير الذي حقّق معنى الاختيار الحرّ الوجودي، بمضمونه العميق، هو الخط الفاصل في المعركة السرمدية بين أنبياء الأرض ومصاصي الدماء، وبين الزيتون والنار، وهو فصل الخطاب بين ثقافة الكرامة والأنفة والحياة والخلاص والحلم والانتفاضات العبقرية الفلسطينية، وبين غوغائية الإحتلال المتمثلة بالهدم والحرق والقتل والتخريب والجهل والضيق والموت والحصار، وتطوير كل أشكال القمع عبر التاريخ، وإعادة إنتاجها بساديّة على كلّ ما هو فلسطيني. ونعرف سلفاً أن مَنْ سرقوا القافلة سيتّهمون أصحابها الحقيقيين بالقرصنة والجنون وقطع الطريق.
سيبقى قدري قَدَرَنا المتجذّر، هنا والخالد في بذور المكان، وعلى بصمة الجَمْر، وأغنيته الصعبة المكابرة بإصرار. وهو، بما تركه من ميراث وطنيّ وابداعيّ معرفيّ. سيبدّل نهاية الحكاية، ويبقى في عناد الحياة وقوّتها الباقية.
ونكرر القول؛ إنّ رجلاً له ملامح التقاء الساحل بالجبل، على رأسه إكليل اللوز، وفي عينيه حلم مُعجِز، قد وُلِد في زاوية الراوية، ذات ربيع دافق، فامتلأ بالشّهد، وجرى مع السحاب الأليف، وحفظ آية التراب، وكان اسمه قدري أبو بكر. كان لقدريَ جُرأةُ الموسيقى، وفي صوته شرايينُ الشهداء ونجيع الجراح الشجاعة، ودقّات القبضات على الأبواب، وفي ناظريه مقاصل الليل، من رفح إلى جنين وغزة إلى ترمس عيّا وجبل النار ويافا والنقب، وفي ظهره تتنفّس البشرية الخارجة إلى العدالة، رغم المذبحة المدوّية.
لقد كبر الفتيان، الذين كانوا وراء القضبان، أو الذين هجّرَ الاحتلالُ طفولتهم، وها هم يولدون، ثانيةً، عبر أحفادهم، ممتلئين بمعاني التضحية والإيثار، إذ أورثتَهم تجربتك التي تفلتت من الظلمة والمَظْلمة إلى الشمس، ودلحتَ في أرواحهم جرعة النار.
فما أجملكَ! وانتَ تؤصّل في الوجدان لباء الطين بسماوات لا نهائية، وأحلام لا تقتل أصحابها الطيّبين. وستبقى ذكراك مع مَنْ اجترح التاريخ وصنعه، أولئك الذين تغلّبوا على الليل، ثم رحلوا، تاركين أرواحهم للنهر الجاري، الذي سيشرب منه الصغار. لقد رحلوا، لكننا نستطيع أن نستعير حياتهم، لنعيد إلى التاريخ، رغم تكراره، فذاذة المعجزة، واختراق العبقرية، لنا، ونحن ننام بجانب ندوبِنا نحس بأننا أكثر جَمالاً مما نرى في المرايا والوجوه، أولئك الذين ما كانت قصّتنا موجودة لولا وجودهم بيننا.
وعندما أتحدّث عنهم أشعر أن صوتي مليءٌ بالتآلف والاطمئنان، أَلَمِهم يجيء هذا الحب والوداعة والثقة بالغد،رغم كل ما يخنقنا من لغط واجتراء.
وعندما أتحدث عنهم، أكاد أقول إنني القوة التامّة والمُعافاة، التي تهبط من السماء، لتجعل الأرض رائعة، لك الكرة المليئة بالوحول والدم والمجازر. وأحس بأنني أمتلك الكوكب بين أصابعي فأضيئه بدم هؤلاء.
فماذا نريد أعلى وأنبل من هذه البوصلة الشهيدة، التي نتشرف بإشارتنا إليها، جعل الذين أصابهم النسيان المُبكّر أو الإحباط أو الكآبة، يتذكرون، ويثوبون إلى رشدهم.
لقدري الذكرى الذاكرة وخلود الشهداء، ولفلسطين النصر والحياة.














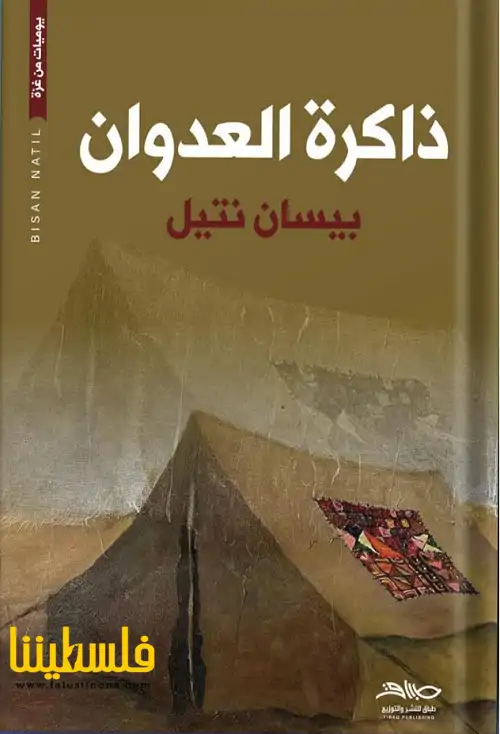
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها