حلَّت ذكرى العدوان الغاشم، الذي نفَّذهُ العدو الصهيوني على ما تبقى من أرض فلسطين، وعلى الدول العربية المجاورة لفلسطين، في الخامس من حزيران عام ١٩٦٧، إنّها ذكرى تحمل في ثناياها المرارة التي تزداد عامًا بعد عام. لم أستطع أن أنسى ذلك اليوم الكئيب وما حمل لشعبنا وأمتنا من نتائج كارثية، ما زلتُ أكتوي شخصيًّا بها، كما يكتوي بها كلُّ الشعب الفلسطيني ومعه الأمة العربية، وما زال العالم ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة، عاجزين عن إزالة تلك المرارات التي خلّفها هذا العدوان الغاشم، وأكثر من ذلك ما ارتكبه بعدها من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، فقد هجَّر من هجَّر، وقتل من قتل، واعتقل من اعتقل، وصادر ما صادر من الفلسطينيين منذ ذاك اليوم المشؤوم وإلى الآن، لم يلقَ هذا الكيان الفاشي العقوبة الرادعة، فيستمر في غيه، وما زال يتغوّل في غيه ويرتكب جرائمه اليومية، التي لا يمكن توصيفها في عرف القانون الدولي الحديث والقديم سوى بأنَّها "جرائم حرب"، فكلُّ ما أقدم عليه من تهجير أو تقتيل أو اعتقال أو مصادرة في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستيطان لأرضهم، كان وما زال وسيبقى مخالفًا لأبسط قواعد القانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان.
اليوم يكون اكتمل من عمر هذا العدوان اثنين وخمسين عامًا من المعاناة المستمرة والمتعددة الأشكال التي أذاقها للشعب الفلسطيني طيلة سنواته، وخلّف هذا العدوان هزات ارتدادية طالت دول المنطقة التي ما زالت تعاني من آثارها المدمّرة، وهي السبب الرئيس لما تشهده بعض الدول من تمزُّق واقتتال.
عند وقوع العدوان كنت قد أنهيتُ الصف السابع -أو ما يسمّى الأول الإعدادي أو المتوسط- بنجاح كالعادة، وكانت قد بدأت حينها العطلة الصيفية لتوها، ومع قرع طبول الحرب في تلك الفترة، كنت أعتقدُ أنَّ العدو لن يقدر على الدول العربية إذا ما وقعت الحرب، وكانت لدي ثقة كبيرة وأمل كبير بأن النصر سيكون حليفًا للعرب، وسوف تتحرّر فلسطين المحتلة عام 1948م إذا ما وقعت هذه الحرب، وسننعم بالعودة إلى السهل الساحلي (السهل الغربي) وبشواطئ المتوسط التي حُرم منها جيلي، وسنلتقي أقاربنا الذين فصلوا عنا في شفا عمرو والناصرة وفي حيفا ويافا، كما سيجري الوصل بين الأهل في الضفة الغربية مع الأهل في قطاع غزة، كل هذه الأحلام للصبي أنا، كانت هي أحلام كلِّ فلسطيني، بل وكلٌّ عربي، حلم بتحرير فلسطين وعودة شعبها المهجَّر من اللاجئين الهائمين على وجوههم، الحالمين بالعودة إلى الديار التي حملوا معهم مفاتيحها.
وفي ليلة الخامس من حزيران المشؤوم، نمتُ مبكرًا لأنَّني كنتُ على موعد مع الوالدة "رحمها الله" لمرافقتها إلى كرم جميل لنا اسمه ((الغرس))، يقع في شرق البلدة، مزروع بأشجار اللوز، والزيتون، والعنب، والتين، والبرقوق، والمشمش، والتفاح السكري، الذي كنت أعشقه، وكانت تباشير نضجه قد بدأت. ففي الصباح الباكر، أفطرت كوبًا من الشاي، وكسرة من الخبز المحمص، مع قطعة من الجبن النابلسي المالح، وانطلقت إلى جانب الوالدة، أسابقُ الريح للوصول إلى الغرس، حيث وصلنا بعد مسير نصف ساعة من انطلاقنا، وباشرت الوالدة بقطف أوراق العنب، لأنَّها قررت أن تحضّر لنا ذلك اليوم غداءً من ورق العنب المحشو بالرز وبالقليل من اللحم المفروم.
أمّا أنا، فعهدت إليّ الوالدة بانتقاء بعض من الثمار التي قد نضجت، خصوصًا التفاح السكري الفريد في نظري لغاية الآن، ولم تمر برهة من الزمن، وإذ بصوت مزلزل يكسر صمت المكان والزمان، ويتردّد صداه بين التلال والجبال، أدخل الهلع إلى نفسي، فتوجهتُ جريًا نحو الوالدة والتصقتُ بها، ونظرت إلى السماء وإذ بأربع طائرات تحلق في سماء المنطقة، كان الظن أنَّها طائرات عربية أردنية أو عراقية، لأنها كانت قادمة من الشرق، وكان تعليق الوالدة أنَّ الحرب قد وقعت، وقالت ((يمّا خلينا انروح إنشوف إخوتك ونشوف إيش راح نعمل))، وقطعت مهمتها وزيارتها الأخيرة للغرس ومهمتي التي لم يكتمل سروري بها! وصلنا إلى البيت واجتمع الجيران، وبدأ الكبار يتحدثون، فهمتُ أنَّ هذه الطائرات لم تكن عربية، وإنما كانت طائرات معتدية صهيونية من طراز ميراج فرنسية الصنع، كانت في مهمة قصف للمطارات الأردنية، وكانت عائدة في طريقها إلى قواعدها، وآثرت القيام بعملية اختراق للصوت لتُدخِل الهلع والرعب في نفوس المدنيين الآمنين من سكان المنطقة. هكذا عشتُ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الخامس من حزيران للعام ١٩٦٧، وسأبقى أكرّر الحديث عن ذلك اليوم المشؤوم، لأنّه نكسة ما بعدها نكسة، إنّها مرارة بعينها، والألم بعينه يتكرّر كل عام، لن يمحوه من نفسي سوى زوال الاحتلال، والعودة للوطن الذي سلبنا، هذه هي ذكرى النكسة الحزيرانية، كما أراها كل عام.
ومع ذلك سأبقى أنا الحاضر.. أنا الشاهد.. أنا الحالم.. بالعودة إلى وطني فلسطين..








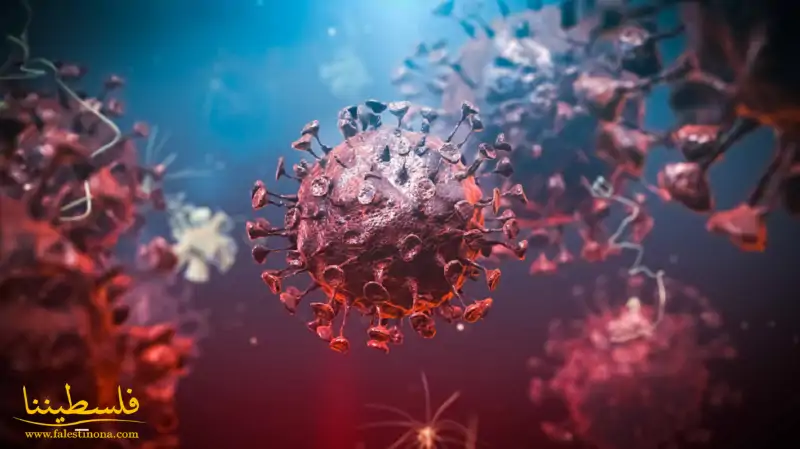






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها