فقدت الحكومة الإسرائيلية صوابها منذ أن أصبحت فلسطين دولة غير عضوية في الأمم المتحدة في سنة 2014، ثم دولة عضواً في محكمة الجنايات الدولية في نيسان 2015، وراحت تشجع المستوطنين المتطرفين على التنكيل اليومي بالفلسطينيين. وما إن عاد الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة في آواخر أيلول 2015 بعد خطبته أمام الجمعية العامة التي دان فيها اسرائيل بقوة، واتهمها بدعم الارهاب اليهودي مباشرة، خصوصاً عصابة "تدفيع الثمن"، علاوة على وضع مخطط لتغيير واقع القدس ولا سيما الحرم القدسي، وحذّرها من مغبة تحويل الصراع في فلسطين الى صراع ديني، حتى بدأت الاجهزة الامنية الاسرائيلية سلسلة من الاجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني، فأطلقت أيدي المستوطنين العنصريين للاعتداء البهيمي على الناس والاراضي وأماكن العبادة. وسجلت الوقائع أكثر من 300 اعتداء نفذه المستوطنون منذ أوائل عام 2015 حتى نهاية أيلول 2015، كان أبشعها حرق عائلة الدوابشة في تموز 2015، واستشهاد الرضيع على الدوابشة ووالده ووالدته. وكان واضحاً أن الحكومة الاسرائيلية تتجه الى تقسيم المسجد الاقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود، الأمر الذي ادى الى اندفاع الشبان للتمترس في أحياء القدس والدفاع عن مسجدهم، وتحول الزخم المتزايد الى مقاومة غاضبة، والى احتجاج معمد بالشهادة. ولا شك أن غضب الحكومة الاسرائيلية ليس ناجماً عن اتهام الرئيس محمود عباس لإسرائيل بالعمل على تقويض حل الدولتين فحسب، وهو التزام دولي في أي حال، بل لأن رئيس الجمعية العامة خاطبه بلقب "صاحب الفخامة رئيس دولة فلسطين". وكان سبق ذلك رفع علم فلسطين فوق مباني الامم المتحدة في نيويورك وجنيف، وعلى مكاتب المنظمات الدولية التابعة لها كالأونيسكو. وتعرف اسرائيل جيداً أن هذا المسار السياسي الذي يبدو واهناً اليوم، سيؤدي في يوم من الايام، الى دولة فلسطينية مستقلة إذا كان في الامكان اقتناص الفرص السياسية الملائمة. وهذا ما يفسر إصرار اسرائيل على تحصين مستقبل كيانها بفكرة "يهودية الدولة".
ليست هبّة بل مقاومة
إزاء هذه الاحوال أحالت حكومة نتنياهو الى الكنيست رزمة من القوانين العنصرية تتيح للجنود الإسرائيليين إطلاق النار على رماة الحجارة الفلسطينيين، وعلى أي فلسطيني يشك الجنود بأنه يتهيأ لمهاجمتهم، وهددت بسحب الاقامات من سكان القدس الذين يشاركون في الاحتجاجات ومن أهاليهم أيضاَ. وبالتفاعل المتراكم تحولت حال الغضب في البداية الى هبّة احتجاجية عنيفة، ثم لم تقف عند حدود الاحتجاج وحده، بل انقلبت الى طراز من المقاومة الشعبية التي ابتكرت أساليب متجددة من المواجهة كالطعن والدهس. وفي خضم هذه المقاومة الشعبية برزت ظاهرة "الذئاب المنفردة" أي المقاومة ذات الطابع الفردي. واللافت أن قادة الاحتجاجات هم فتيان ولدوا بعد اتفاق اوسلو، وكان كثيرون منهم يسهرون في الأحياء اليهودية في القدس الغربية، أو يعملون في المدن اليهودية الاخرى. واللافت أيضاً أن العلم الفلسطيني (وأحياناً راية فتح) هو الذي ارتفع في ساحات المواجهة من دون رايات الفصائل الفلسطينية الاخرى التي اقتصر شأنها على إصدار البيانات أو المشاركة في الجنائز، حتى راحت عبارة "الشعب يقاوم والمنظمات تبارك". ولعل استنكاف بعض المنظمات عن المشاركة المباشرة في المواجهات الغاضبة هو من حُسن التقدير. لكن، من مضحكات هذا الزمان أن "الفصائل الوطنية والاسلامية" أصدرت بياناً تطالب فيه بالتصدي للاعتداءات الاسرائيلية". تطلب ممن؟ وتطالب مَن؟ أليس الاحرى ان تتصدى هي بنفسها ما دامت تدعي أنها فصائل وطنية مناضلة؟ ويبدو أن هذه الفصائل قد وصلت الى طريق مسدود تماماً. فالاحتجاجات كشفت أن الشبان المتظاهرين لم يكترثوا البتة لمواقف هذه المنظمات؛ فحين دعت منظمات عدة الى مسيرة "نفير وغضب" في 15/10/2015 لم يُلب هذه الدعوة إلا العشرات، وهؤلاء هم بقايا أعضاء تلك الفصائل.
من مفارقات ما يجري اليوم في مدينة القدس وبقية الاراضي الفلسطينية ان اليهود الشرقيين باتوا يخشون التجول في الاماكن العامة لأن المستوطنين المتوحشين ربما يعتدون عليهم بسبب سحنتهم الشرقية. والمؤكد أن الاحساس بعدم الامان لدى المستوطنين قد تفاقم كثيراً بعد العمليات الجريئة التي قام بها شبان فلسطينيون ضد المعتدين اليهود. وهؤلاء المعتدون يكشفون في كل يوم الطبيعة الفاشية لليمين الصهيوني وللمستوطنين في آن. ومهما يكن الأمر، ومهما تكن أسباب الغضب الفلسطيني، وهي معروفة، أو مجموعة من الاحتجاجات اليومية الشجاعة، لكنه لا يستطيع أن يطور الاحتجاج الى انتفاضة. فالانتفاضة التي يطالب بها كثيرون اليوم ويتوقعها ويتمنى حدوثها، تحتاج الى عقل سياسي، والى تخطيط سياسي وعسكري، والى موارد بشرية ومالية، والى ادارة سياسية ثاقبة. ويبدو لي ان المقاومة الشعبية في صورتها الحالية، مع مقادير من العنف المدروس، هي التي تلائم الاوضاع الفلسطينية. فالمقاومة السلمية هي الافضل لأن اسرائيل الخائفة والمضطربة مستعدة لإيصال القمع الى أعلى درجاته، ولأن العالم كله غير مكترث بما يجري في فلسطين، بل بقضايا الارهاب والهجرة وتباطوء النمو الاقتصادي والأزمات المالية المتمادية والتنافس على المصالح الحيوية.
السلطة الفلسطينية، في معمعان ذلك الاضطراب العميم، واقعة بين لجام ومهماز. فإسرائيل تحارب بكل قوتها إمكان تحوّل السلطة الى دولة. وكثير من الفلسطينيين يحولون دون تطوير الوضع الراهن وتثويره الى مستوى استعادة منظمة التحرير حركة للتحرر الوطني. وحركة حماس لا همّ لها الا التحكم بقطاع غزة وحكم الناس فيه وفك الطوق عنه ولو بالتفاوض المباشر مع اسرائيل على هذه الغاية. والمنظمات الفلسطينية لا تأثير لها في الشؤون الاستراتيجية، وهي باتت بلا فاعلية، وأصواتها التي تعلو هنا وهناك أحياناً إنما هي حشرجة الشيخوخة قبل النهايات الأخيرة.
ما الخيارات المتاحة الآن أمام الفلسطينيين في ضوء مجريات الأحوال؟ أول هذه الخيارات هو توسيع حركة المقاومة وتطوير فاعلية الاحتجاجات. وفي هذا الميدان إما أن تضبط السلطة الفلسطينية إيقاع الاحتجاجات خوفاً من الفوضى ومن اختراقها وتحويلها نحو العمليات العسكرية الاستعراضية، أو أن تدعم المقاومة والاحتجاج على طريقة الرئيس ياسر عرفات في سنة 2000 وثاني هذه الخيارات هو إبقاء المقاومة والاحتجاجات في نطاق يمكن التحم به كي لا يقدم الشعب الفلسطيني مجدداً مئات الشهداء من دون تحقيق أي إنجاز سياسي على غرار ما حصل في غزة في سنة 2014. والخيار الثالث، وهو الراجح، استمرار المقاومة بشكلها الحالي، اي التصدي للمستوطنين وتنفيذ عمليات ذات طابع فردي، وإبقاء شعلة القضية الفلسطينية متوهجة.
لا خيار أمام السلطة الفلسطينية فضلاً عما تقدم، إلا السير في النطاق العالمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفاقاً للقانون الدولي الانساني، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. ومع أن هذا السعي يتسم بالضبابية وعدم اليقين في جدوى نتائجه السياسية، إلا أنه ضروري جداً في الاحوال الراهنة التي تتسم، بدورها، بالجمود السياسي على مسار التسويةٍ، وبالانقسام الذي لا ينتهي بين الضفة وغزة وبالواقع الاقليمي المروّع.وهذا كله يجعل الخيارات السياسية قليلة جداً أمام السلطة الفلسطينية التي تواجه "معارضة" انقسامية ذات شأن في الواقع الفلسطيني. والحقيقة أن ثمة فارقاً جوهرياً بين المعارضة والانقسام. فجبهة الرفض التي ظهرت في سنة 1974 رداً على برنامج النقاط العشر وخيار الدولة الفلسطينية آنذاك كانت معارضة لأنها ظلمت في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. أما الانشقاق عن حركة فتح في سنة 1983 وتأليف ما سمي "جبهة الانقاذ" (إقرأ: جبهة الأنقاض) فهو انقسام اندثر مع الانتفاضة الأولى في سنة 1987. وكذلك شكل اتفاق أوسلو انقساماً انتهى مع الانتفاضة الثانية في سنة 2000. ولكن الانقلاب الذي وقع في حزيران 2006 شكل حدثاً انقسامياً "وليس قسّامياً" لم تنتهِ عقابيله بعد.وليست إسرائيل في أحسن حالاتها على الاطلاق. فهي باتت غير قادرة على التصرف في المنطقة كيفما شاءت بعد نزول الجيش الروسي في سورية، وبعد العجز الأميركي والأوروبي عن اتخاذ أي رد على هذه الخطوة ولهذا ليس غريباً ان ينصرف نتنياهو الى التفتيش في الاوراق المتعفنة، فيزعم في خطابه أمام المؤتمر الصهيوني في القدس في 21/10/2015 أن الحاج أمين الحسيني هو صاحب فكرة إبادة اليهود، وهو الذي حرّض هتلر على انتهاج طريقة الحل النهائي للمسألة اليهودية حين التقاه في برلين في 21/11/1941. وهذا الأمر يشير الى أن اسرائيل بدأت تفقد ذرائعها الزائفة بالتدريج. فمن يقتنص اللحظة السياسية الملائمة؟



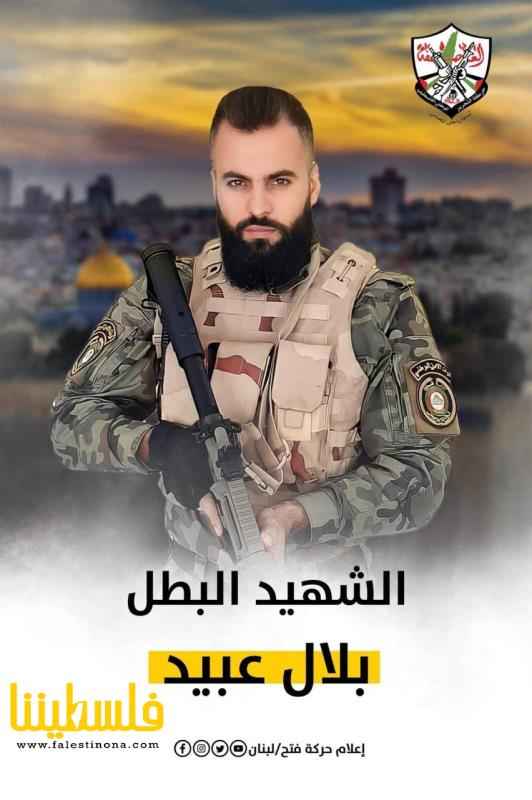










تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها