خاص مجلة القدس- بقلم: محمد سرور
منذ البدايات، يوم اغتالَ السمُّ ياسر وصوته المصقول من ومضات الزمان، منذ شهدنا كيف أباحَ القاتل دماءَ اليمامِ والعصافيرِ في جهاتِ أحزاننا المثقلة بالنزف والعزة الثكلى.
يومها احترنا بتعريفِ السيد محمود عباس. قد يكون- حينها - أصابنا بسهم التشوُّش والقلق المشروع أحسسنا أن الظروف خذلتنا بخيار ليس الأفضل.
وقد يكون في حينه – أيضاً- ارتكب جرمَ وراثة: يا جبل ما يهزك ريح . وعالقدس رايحين – وشهيداً شهيداً شهيداً. يوم أبت عواطفنا وقلوبنا قبول فكرة استشهاد عابر للفضاءات والقارات والمحيطات بكوفيته التي تجاوزت جغرافيا وتاريخ فلسطين، وبذات القدر ولذات السبب مارسنا النقمة على الخلف المغمور – دائماً مقارنة بالسلف- الذي جاء لكي يؤكد لنا حقيقة نرفض الاعتراف بها وتصديقها.
لم يأتِ الرجل في سياق تناوب العهد، ولا كان حاضراً في سلسلة توقعاتنا التي لم تقبل فكرة غياب نديم الزمان والمكان والأمان – أبو عمار الشهيد الذي أصرَّ في كل يوم أن يحضر أكثر. كان في نظرنا حالة لا تستوي مع ما يصيب البشر .
كأن أبو مازن انقلب على تاريخنا وذاكرتنا وتجرَّأ على إعلان نفسه نسخة اللسان المعدَّلة ولغة الحدث المختلفة. ومع أننا كنا عصاة على الترويض ، مارس علينا فعل التطبيع لا التسييس، وفعل اللكم لا التمهيد . خاطبنا بلغة الدبلوماسي الذي يحاكي غيرنا لنفهم المعنى مشفراً، وفوق ذلك راحَ يحملنا عبئاً يفوق نرجسيتنا المعلقة بالأمس الجميل، عبء ادعاء تفهُّم مقاصده – رغم شكوكنا الكثيفة والعميقة الوقع، وبذات القدر حمَّلنا عبءَ ترجمة أقواله غير المنسجمة مع أهوائنا وأبجدية يومياتنا السياسية إلى مواقف لإقناع الآخرين ومساجلتهم بقوتها وفاعليتها وجذرية أهدافها.
ودون سابق اعتذار، كنا نرى بأبي مازن الدواء المر، نشربه عن حاجة إليه، فيما مذاق حضوره لا أثر له غير المر المعلق في سقوف أفواهنا وهواجسنا المنكسرة.
رحنا ندوِّر زوايا اللغة، ونحاول نبش البلاغة من براثن الواقع الذي غابت عنه صورَ البدائل ورجالات الأمس الحميم.
نطرق أبوابَ الصور التي لا تملُّ محاولة استنساخ ياسر عرفات آخر، أو شبيه له، أو أيِّ رجل سهل الهضم في خواطرنا، إلى أن بدأنا نستمتع برياضة الكلمات المتقاطعة مع حسناتٍ بدأت تتسلل إلى ضمائرنا خلسة وتراكم معها سمات تحوُّل في مداركنا ومسارات ذاكرتنا، كانها الإنقلاب الآخر الذي تربص بنا طويلا، إلى أن حان موعد اكتمال شروطه.
قد يكون اول أهم أسباب نجاح انقلاب السيد محمود عباس على إرثنا العاصي بداية تجرُّعنا حقيقة استشهاد ياسر عرفات ودخوله حالة الخلود الذي لن يرانا خلالها إلا من مقام أسمى وأبلغ من البقاء بيننا. وأن الضريح الذي تلا عليه صورة الفاتحة بعد انتخابه رئيساً للسلطة الوطنية آنذاك حقيقة يجب تقبلها كبداية لتقبِّل الخلف.
عجزنا يومها عن كيف نعرِّف قائدنا الجديد. فهو لم يكن صاحب تجربة فدائية ولا علاقة له بميادين النزف الجليل. مع أنه الدبلوماسي المخضرم في مساجلة الحال الصهيونية من ألف الباطل الذي قام عليه المشروع الصهيوني في فلسطين إلى ياء الخطاب المظلل والمزيف والكاذب في أدب اليوميات العدوانية الصهيونية.
لكننا بين المشهدين النقيضين أسكنا الأسئلة الكثيرة والعميقة وذات الصلة الرابطة بين شخصية القائد الخلف وقدرته على التوفيق بين بروتوكولية السلطة، التي تفترض خطابا يجيد الوصول إلى العقول التي لم نكن نعيرها كبير اهتمام، وبين طقوس الثورة التي تسير على الحد الفاصل بين الشارع والمتراس والقصر والديوان.
بدأنا بمقولة تختصر الفارق بين شخصيتي السلف والخلف، ودائماً نسعى لإقناع أنفسنا قبل الآخرين، بأن المزاوجة بين البندقية والسياسة لا يمكن لغير ياسر عرفات أن يجيدها. لسنا في إيرلندا وعدونا ليس حكومة بلاد الضباب، بل قاتل لا يتورَّع عن إراقة الدم بأي ظرف ولأي سبب. ونكمل بخلاصة نراها أكيدة : بقتلهم الرجل الأكثر حضوراً في تاريخ ثورات العالم، يقولون لنا، بالعمل وليس نظرياً فقط، إنه لم يعد مسموحاً إقامة تلك الثنائية العجيبة في بلاد ما بين النهر والبحر – ثنائية العمل المسلح والدبلوماسية التي تحضنها وبذات الوقت تدَّعي الإستقلال عنها. في تلك الظروف، ودون أن ندري، كنا نسهم في كيِّ وعينا على طريقة موشيه يعلون، بالذهاب أكثر صوب الدبلوماسية وسياسة الصالونات ، كبديل واقعي عن البندقية التي كلفتنا الكثير ذات انتفاضة ثانية وأدناها في تضاريس تنافسنا على الإنتحار وتجاوز حدود ما نقرُّ به في أدبيات دبلوماسيتنا ومسارات الحد الأقصى من وقعنة حدود دولتنا العتيدة التي عصرناها وجففناها إلى الحد الذي لم يعد من مجال بعده على التنازل، فأسميناها الإسم الذي يطابق مكانتها: الثوابت الوطنية – أو ثوابت ياسر عرفات.
بعد ذلك مارسنا الإنتهازية – حتى على أنفسنا، فحين ننجح بموقف أو نعبر أزمة ما بسلام، نمنح الثقة مضاعفة لوريث عهد تاريخنا وضميرنا أبو عمار، وإن لم يفلح في مناوشة غرائزنا المتطلبة والملحَّة في استحضار الأنا الفرد والجماعة بيننا، كنا خلسة وعلنا نقرِّع ونذم ونتهم الخلف بالقصور وعدم الأهلية وفقدان الرؤية التي تناسب قيادة قضية بحجم القضية الفلسطينية. الكثير ممن بيننا تعاملوا باستقالة ونأي بالنفس عن واقع الحال وبذات الوقت أحالوا مواقفهم وردود أفعالهم إلى حقائق أوقعتنا في وهدة التباس عميقة وجلدتنا بسوط أسئلة محيرة عمَّن هو على حق ومن هو على ضلال. كثيرون ذهبوا إلى حد التماهي مع مواقف حماس والجهاد وغيرهما، كثيرون خلطوا بين أدب الإلتزام وحق الإعتراض وبين حقهم في الفوضى والتشويش والإعاقة أيضاً، مستغلين اتساع صدر حركة فتح وقيادتها ومنهجيتها التاريخية لقبول الكلام المختلف والإعتراض على موقف أو مسار ما غير واضح أو غير مقنع لأي من مناضليها.
غالباً ما تناسينا أن جذرية المشروع الصهيوني هي العائق الوحيد أمام تحقق أي شكل من أشكال الهدوء والتعايش ومراكمة أسباب سلام تقوم على أساس القرارات الدولية، وعليه كنا ندفع باتجاه افتعال خلاف ما بيننا وتحميل تبعاته إلى القائد الذي استلم دفة المسيرة وراية الغد الثقيل.
إنتهازيين وأنانيين كنا وظالمين لقائدنا. لكننا قوم باكثر من وجه. وأكثر من عقل. ولا نخاف الإلتفاف على ما قلناه قبل، لا نتردد عن تكذيب ما ادعيناه وما مارسناه أمام الملأ. كأن الإنكسار الذي سكننا طويلا لم يزل يبحث عن خلاص أو خاتمة لعذابات النفس غير المطمئنة لواقع يأبى التبدل والإنكفاء إلى مسار معدَّل ومخفف الكلفة.
لم يكن المذنب محمود عباس لأنه وريث قامة عجيبة كياسر عرفات. فهو بهذه الحال أكثر المظلومين. ولو أتى ببيض الرخ لما قبلنا فكرة وجوده كخلف له. كيفما كان الرجل يتحرك أو ينطق أو يبتسم أو يغضب كنا نقارنه، بجفاء وبرفض، بياسر عرفات، جرَّدناه حتى من حق امتلاكه شخصية خاصة به.
لم يكن ذنبه عدم امتشاق البندقية، فقد حلَّ في مواقع نضال أخرى، لم تكن أقلَّ أهمية من البندقية، برع وتألق هناك، وأنتج ما هو جميل في ذاكرة الشعب وقضيته.
لكننا بعد أن أفلسنا تناقضاً واستحضاراً للعيوب والمقارنات القاسية وغير المنصفة بدأنا التمرُّن على فكرة المرحلة التي يمثل أبو مازن نموذجها الحقيقي والدقيق. فوازنّا- افتراضياَ- بين حاجتنا لاستراحة المحارب- دون أن نعترف بهزيمتنا في إدارة الإنتفاضة الثانية، بذلك نكون كمن يختار الشخص الذي لم تحترق أصابعه بجمر الكرة العدوانية المتدحرجة، بالمعنى المباشر للكلمة- وبين ضرورة امتصاص العبث الإجرامي الإسرائيلي بواسطة شخصية تستطيع مخاطبة العقلين الصهيوني والغربي معاً، وانتظار مرحلة قادمة نكون استعدينا لها بترميم الصفوف وإنتاج جيل جديد من الشباب والقادة ممن يستطيعون حمل مسؤوليتها والذهاب بها إلى مستقبل أفضل، متناسين أن شخصية الرئيس محمود عباس تتعامل مع القضايا التي تخصها بوضوح رؤية وتمكن، بحيث يحشر العدو في خانة ردود الفعل الإنتقامية والدائمة التوتر بسبب فقدانها المادة الحيوية والحسية التي يستطيع من خلالها- العدو - ترويج ما يضر ويصيب القيادة الفلسطينية ومعها شعبها وقضيته على المستويين السياسي والأمني وفي بعديهما الداخلي والعام، وهذا ما كان يصبو إليه الرئيس محمود عباس دائماً.
ففي مسألة الكفاح المسلح لم يغادر الرجل موقفه المبدئي من عدم صوابيته- خاصة في المرحلة الحالية، وهو بتركيبته الشخصية لا يحبذ العنف، ويتحرك وفق رؤيته التي تفترض تحييد الآلة العدوانية الإسرائيلية، والضغط الدائم باتجاه فضح السياسة الإسرائيلية وآلتها العسكرية على مستوى العالم.
هذا الموقف لم يعجب الكثيرين منا، لكنه بالمقابل كشف شاعرية ورومانسية شعارات طالما افتقدت للعمق والقدرة على اجتراح البديل الحيوي الذي يؤكد صوابية مواقف وتطلعات المعترضين. حتى في مسألة معالجة الإنقسام الداخلي، لم يرَ سوى الحوار بديلا له، في حين تبارى الكثيرون بيننا على تعريفه بالمتردد والقاصر والفاقد للبعد القيادي في شخصيته.
لماذا لا ندقق في معنى القائد والقيادة؟
كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات يتخذ مواقف وقرارات قد تنسجم أو لا تنسجم مع قناعاتنا وتطلعاتنا، فنعيش التشوش وانعدام اليقين، وأحياناً الغرابة من مشاهد وخطواتٍ غير مألوفة على مسامعنا وما اعتدناه من مشاهد وثيقة الصلة بثقافاتنا وقناعاتنا السياسية، لكننا بذات الوقت لم نكن نقلق ونشكك بنزاهة ووجاهة ما اتخذه الرئيس الشهيد من مواقف وقراراتٍ وأفعال. السبب هو تلك الثقة اللا محدودة التي عايشناها مع هذا الرجل. كذلك فإن الأمر يتعلق بصفات القائد التي قد توافق أو لا توافق تطلعات الإجماع.
أهمية القائد- أي قائد - أنه لا ينتظر المزاج العام لكي يتبنى ما يناسبه من خطوات وتوجهات تجعل من ذلك قميصاً أو زياً فولكلورياً له، بل يبني على ما يراه مناسباً للمصلحة العامة من خلال دراسة كاملة – ذاتية وموضوعية- مبنية على مساحة واسعة من المشهدية النظرية والشاملة بحيث تبرز الواقع الذي يمكِّن القائد من التعامل مع المسألة وفق اختصاصه وتمرُّسه في قراءة وتحديد ما يلزم من قرارات محددة.
بالمقابل، تحرك الرئيس محمود عباس في المنطقة الواقعة بين ضفتي ثوابت الشهيد ياسر عرفات في الجانب السياسي، إنما بواسطة منظومة لغوية- وأدبية غير مألوفة في قواميسنا التقليدية، وأدار دفة القيادة من خلال منهج تخصصي سياسي – إداري، قرأناه خالياً من عاطفة الأبوة والروحانية التي تمثلت بشخصية ياسر عرفات.
أحسسناه سقط علينا لحظة التباس الحال، عندما كان الحزن يطوِّق الأعناق والحناجر، سألنا يومها عن قائد يستطيع ركوب الموج الفلسطيني الغاضب بلوح مصقول من عذاب ودم ورحيل وبحث عن الدروب الضائعة. سألنا عمَّن يكسح رياحَ الغياب عن ألق تدثرته قضية العصر المجبولة بالدويِّ القارص.
ولأنه المشاكس العنيد، استطاع أن يخلع منا وعنا وحشة الظن وارتياب الحواس في زمن القلق النبيل. على راحتين غامضتين- طريتين عبَر بنا زحمة التشوُّش وضباب العالم المستحيل. لم يجبْ على أسئلتنا كلها، ولا بدَّد من خواطرنا هالة الإرتداد إلى زمن اعتدنا المراوغة بين ثناياه العابثة – المخضبة، لكن ما أصابنا من سكينة العاشقين كان بفضله، كونه القادر على انتزاع ابتسامة من الأفواه الجائعة والتواقة للقليل من عسل الربيع، دون أن تمسَّنا الدبابير الحائمة حولنا، لإيفاء نذورها من اللسع والوجع.
بدا أنه القادر على تسكين حيرتنا وانفعالاتنا الهادرة، يكفيه فخراً، ونحن معه، قدرته العجائبية على صنع وحدة بكل محتواها من الضجيج والتعدد. ويكفيه أنه جمع مفارقتي السلطة والثورة في قالب الشرعية السائرة على حدِّ السيف.
لكن العجب الأدهى والأغرب أننا بدأنا الإنحياز للرجل المثير لجدل الجموع – الأقارب وغيرهم، عندما بدأت ردود الفعل الإسرائيلية في الظهور، ناعتة إياه بالأخطر من ياسر عرفات، وبالذي يشكل الخطر الحقيقي على إسرائيل، وبأنه يعمل على عزل إسرائيل واستحضار أسباب العداء لها، وبأنه ليس الرجل المستعد لعقد شراكة السلام مع القيادة الإسرائيلية... وهكذا... إلى الحد الذي يتفوق فيه على حماس والجهاد الإسلامي في التطرف واستهداف إسرائيل- بناء على وجهة نظر المتطرفين الصهاينة.
ورغم ذلك بقينا مستمرين على علاقة فرضية معه، تنطلق من خارطة مفردات ومواقف تحدد شكل وعمق العلاقة معه، بحيث لا ينفك يثير فينا نوازع الماضي وإرباكات نستحضرها من خلال مسافة ننأى بها عنه.
كأننا لم نزل نصر على عدم التصالح معه، بمعنى الشراكة والتزام موجبات قيادته. لم نزل نشعر بالغربة عنه، إلى الحد الذي يبقيه الغامض – الملتبس- المطالب بكشف حساب عن مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل الدائم.
لم يكن يوماً على استعداد لإضافة أية هموم تمس الشعب الفلسطيني ومصالحه، فلم يكن لديه بديلاً للحوار مع حركة حماس إلا الحوار والوصول إلى الوحدة التي ترفع شأن القضية وتبعدها عن الإستقطاب والإستثمار المجاني من هذا المعسكر أو ذاك.
أجاد هذا الرجل التسلل إلينا بالنقاط، فلا أنشدَ ولا هتفَ أو ادّعى ما تميَّز به شهيد المسيرة الفلسطينية وثورتها ياسر عرفات على الرغم من عدم امتلاكه روح الأبوة والتواصل الوجداني والروحي والتاريخي مع الذاكرة الجامعة. كان ولم يزل بالنسبة إلينا يخوض امتحان النجاح في كل موقف أو مباردة.
لكنه حين وقف برام الله خاطباً بالجماهير التي جاءت لاستقباله بفرح لم تشهده فلسطين من قبل، رأيناه بكامل حضوره الخالي من النجومية والزعامة التقليدية، كان به من النشوة المشوبة بالجدية، وبه من الإنفعال الذي حاول ضبطه بالهدوء والرصانة النخبوية، عيناه لأول مرة كانتا تلمعان بحيرة شديدة، هو اللمعان الكامن بين دموع الفرح بالإنجاز غير المسبوق وبين الغضب من المغتصبين الصهاينة وكل الذين وراءهم، ممن هددوا وحاصروا واستعملوا كل أسلحة المنع والترهيب... لكنه لم يأبه ولم يتردد ولم تهزمه أسلحتهم المرعبة كلها.
خلال تلك الوقفة المشبعة بالعزة والإفتخار قال محمود عباس جملته المختصرة التي تتجاوز كل الكتب والقواميس بلاغة : "أليوم صار عندنا دولة". هذه الجملة اخترقت كل الحواجز والموانع والشكوك والأسئلة والإمتحانات الحصرية واللوم الذي احتمينا به... عبرَ الجوارح والقلوب والشفاعات غير المسبوقة ... ونال ثقة خاصة لا ينالها إلا خلف الخالد في عليائيه: علياء الغياب إلى عالم المسكونين بروح الأزل، وثقة السكنى في حالات لحظاتنا وانفعالاتنا الدائمة، السكنى في الأغنيات والأناشيد... والفرح والغضب .









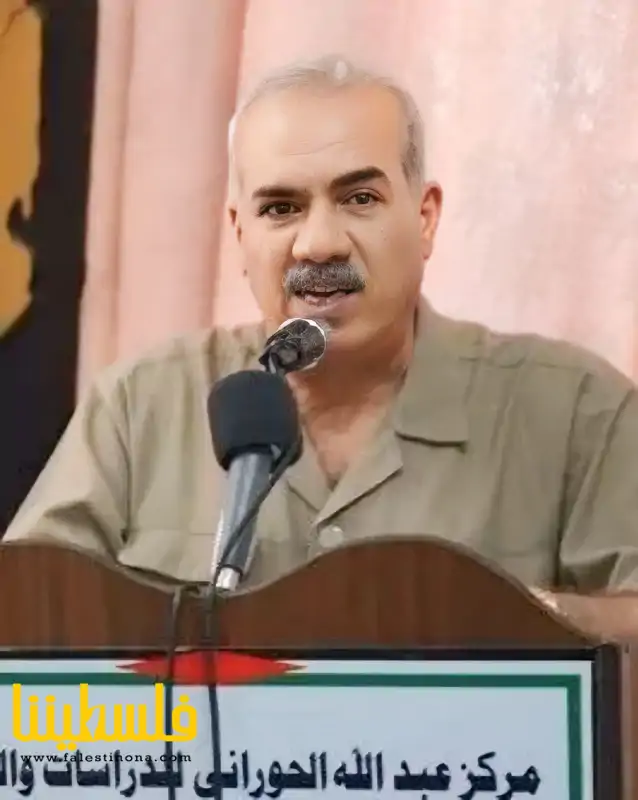







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها