بقلم/ صقر أبو فخر
ما إن أُعلن عن وضع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التنفيذ في 23/4/2014، وجرى تأليف حكومة توافق وطني بكفاءات مستقلة، التي بدأت السير بخطى مدروسة نحو الانتخابات الرئاسية التشريعية، حتى جُنَّ جنون القيادة الاسرائيلية. وكان اليمين الاسرائيلي كله قد ازداد سُعاراً حين تقدمت الدولة الفلسطينية في 1/4/2014 بطلبات للانضمام إلى أربع عشرة معاهدة ومؤسسة دولية تمهيداً للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي تتيح مقاضاة اسرائيل وشخصيات اسرائيلية جنائياً. وعلى الفور اتخذ الانتقام الاسرائيلي شكلين: المزيد من المستعمرات في الضفة الغربية، وقطع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، علاوة على إجراءات أمنية من شأنها التضييق على حياة الناس، وإعاقة حركتهم اليومية... وغيرها. في هذه الأحوال جاءت عملية اختطاف المستوطنين الاسرائيليين الثلاثة بالقرب من مستعمرة غوش عتسيون يوم 12/6/2014، لتمنح القيادة الاسرائيلية الفرصة لاستغلال هذا الحادث وتحويله إلى قضية قائمة بذاتها، واستثمار التداعيات لمصلحتها السياسية والأمنية بذريعة مكافحة الارهاب.
إن الهدف الحقيقي للعملية العسكرية الاسرائيلية هو تقويض المصالحة الفلسطينية، وزرع الفوضى في مناطق السلطة الفلسطينية، واحتلال الضفة الغربية ولو موقتاً، وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين، وهذا كله يجري تحت ستار البحث عن المستوطنين الثلاثة. وفي ما يتعدى ما تريده اسرائيل حقاً من هذه العملية، فإن خطف المستوطنين أربك، بالفعل، الوضع السياسي الفلسطيني في وقت كانت أنظار العالم كله تتحول إلى العراق لمراقبة ما يجري فيه وفي سورية، ومتابعة خطة "داعش" لإقامة ولاية اسلامية في العراق والشام. وفي جميع الأحوال فإن عملية الخطف تطرح على العقل الجمعي الفلسطيني تحدياً سياسياً وفكرياً ذا شقين أو مستويين: المستوى الشعوري الذي يرى في عملية الخطف ثأراً للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وشفاءً للغليل من المحتلين، والمستوى السياسي الذي يقيس الأمور على المصلحة الوطنية ويحسب حساب النتائج والتبعات.
المشروعية غير المصلحة
إن اختطاف المستوطنين، وهم شبه محاربين، أمر مشروع مبدئياً كشكل من أشكال المقاومة. لكننا لسنا هنا في ميدان مناقشة الأمور المبدئية، بل دراسة التبعات الأمنية والسياسية التي من الممكن أن تنجم عن هذه العملية. ولا شك في أن أشكال المقاومة المشروعة قابلة للتغير على المدى المتوسط بحسب المصلحة، وهي ليست ثابتة بالمطلق. فخطف الطائرات كان مفيداً في البداية، لكنه تحول إلى عكس الغاية منه، وصار عبئاً على النضال الفلسطيني. وكذلك الهجوم على السفارات الاسرائيلية في دول العالم الذي وإن صبَّ في سياق تعريف الرأي العام العالمي إلى قضية فلسطين في إحدى المراحل، إلا أنه انقلب في ما بعد إلى سلوك سلبي وبات إرهاباً في نظر الرأي العام العالمي إياه.
إن العقل السياسي هو الذي يزين الأمور بميزان المصلحة الوطنية. بينما العقل المشيخي لا يحسب أي حساب للأرباح والخسائر بل للأثر الاعلامي والنكاية. وعملية خطف المستوطنين، على مشروعيتها المبدئية وجاذبيتها النفسية، يُخشى أن يُحوِّلها الاسرائيليون إلى عنف غير منظور، أي أن يعمد الاسرائيليون إلى تحويل الواقع الفلسطيني المستجد إلى ميدان للعنف من دون الظهور مباشرة على المسرح، ما يعني اندلاع موجة من الاغتيالات الغامضة والاعتقالات والتفجيرات والشائعات وغير ذلك من الوسائل الخبيثة. والمعروف أن العنف يتزايد حين يفشل الحل السياسي. وقد فشلت المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي تفاقم فيه فشل حركة حماس في إدارة شؤون قطاع غزة بعدما حوّلت المقاومة إلى مجرد إطلاق صواريخ (صورخة المقاومة). لكن الفشل الأهم هو فشلها في وضع حد لنمو الجماعات الإرهابية مثل "جيش الأمة" و"جند أنصار الله" وغير ذلك من المجموعات الفطرية السامة التي نمت، في البداية، تحت عباءتها.
الإخفاق الأمني
تكشف عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، أَكانت حركة حماس هي التي نفذتها أم إحدى الجماعات الاسلامية الأخرى، إخفاقاً أمنياً ومعلوماتياً خطيراً للأجهزة الاستخبارية الاسرائيلية. ولعل أكثر ما تخشاه الدوائر الأمنية في اسرائيل، ومعها المستوى القيادي السياسي، أن تنجح الجهات الخاطفة في إخفاء المخطوفين والاحتفاظ بهم في مكان آمن لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في ما بعد، الأمر الذي يشجع آخرين على وضع الخطط لاختطاف اسرائيليين للغاية نفسها. لذلك يبدو الجيش الاسرائيلي وهو يعيد احتلال مناطق السلطة الفلسطينية ويفتشها متراً متراً و "زنقة زنقة" كأنه أمام اختبار حاسم ومدمر للأعصاب، بل إن هذا الاختبار سيكون مهيناً حقاً في ما لو فشل هذا الجيش في العثور على المستوطنين الثلاثة.
لنتذكر أن امتناع اسرائيل عن إطلاق سمير القنطار في سنة 2004 بعدما كانت التزمت وعداً بذلك، أدى إلى قيام حزب الله بأسر جنديين اسرائيليين في سنة 2006، ما تسبب في اندلاع حرب تموز 2006. وعلى هذا المنوال، فإن امتناع اسرائيل عن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين أدى إلى هذه العملية المربكة والمحيرة والخطرة. والبرهان على خطرها وحيرتها أن لا أحد اعترف بمسؤوليته المباشرة عن هذه العملية. وهذا الغموض يتيح لأي اسرائيلي أن يلقي المسؤولية على هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك، في الوقت الذي يبدو أن الجهة الخاطفة شديدة الحرج ولا تستطيع المجاهرة بفعلتها خوفاً من التبعات السياسة والأمنية، وخشية من ردة فعل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين سيتحملون مباشرة تبعات هذا العمل الخطير.
مخاطر غير محسوبة
إذا استنفد التفتيش الاسرائيلي أهدافه، وإذا لم تنجح الاعتقالات العشوائية في التقاط أي معلومة عن مكان المخطوفين ومصيرهم، وهل ما زالوا أحياء حقاً، وإذا لم يتم العثور عليهم في فترة قصيرة، فإن الأمور ربما تتطور بطريقة دراماتيكية بحيث تضع أمن الفلسطينيين في الضفة والقطاع تحت الاختبار بالنار. ومن المتوقع أن تعمد السلطات الاسرائيلية إلى نفي عدد من قادة حركة حماس إلى قطاع غزة، وأن تقوم في الوقت نفسه بتوجيه ضربات متتالية لحركة حماس (ومعها حركة الجهاد الاسلامي) في القطاع، وسترد الحركتان بالصواريخ على المواقع الإسرائيلية في جنوب فلسطين. ويفترض هذا السيناريو أن تتدهور الأحوال الأمنية والعسكرية بصورة متمادية، وأن تنزلق الأوضاع إلى مزيد من العنف.
في معمعان هذه الأحول، واستشعاراً بالمخاطر الجمة التي تتربص بالفلسطينيين في الضفة وغزة، كان موقف القيادة الفلسطينية ذكياً جداً وموفقاً، فقد اختارت التوجه إلى مجلس الأمن لطلب حماية الشعب الفلسطيني من الأهوال التي تحدق به من كل صوب. فإما أن يتمكن مجلس الأمن من لجم اسرائيل عن عدوانها، أو تجري المواجهة هذه المرة تحت عيون العالم قاطبة حيث ما عادت ذريعة مكافحة الارهاب تكفي لإقناع العالم بمشروعية الموقف الاسرائيلي، أي انتفاضة جديدة تحمي الشعب حقاً، وتجعل الاحتلال يدفع ثمن غطرسته.
* * *
ليس من المجدي القول، كما يحلو للبعض، إن من الضروري إطلاق المخطوفين بلا ثمن. المجدي هو إخضاع ما حدث للمصلحة الفلسطينية العليا، وتأمين مخرج ملائم إما بأقل الخسائر أو بأقصى المنافع. لكن مَن يحدد المصلحة الفلسطينية العليا في هذه الأحوال؟ أعتقد أن السلطة الوطنية هي التي تعقد لواء هذه المصلحة، ومن دونها لا يمكن الكلام على مرجعية وطنية حقيقية بصرف النظر عن الخلافات السياسية الناشبة بين المجموعات الفلسطينية، وهي مسألة دائمة. ولا بد من الاستظلال دائماً بهذه المرجعية التي لا يمكن الاستغناء عنها البتة، وهذا ما برهنت عنه تجربة الانفصال في قطاع غزة. وفي هذا الميدان من التفكير السياسي ثمة قاعدة ذهبية لا بد من ترسيخها وهي أنْ ليس في الإمكان تكرار تجربة حزب الله في فلسطين، أي بقاء حركة حماس قوة عسكرية مستقلة تنفذ سياسات منفصلة عن المرجعية السياسية، وتبقى في الوقت نفسه شريكة في حكومة فلسطينية لها سياستها العامة.
إن سلطة واحدة بإقليمين منفصلين غير ممكنة. وسلطة واحدة برأسين غير ممكنة. وسلطة واحدة بسلاحين غير ممكنة. الممكن هو سلطة واحدة بحكومة واحدة وبأجهزة أمنية وإدارية واحدة وبسلاح واحد. أي سلطة وحيدة تحتكر وحدها القوة والسياسة والعنف. ومَن لا يعجبه هذا الأمر فليذهب إلى الشارع فيتظاهر ويحتج ويعارض من خلال مؤسسات المجتمع المدني كالأحزاب والفصائل والنقابات والصحافة... الخ. لكن ليس له الحق في استخدام العنف بمعزل عن المرجعية السياسية.
















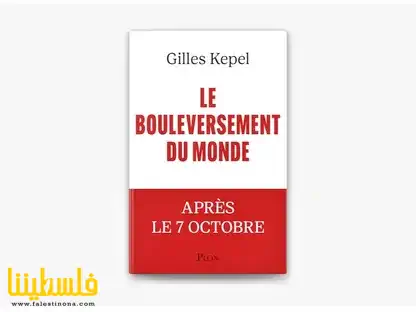
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها