منذ أن بدأت الاتصالات الفلسطينية مع الولايات المتحدة، قبل اتفاق "أوسلو" لم يُظهر الأميركيون تمسكاً بشيء لصالح التسوية المتوازنة، ولم تكن لديهم اية محددات ثابتة يقيسون عليها. ولو عدنا الى تاريخ الوساطة الأميركية، والى الموقف الفلسطيني الذي قدم التوطئة المطلوبة لهذه الوساطة؛ نستذكر خطاب الرئيس الشهيد ياسر عرفات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) 1988 يوم أن انتقل الانعقاد الى مقر عصبة الأمم القديم في جنيف بسبب رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة الدخول للزعيم الفلسطيني. ففي ذلك الخطاب، قدم الرئيس عرفات مبادرة بمضمون يلبي المتطلبات الأميركية لبدء الحوار مع واشنطن، وافترضنا حينها أن على هذه الأخيرة أن تفرض بنفوذها على تل أبيب قطع المسافة التي يتعين عليها أن تقطعها وصولاً الى تسوية تاريخية. فقد أعلنت منظمة التحرير بلسان الزعيم عرفات عن الاستعداد للاعتراف بإسرائيل والعيش معها بسلام، في إطار حل تقوم بموجبه دولة فلسطين على أراضي 67. وأظهر الأميركيون قبل حصولهم على ذلك الإعلان، قناعة بأن الجانب الفلسطيني قدم ما عليه لكي تتحقق التسوية. بعد ذلك تتالت الفصول وبدا أن الطرف الأميركي لا يعتزم ممارسة الضغط على إسرائيل، وإنما يهدف الى تجويف الموقف الفلسطيني شيئاً فشيئاً، لصالح إسرائيل، مقابل لا شيء للشعب الفلسطيني. ولما أبرم اتفاق "أوسلو" لإعلان المبادئ، تلقف الأميركيون الموقف وبدأوا في مساعدة إسرائيل على إفراغ الاتفاق من مضامينه الضحلة أصلاً، وأوصلوا التطبيقات الى طريق مسدود، بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، ما جعل الوضع يتفجر بسبب الانسداد وممارسات الاحتلال المستفزة. ولما أدخلونا الى دائرة العنف من جديد، وعربدت الآلة العسكرية الإسرائيلية فقتلت ودمرت، عدنا الى نقطة الصفر. وفي نقطة الصفر تلك، هددوا بتغييب ياسر عرفات وحمّلوه المسؤولية عن تردي الأحوال، ونفذوا تهديدهم، وانتقلت السياسة الاسرائيلية الى أيدي متطرفين عارضوا بشدة، ومنذ البداية، العملية السلمية برمتها!
وفي مرحلة قيادة الرئيس محمود عباس، ظنوا أن الرجل يمكن أن يستجيب لرؤية إسرائيل للحل، وهي رؤية لا تُبقي شيئاً للشعب الفلسطيني. وكان واضحاً أن ما يريدونه هو الطرح نفسه الذي ظل يكرره روبنشتاين، رئيس وفدهم الى محادثات مدريد واشنطن على مدى عشر جولات تفاوضية: لا حديث عن القدس، ولا حديث عن حق العودة، ولا دولة بين النهر والبحر، ويمكن القبول بإدارة ذاتية لحياة السكان، بمستوى عمل البلديات والمجالس القروية!
خلال السنوات التي مرت، وعلى الرغم من تداعيات التعنت الاسرائيلي في الوطن وفي الإقليم، وعلى الرغم من حاجة أميركا نفسها لاستقرار الشرق الأوسط؛ لم يُمارس ضغط جدي على المتطرفين الذين يحكمون إسرائيل وينفذون مشروعاً استيطانياً في الضفة. وكلما مر الوقت، كانت تنشأ وقائع جديدة على الأرض، فتتضخم المشكلة ويبتعد الحل. انتشرت المستوطنات كالسرطان وجرت عمليات تهويد القدس على قدم وساق، وبات ما يريده الأميركون هو إطالة أمد المفاوضات، بينما عمليات التوسع الاستيطاني جارية ومراحل تغيير الطابع العربي الإسلامي للقدس لا تتوقف حتى وصلت الى مراحلها الأخيرة. ولم يُظهر المحتلون امتناناً للمساندة الأميركية على مر العقود، وإنما افتعلوا ويفتعلون خلافات مع الأميركيين أنفسهم، في ذات الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لإعطائهم وقتاً إضافياً للمراوغة السياسية والاستمرار في الاستيطان. وبات الموقف الآن، هو عرقلة تنفيذ الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى حسب الاتفاق، وهم أقل من ثلاثين أسيراً. في هذه المسألة الجزئية والصغيرة يساومون، ووضعوا الوسيط الأميركي جون كيري في موقف المُلام بل في موقف الشخص غير المرغوب فيه، حتى أصبح ضعيفاً يمثل إدارة لا حول لها ولا قوة.
لا حاجة لأن يرشَحْ شيء عن لقاء الرئيس "أبو مازن" في عمان مع جون كيري، لكي نعلم يقيناً أن السياق عقيم، وأن الموقف يتطلب استراتيجية عمل جديدة، يمكن أن تتاح من خلال تصليب الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاض الحالة الجماهيرية التي لا تنهض بغير تحولات في طريقة الأداء في العمل السياسي والاجتماعي، الذي يأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة، ويهيئ البُنية الوطنية التي تساعد على الصمود!











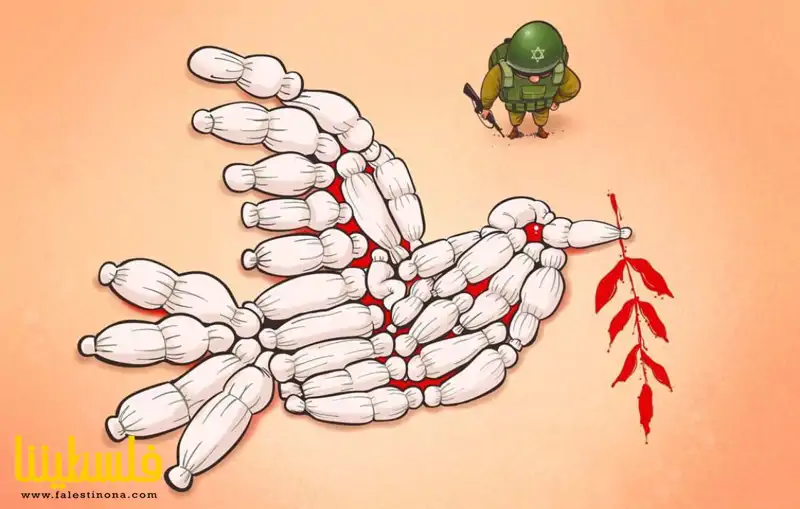



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها