بقلم/صقر أبو فخر
لا ندري، على وجه الدقة، متى بدأت النكبة الحقيقية للعرب. هل بدأت في 10/2/1258 يوم سقوط بغداد تحت سنابل خيل هولاكو؟ أم في سنة 1400 حين احتل تيمورلنك الأعرج دمشق وخرّبها؟ أم في سنة 1516 عندما غزا السلطان سليم الأول بلاد الشام؟ أم في سنة 1917 حين هُزمت الدولة العثمانية في الحرب العاليمة الأولى، وغادرت هذه البلاد بعدما تركتنا غنيمة لقوات الحلفاء وللسيدين سايكس وبيكو ولإعلان بلفور معاً؟ أم في 24/3/1924 يوم إعلان نهاية الخلافة الاسلامية في اسطمبول؟ أم في 29/11/1947 حينما تبنت الأمم المتحدة بأوامر من الريس الأميركي هاري ترومان خطة تقسيم فلسطين؟ أم في 14 أيار 1948 عندما أعلن دافيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل؟ أم في 5 حزيران 1967 حين هَزَمت اسرائيل النظامين القوميين في سورية ومصر وأكملت احتلالها فلسطين كلها؟ أم في 5 حزيران 1982 حيث كشفت تلك الحرب أن الاستناد الى أنظمة الحكم العربي لحماية الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية خرافة؟ أم في 9/4/2003 يوم سقطت مدينة بغداد بين أيدي الجنود الأميركيين؟ أم في التحولات العربية الدرامية الراهنة التي أطلقت عقال همجية مثل "داعش" و "النصرة" وغيرها؟
يلوح لي أن تاريخنا، القديم والحديث، هو تاريخ النكبات والانقسامات، وما زالت الحال على ما هي عليه منذ زمن طويل. لكنه، في الوقت نفسه، تاريخ من المواجهة والمقاومة ومعاندة الوقائع والتشبث بالأرض. ولولا هذه المقاومة والمحاولات الدائبة لصنع الحرية وصوغ المستقبل لكانت اسرائيل تنظم الحجيج في مكة أو تبيع النفط في الأحمدي بالكويت.
اللعب بالنار
لا أبالغ في الكلام على أن برنامج حركة فتح السياسي هو الوحيد الذي عانق المستقبل الفلسطيني. والفتحاويون بالمعنى التاريخي الواسع هم مَن سعوا حقاً لفلسطين المستقبل. أقول هذا على الرغم من السواد الكثير المحيط بنا، وعلى الرغم من الخيبات والمرارات وفقدان الأمل أحياناً. لننظر الى ما حل بمن انشق على فتح! ماذا كانت نهاية صبري البنا( أبو نضال)؟ قُتل أو انتحر كالبعير الأجرب في العراق بعدما أشاع القتل والاستخبار المأجور في كل مكان، وتوزع أعضاء منظمته على الاستخبارات كلها طلباً للحماية لقاء الاعترافات والبوح بما يملكون من معلومات. لنلاحظ كيف انتهى مصير الذين خرجوا على فتح في سنة 1983! انتهوا الى ان يصبحوا مياومين في الاستخبارات بعد ما نهبوا وقتلوا وباعوا ممتلكات الحركة وتاجروا بالمخدرات وبالعملات المزورة، بل أنشأوا عصابة "فتح الاسلام " من تحت العباءة الفتحاوية التي تسربلوا بها، ثم مات مَن مات منهم فلم يحزن عليه أحد. واليوم يحاولون إحياء محمد دحلان في غزة؛ يا للسخرية الهاذية. فالعلاقة المستجدة بين دحلان وحركة حماس لا علاقة لها بالسياسة بمعناها الراقي البتة، إنما هي الانتهازية المبتذلة في حد ذاتها، بل النكاية في صورتها المنحطة التي تخجل السياسة من وجهها الابتزازي السافر.
إن اللعب بالنار لا يجعل النار لعبة. والتظاهرات التي حاول محمد دحلان في 18/12/2014 أن يجعل منها حدثاً سياسياً، فضحت الانحطاط الذي بلغت اليه الاوضاع في قطاع غزة. ففي إحدى المرات توعد محمد دحلان حماس بـِ "ترقيصها خمسة بلدي"، وها هو اليوم يرقص على موائدهم ويغني المواويل في احتفالاتهم. وسيجد دحلان (ما غيرو) كثيرين مستعدين للتعامل معه لقاء بضعة دنانير وبعض الشواقل. لكن ذلك لن يكون له أي أثر جدي في انتزاع موقع سياسي له، ولن يكون له أي تأثير في السياسات العامة. فمن أتى بالمال باللعنات يذهب. غير أن الأمور لا تجري هكذا بوضوح تام، فثمة من يلعب بالنار حقاً عشية المؤتمر العام السابع لحركة فتح. ودحلان إنما يفتش عن الشقوق اليابسة في الأرض الفتحاوية ليتسلل منها الى الاضواء وهذه هي مسؤولية فتح في كل يوم، ومسؤولية المؤتمر العام السابع غداً، أي سد هذه التشققات، ورصّ الأرض التي يقف عليها الجميع.
إنسوا المصالحة
إن فتح، ومعها كثيرون من الاتجاهات الأخرى، ما زال هدفهم هو الهدف التاريخي إياه: التحرر الوطني وتأسيس دولة مستقلة للشعب الفلسطيني. وما برح هذا الهدف هادياً للفتحاويين وللوطنيين الفلسطينيين من شتى الفصائل الفلسطينية الوطنية. لكن، هل هذا هدف الآخرين؟ ما هو مشروع حركة حماس من أجل الدولة الحرة والاستقلال؟
لا شيء. مشروعهم الوحيد هو الخلافة الاسلامية. أما إذا كان ذلك صعباً فالإمارة الاسلامية في غزة تكفي مؤقتاً لذلك لا تنتظروا المصالحة الوطنية في هذه المرحلة. والأمر ليس استنتاجاً مني على الإطلاق، بل إن تصريحاتهم ومواقفهم تدل على ذلك مباشرة. ففي حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في 23/6/2007 أعادت جريدة "البيان" الاماراتية نشر مقتطفات منه في 24/6/2007، ثم نشرت مجلة "الحرية" النص كاملاً في 1/7/2007 قال محمود الزهار في جواب عن سؤال في شأن تأسيس إمارة اسلامية في غزة: " بالطبع نريد أن نفعل ذلك، لكن بدعم كامل من الشعب (...). وبما أننا لا نملك دولة حالياً فسنحاول تكوين مجتمع اسلامي؟. وفي برنامج" نقطة نظام" (قناة "العربية"، 6/7/2007)كشف محمود الزهار أن حماس بدأت التحضير للسطيرة على قطاع غزة منذ أيلول 2006، وأنها وضعت خطة للاستيلاء على الأجهزة الأمنية ومقارها، وأنها حفرت أنفاقًاً تحت مقار هذه الأجهزة مثل الأمن الوقائي في خان يونس (أنظر أيضاً مجلة "الحرية" 15/7/2007، أي أن بعض قادة حماس كانوا، منذ البداية، غير راغبين في أي شراكة سياسية مع حركة فتح، وهو ما حدث في 14/6/2007 في الانقلاب الدموي الذي جعل من حماس سلطة الأمر الواقع في غزة، ومنذ ذلك الوقت وحماس تفرض شروطاً لإتمام المصالحة بدلاً من أن تقدم تسهيلات، وهذا سلوك غير معقول لمن يملك مشروعاً وطنياً للاستقلال والتحرر. ودائماً لدى حماس شروط أمنية، وشروط في شأن دفع رواتب 41 موظفاً غير موجودين في السجلات المالية والادارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وشروط تتعلق بمن ارتكب الجرائم في حق الفتحاويين في سنة 2007،وشروط سياسية في شأن المفاوضات مع اسرائيل. ومن غير المنطق فرض هذه الشروط كلها مسبقاً ما دامت حماس ستصبح شريكة في حكومة الوحدة الوطنية ( أو التوافق الوطني)، ولها الأغلبية في المجلس التشريعي، وهي قادرة، بهذا الموقع، على إعاقة أي قرار سياسي للرئيس محمود عباس، ولن يكون من الممكن اتخاذ اي قرار سياسي من دون موافقة حماس. ومع ذلك فإن حماس أجهضت المصالحة مباشرة بعد توقف العدوان على غزة. فالذي يتطلع الى المصالحة حقاً لا يفجر سيارات الفتحاويين ومنازلهم في غزة عشية احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد ياسر عرفات، ولا يتراقص على التشققات في الجسم الفتحاوي في غزة.
بين الانقسام والمعارضة
هل ثمة حقاً انقسام في حركة فتح في غزة؟ وهل ان محمد دحلان وأتباعه من الناقمين أو المنعمين بالأموال الجديدة يشكلون فعلاً حالة انقسام؟ وما الفارق بين المعارضة والانقسام؟ ومنذ البداية أعتقد أن حركة محمد دحلان هي من طراز الانشقاقات القشرية التي تتساقط في كل مرحلة عن جسم الحركة فتهترئ وتبقى الحركة. هذا ما حصل مع أبو يوسف الكايد في سنة 1973، وكذلك مع سعيد المزيّن (أبو هشام) في سنة 1978، ومع أبو سائد في سنة 1981. وبرهنت الانشقاقات كلها أن فتح مثل "أذن الفرس"، تحركها فتجدها طرية، تشدها فتتحول قاسية جداً.
ثمة فارق جوهري بين الانقسام والمعارضة جبهة الرفض مثلاً التي ظهرت في سنة 1974 بعد تبني منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك البرنامج المرحلي، أو برنامج النقاط العشر، هي معارضة لأنها ظلت في إطار البيت الفلسطيني الواحد. لكن انشقاق المنشقين في سنة 1983 ثم تأليف "جبهة الانقاذ" (إقرأ: جبهة الأنقاض) هو انقسام جرفته الانتفاضة الأولى في سنة 1987. وما جرى بعد اتفاق أوسلو هو انقسام أيضاً انتهى بالانتفاضة الثانية في سنة 2000. أما انقلاب 2007 في غزة فهو انقسام اضافي لم تنتهِ مفاعيله بعدُ.
مشروعان لا يلتقيان
إن حركة فتح، على بساطة الأفكار الأولى التي ظهرت في "بيان حركتنا" في سنة 1959 كانت المنظمة السياسية الأرقى التي عانقت في نضالها حقائق العصر منذ بداياتها، فكانت حركة تحرر وطني في عصر التحرر الوطني، ودعت الى دولة ديمقراطية في فلسطين في حقبة كانت الديمقراطية احدى علامات الفكر التقدمي، وتمكنت من أن تخترق الوعي الغربي بأطروحتها عن التحرر الوطني وعن حرية الشعوب في تقرير مصيرها، وعن الديمقراطية معاً. وها نحن اليوم نخطو نحو مسار جديد سيتوّج يوماً ما بالحرية على غرار جنوب افريقيا؛ إنه الهجوم الفلسطيني الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة في سبيل الدولة الفلسطينية المستقلة، والنضال، في الوقت نفسه، ضد الهجوم الاسرائيلي في شأن "يهودية الدولة الاسرائيلية".والفلسطينيون بهذا المعنى هم الوحيدون من بين العرب الذين يناضلون في سبيل مشروع سياسي ينتمي الى المستقبل. فالإخوان المسلمون وحزب التحرير يسعون لإمارة أو لإقليم يعلنون منه الخلافة، وقد ثبت خُبال هذه الفكرة. والتكفيريون من كل طراز يقاتلون من أجل مشروع خرافي سيفتت المنطقة العربية بأسرها. والنظم العربية تقاتل في سبيل بقائها. والطوائف وفي معظمها، ولا سيما في لبنان والعراق تتقاتل على مصالح نفعية وبائسة. ولو حوّلنا أبصارنا نحو المشرق لن نرى الا داعش والنصرة وكتائب عبدالله عزام وجند أنصار الله وأنصار الشريعة وجيش الاسلام وأنصار بيت المقدس، وجماعات مثل عدس الشام لا عدَّّ لها. وهذه الكائنات التي تنقسم في كل يوم كالدودة الشريطية لا تفعل شيئاً إلا إشعال الحرائق وتفكيك المجتمعات العربية.
الشوط الأخير
في 29/10/2014 أعلنت الحكومة السويدية اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، فافتتحت بذلك مساراً جديداً لدول الاتحاد الاوروبي، فتبعها البرلمان الاسباني الذي تبنى في 19/11/2014 قراراً يدعو الحكومة الاسبانية الى الاعتراف بدولة فلسطين. ثم كرت السُبحة؛ فتبنى البرلمان الفرنسي الموقف نفسه في 2/12/2014، وبرلمان اللوكسمبورغ والبرلمان الاوروبي في 17/12/2014، وتبعهم في الموقف نفسه مجلس العموم البريطاني وبرلمان البرتغال والبرلمان الايرلندي، وقررت الدول الموقعة على معاهدة روما قبول فلسطين دولة مراقبة في محكمة الجنايات الدولية في 9/12/2014.
إن هذا التسونامي الدبلوماسي الأوروبي هو رسالة مكشوفة الى اسرائيل كي تتخلى عن عنجهيتها التفاوضية، وأن تبدأ التفتيش عن مخرج سياسي لمنح الفلسطينيين حقوقهم كشعب يتطلع الى تقرير مصيره. وهذه الاعترافات المتوالية تفتح بالتأكيد مساراً سياسياً سيؤدي في يوم من الأيام إلى دولة فلسطينية حرة. وهذا المسار يعيد الى ذاكرتنا ما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وهو يشبه بالفعل تلك الحقبة التي سبقت انهيار نظام الأبارتهايد. فحينما تصبح قضية ما مصلحة دولية، ويبدأ الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على الدولة المعرقلة لهذا الحل، فإن الوقت لن يطول كثيراً حتى يتم التوصل الى مخرج سياسي وإن تخللت ذلك صدامات عسكرية ومعارك وكوارث احياناً. ثم ان هذه الصحوة الدولية في شأن فلسطين لم تهبط على أوروبا كهبوط الوحي، إنما هي وليدة نضال فلسطيني مديد دشنته حركة فتح منذ خمسين سنة بالتمام، وشهدنا إبان هذا النضال انتصارات وهزائم، كبوات وصحوات، تراجعاً وتقدماً، بطولات وطعنات في الظهر.
إن اسرائيل خائفة جداً من توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وهي تعرف ان هذا المسار الجديد سيؤدي حتماً الى دولة فلسطينية. دولة فلسطينية؟ ولِمَ لا ؟ لقد نشأت دولة جديدة في جنوب السودان. وقبلها ظهرت دولة في شرق أندونيسيا، وصار للصرب دولة وللكروات دولة وللمسلمين دولة في أراضي يوغوسلافيا السابقة، وانفصل السلاف عن التشيك في أوروبا الوسطى، وها هي دولة كردية في شمال العراق توشك على الظهور، فلماذا لا تقوم دولة فلسطينية أيضاً.
إن اسرائيل هي الأكثر خوفاً من هذا المسار، وهي تعلم ان، الدولة الفلسطينية آتية لا ريب فيها، لذلك تحاول، بقوة، عرقلة هذا المسار وتحصين كيانها بفكرة "يهودية الدولة". وهي بمطالبتها الحثيثة بالاعتراف بها دولة يهودية إنما تفصح عن خشية مركبة، خشية من أن ينتقل فلسطينيو 1948 من المطالبة بدولة لجميع "مواطنيها" كما هي حال معظمهم اليوم (أي المطالبة بالمساواة)، الى استخدام العنف في المستقبل للحصول على حقوق قومية متساوية، ولا سيما أن عدد اليهود في فلسطين سيصل، بحسب التوقعات الاحصائية الاسرائيلية، الى نحو ثمانية ملايين نسمة في سنة 2030، بينما سيصل عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية الى نحو عشرة ملايين. ومن المتوقع أن يبلغ عدد فلسطينيي 1948 الى نحو 2.4 مليون نسمة في سنة 2030، أي الى نحو 30% من سكان اسرائيل، وهذا أمر يخيف راسمي السياسات المستقبلية.
ولمواجهة هذا الكابوس تعمل اسرائيل، على المدى المتوسط، الى خفض نسبة الفلسطينيين الى مجموع السكان من 18% كما هي اليوم، اي 10% أو أقل، الأمر الذي يحول دون تحوُّل اسرائيل دولة ثنائية القومية. ولا يمكن الوصول الى هذه الغاية إلا بالانفصال الجغرافي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق يصر الصهيونيون، يميناً ويساراً، على اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الاسرائيلية وإعلان فلسطينيي 1948 الولاء لها. والرد الفلسطيني كان دائماً هو هو: إن ولاءنا هو لشعبنا وليس للدولة التي تحكمنا قسراً.
مهما يكن الأمر، فإن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية سيجر الفلسطينيين، رويداً رويداً، الى التنازل عن حق العودة، وتصبح حقوق الفلسطينيين في مناطق 1948 في مهب الرياح، فحتى لو أصبح عدد هؤلاء في يوم من الايام نصف عدد سكان اسرائيل، فلن يكون لهم، بموجب الاعتراف بيهودية اسرائيل، أي حقوق قومية.
قصارى القول، إن إحدى نتائج حرب 1948 كانت خسران الفلسطينيين وطنهم، أما اليهود فتمكنوا، بمساعدة الغرب الاستعماري، من تأسيس وطن لهم. ومع ذلك، فإن اسرائيل ما برحت مصرّة على اعتراف الفلسطينيين بها دولة يهودية، وهي مفارقة ذات دلالة. فإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية لا تمتلك السيادة على الأراضي الفلسطينية حتى الآن، فلماذا تطالبها اسرائيل بالاعتراف بحق اليهود في امتلاك معظم أراضي فلسطين؟ إنه إقرار صريح بأن مصير اسرائيل مرهون بإرادة الضحية، وأن اعتراف العالم بإسرائيل الذي كان كافياً في الماضي، ما عاد كافياً اليوم، وأن مستقبل اليهود في فلسطين لا يمكن ضمانه إذا لم تُحل القضية الفلسطينية حلاً يُرضي الفلسطينيين أنفسهم. وعلى هذا الحل الغائب وصورته ومضمونه وتفصيلاته يدور الصراع الدامي والدبلوماسي والسياسي والقانوني في هذا الايام.
خاص مجلة "القدس"/ العدد السنوي


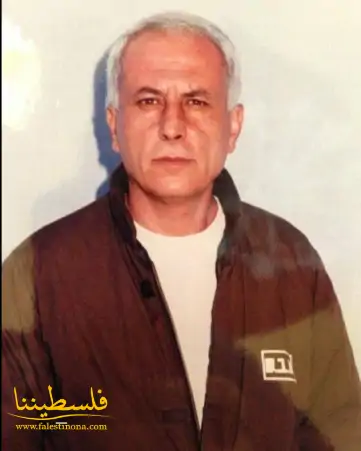











تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها