قبل أن تقع الخصومة الفلسطينية، حذرنا منها، وتعرضنا بالنقد، لمنطق النافخين في النار، وظللنا نذكّر بأن الخطاب ذا الوعود القصوى واللغة المزلزلة، يحبط الناس مثلما تحبطها السياسات الاستسلامية الرقيعة. وحين يتقصى باحث خلفيات كل من استأنس بالفتنة وبالانقلاب، ليكيل لحركة «فتح» اتهامات من كل صنف، سيكتشف أن هناك عورة، أو نقطة ضعف، أو غاية رخيصة يريد التغطية عليها أو تمريرها وهي لا علاقة لها بالوطن، ولا بالسياسة ولا بالمقاومة. لقد افترضنا الكثير من هذه الدوافع، وابتعدنا قدر الإمكان عن الخوض في المسائل الشخصية، علماً بأن بعض الذين دأبوا على التجني ورمينا بالسهام المسمومة، كانوا من المعلومين لدينا، بسقطاتهم الشخصية وحكاياتهم الفائحة ومقاصدهم. وكان البعض الآخر جاهلاً وقصير النظر أو من الواهمين، وقد ظن نفسه قد أمسك بناصية التاريخ، وانه يتصدر عهداً يجب ما قبله، وأن لا عودة للحركة الوطنية الفلسطينية، التي اختزلها الحاقدون من رُماة السهام، في بعض أسماء وعناوين وممارسات، وأمعنوا في هجائها وبالغوا في أمرها، حتى صار إسم «دايتون» هو الذي يلي اسم السلطة أو «فتح» عند الإشارة الى أي منهما!
في تلك الأيام السوداء، ساعدت فضائيات الفتنة ومعها متطوعو السوء وأنظمة الدسيسة في محاولات تشويه الحركة الوطنية الفلسطينية. كان ظاهر المساعدة، هو التعاطف مع «المقاومة الإسلامية»، أما باطنه، فهو الإجهاز عليها تماماً، بعد شطب الحركة الوطنية وإدخال فلسطين الى حال اللا تشكُّل الكياني. فالمريبون يعرفون أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني، التي باتت طرفاً ماكثاً في قلب الجغرافيا وفي قلب أحداث المنطقة، إن اندثرت، لن يُسمح لبدائلها بالنهوض، وبخاصة عندما تكون ذات ايديولوجيا دينية أو ذات وجهة «جهادية»!
في سنوات التغالظ والقسوة، وكيل الاتهامات، كنا نخاطب الباغي المتعالي، أكثر مما نخاطب المستهدفين والضحايا والمندهشين لما تداعت اليه الأمور، ولما استحدثه الانقلابيون من بدع وضلالات، في تاريخ علاقة الفلسطيني بأخيه الفلسطيني، وفي تاريخ علاقة المسؤول المؤتمن على أمر الناس، بمواطنيه أو رعاياه من كل ألوان الطيف، ومن كل المنابت المتجاورة، قرى ومدن ومشارب وأماكن سُكنى!
لم نكن نكابر كلما عدنا للتأكيد، على أن الفلسطينيين أذكياء، وعلى أن الحركة الوطنية الفلسطينية ستظل تحظى بمحبة الناس واعتزازها وولائها، مهما تفشى الخطاب الظلامي لفترة. ففلسطين هي أرض الاختبار الحقيقي لصدقية كل النصوص والشعارات والبرامج. وشعب فلسطين لا يقبض كلاماً فاقداً للدلالة، ولا يخدعه ملتح أو مدع ثورية من أية حركه، إن كان في سلوكه، يجافي شرع الله ويمرق عليه، أو كان فاسداً لا يؤتمن على قضية أو على أي تفصيل في الوطن!
لم نكن نكابر ونحن ننصح الحمساويين أن يلتقطوا خيط الرُشد والحكمة والواقعية، وأن يستفيدوا مما أتيح لهم من مشروعات للمصالحة أعطتهم ما ليس من حقهم، على حساب هيبة وقدرة الكيانية الوطنية والسلطة نواة الدولة. اليوم لا يصح أن نذهب الى مصالحة دون أن تتوافر شروطها الدستورية السارية على الجميع. فقد كانت رسالة المليونية الزائدة أمس، لسلطة الحكم في غزة، أن تنويم المارد الشعبي أو إنكار وجوده أو البطش به، لم يعد ممكناً. الممكن الوحيد، هو المشاركة القائمة على التعددية والتسامح وإنفاذ القانون لرد الحقوق. والممتنعون عن المصالحة، منذ الآن، هم الرافضون لرؤية الشمس، والمسكونون بهواجس مريضة حاقدة، والراغبون في تغييب القانون وفي مواجهة الشعب. إن الذين خرجوا للاحتفال بذكرى الانطلاقة، هم أكثر من نصف السكان في قطاع غزة. وإن ضممنا أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم اللاتي مكثن في البيوت لإعداد الطعام، نكون بصدد 80% من السكان، وهذا يعكس من خلال نسبة المشاركة، واحدة من أسطع مناسبات التأييد والمبايعة لأية قوة سياسية على مر التاريخ!
هذا التأييد الساطع، يعني أن الأمور ستكون إعجازية وطاغية التأثير في المحيط الإقليمي، وجديرة بأن نعجن ونخبز منها مفاجآت شتى، وبرامج مدهشة؛ لو أن فتح كانت في حال أفضل، وكانت أطرها أكثر فاعلية، وكان ضبط مسارها أكثر التزاماً بتقاليدها وإرثها الكفاحي، وكانت أكثر ديموقراطية، وكانت أعز شأناً على صعيد الحكم والحكومة والسلك الديبلوماسي والعمل الاجتماعي والعدالة، وكانت ذات رؤية متكاملة على كل صعيد أو كانت تهيأت بالأخيار من أبنائها لمواجهة الحصار بالمدخرات والاستثمارات والعمل الاقتصادي الرصين!
على الرغم من ذلك لم نتوقف في أصعب المراحل، عن التأكيد، على علاقة «فتح» بفطرة الفلسطينيين ووجدانهم وبأعماقهم وذكرياتهم. ولم نكن نكابر حين قلنا إن هذه الحركة الرائدة، هي شبيهة الناس وقيثارتهم!









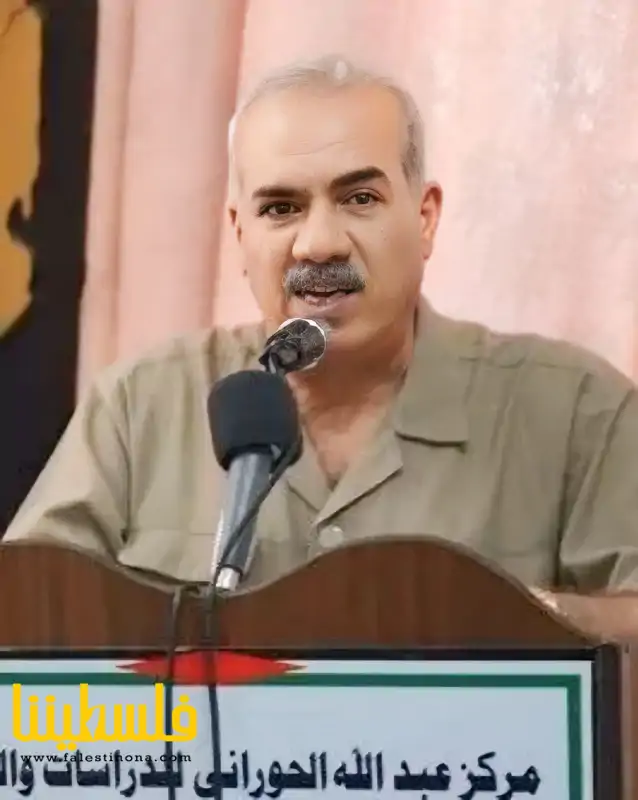







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها