في سنة 1963، أي قبل عامين من انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة؛ أصدرت القاصة وأديبة الرحلات الأيرلندية إيثيل مانين Ethel Mannin )1900 1984) روايتها "الطريق الى بئر السبع". فتلك رواية نعلم منها، أن ثورتنا التي قيل إن رصاصتها، قد سبقت الكلمة، وأنها بلا إرهاصات أو تنبؤات أدبية؛ كان لها عند إيثيل إرهاص ايرلندي، سطرته أديبة مرموقة وهي في العقد السابع من عمرها. ففي سطور الرواية، صوّرت إيثيل، بقلم يضاهي الكاميرا؛ عملية انتهاب فلسطين، وما تلاها وصولاً الى فعل المقاومة، وقدمت ملحمة إنسانية، رتبتها فصولاً تبدأ بخروج الفلسطينيين القسري من وطنهم. أدهشتني إيثيل بالعديد من المفارقات في روايتها. فقد اختارت مدينة اللد، موضع التصوير الأول ونقطة البداية. تجاوزت عن مدن فلسطينية أكبر وأكثر شهرة. وبدا واضحاً أنها تقصّدت أنموذجاً أصغر، يعيش فيه الفلسطيني المسلم والفلسطيني المسيحي في إخاء وطني، وقد استهدفهما الغزو الصهيوني الإمبريالي. واللافت أنها وهي تتتبع حركة أسرة فلسطينية مسيحية، بعد الخروج، كأنها قرأت قصة حياة د. جورج حبش قبل أن تُكتب، أو قبل أن يرويها "الحكيم" للصحفي فؤاد مطر بعدة سنوات. فمن اللد الى رام الله أولاً، ثم الى عمّان. هنا، وبمحض المصادفة، تخيلت الروائية مسار أسرة ما، وسردت ما حدث معها، وبالفعل كان هناك في الواقع، مسار مشابه أو متطابق. تقول "امتصت مخاوف المتاهات أرواحهم، وصرعتهم ضربات الشمس المتأججة، الى أن وصل من كُتبت له النجاة من هذه الجموع البائسة الى مدينة رام الله، وقَطَنَ معظمهم في العراء بعد أن بلغوا مأمنهم، وكان بطرس منصور أوفرهم حظاً، إذ وجد دار صهره الثري جاهزة لاستقباله، وكذلك داره في أريحا!
في سطور كهذه، نكون في العام 1963 بصدد روائية على دراية بتوزع الأسر الفلسطينية وعلائقها وأسباب امتلاك الميسورة منها دوراً عديدة في مدن مختلفة من وطنها.
طفل فلسطيني، هو أنطون ابن بطرس منصور، يشب عن الطوق ويحل في لندن. يتشرب ثقافة غربية. ومن خلاله تقدم الروائية شخصية الفلسطيني الذي لم تصرفه حياة الغرب المستقرة، وثقافته ولغته، عن تعلقه الفطري بالوطن. فالفلسطيني في الرواية لا يندثر، ولا تذوب قضيته في المهجر ولا تُنسى على مر السنين. في مثال الشاب أنطون، لا تنقطع المراسلات بينه وبين صديقه وليد حسين، من ريف الخليل، الذي يؤجج لديه الحنين للعودة الى الوطن، بينما أنطون يكابد، في مهجره، الدعاية الصهيونية. لقد حلّت لحظة الصيرورة، عندما احتدم النقاش بين انطون وديسموند الإنجليزي. قال لحظة إذ: "إن جيلي من الفلسطينيين سوف يشهد تحقق العودة، لأننا سنعمل من أجلها.إن فلسطين سوف تتحرر على يد الفلسطينيين"!
كان الإحساس السائد وقت صدور الرواية، وفي مرحلة المد القومي، أن الجيوش العربية، في "الجمهوريات" المناهضة للاستعمار، هي التي ستتكفل بالتحرير. لكن إيثيل مانين، قالت غير ذلك على لسان أنطون. وما قالته إيثيل، يُرهص لثورة لا تعلم الروائية عن أمرها شيئاً، ولم تكن انطلقت!
فرضية التسلل المسلح، وتكوين خلايا للمقاومة، رُسمت في الفصل الأخير من الرواية. كانت تلك فرضية قرينة بفرضية العودة. كانت في الرواية، ثمة ردود أفعال مترددة، شبيهة بردود أفعال قوى حزبية عربية، على انطلاقة "فتح" من بينها :"قوة اليهود لا تُغلب الآن. والعرب الفلسطينيون أضعف بما لا يُقاس. لذا عليهم انتظار الظرف المناسب".
تتشكل الخلية في ريف الخليل. يتراجع انطون ربما لأن أمه وصلت للتو من لندن الى عمان لحضور خطبته على ثريا. يتسلل وليد ورفيق له. يراجع انطون نفسه ثم يلتحق بهما. يشتبكون مع الاحتلال، ويكون أنطون هو الشهيد!
كانت ظلمة الواقع آنذاك، أحلك من الظلمة في هذه الأيام. فلم تكن لنا تجارب ولا أطر ولا نصاب ولا تمثيل لأنفسنا. لم يفكر الفلسطينيون حسب ما كتبت إيثيل في تسويات تنبثق عن لحظة رديئة من التاريخ. فالصراع ذو الطابع التاريخي، لا يطوى في لحظات رديئة!
رؤية ورواية: بقلم عدلي صادق
27-12-2014
مشاهدة: 725
عدلي صادق





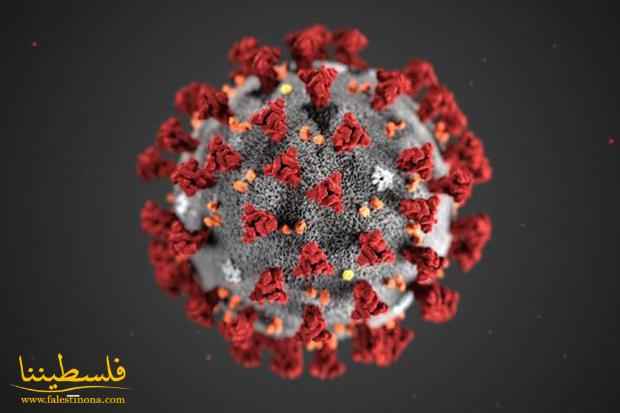








تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها