هذا حديث الى الذات الفتحاوية أكثر مما هو حديث الى الآخر، قد يكون فيه نوع من الحنين الى الماضي، وقد يكون فيه نوع من القفز عن المتغيرات التي شملت وعاء الزمن، ذلك أنه حين يتغير الزمن فان الوسائل يجب أن تتغير حتما، والأدوات يجب أن تتغير حتما، وزوايا النظر الى الأشياء يجب أن تتغير حتما، والا فاننا نصبح خارج الزمن، وخارج الصراع، وهذا ما لا ينطبق على فتح، ولا يتماهى مع فكرتها الملهمة الأولى، ولا مع نسيجها الاجتماعي الواسع الذي لم يرفض أحدا من الفلسطينيين على امتداد ثلاث وخمسين سنة منذ اعلان انشائها في عام 1958، ومنذ سبع وأربعين سنة من انطلاقتها الكبرى في مطلع عام 1965، لم ترفض فتح أي فلسطيني على خلفية الأيديولوجيا، بل استوعبت كل من دلف الى فنائها الواسع وحديقتها المتفتحة بكل ألوان الزهور، فاذا بالدالف الى الفناء يصبح عضوا في العائلة، واذا بالداخل الى الحديقة تتفتح وردته فيصبح جزءا عضويا من هذه الحديقة المتوحدة في تعددها، ومنسجمة في ألوانها التي تماهي كل ألوان الطيف.
فتح، تلك الواردة الطالعة للجرح، قالت للفلسطيني بصفته فلسطينيا: أنت على حق، لأنه بصفته فلسطينيا لا يستطيع أن يعيش ويستقر ويندمج بشكل طبيعي، دون استعادة منظومته الأصلية، أي أن يكون له كيان فلسطيني في أرض فلسطين، وأن يكون له هوية فلسطينية مزروعة في أرض هذا الكيان!.
وهذا هو جوهر بشارة فتح، ومبرر وجودها الأول، وبالتالي فان حركة فتح لم تتعامل مع الفلسطيني – أي فلسطيني – بأي قدر من الريبة، بل اعتبرت كل فلسطيني عضوا طبيعيا فيها، وبالتالي فهي لم تقفل بابا في وجه أي فلسطيني، لأنها هي في ذاتها، وفي نطفتها الأولى، وفي فكرتها الملهمة، وفي مآلها النهائي، بشارة فلسطينية.
ولذلك فان فتح لم تتعامل مع الفلسطينيين على طريقة الفرق الباطنية المنطوية على سر آخر لا يعرفه سوى الكهنة والسدنة ومن يمرون في اختبارات غامضة فينجحون في تلك الاختبارات، بل هي نفسها الدعوة والداعي في آن واحد، هي الوسيلة والهدف في حد ذاته، لا تطلب من الفلسطيني ما لا يطيق أو ما يتناقض مع كينونته، كل ما طلبته فتح ودعت اليه وفتحت له الطريق هو أن يكون الفلسطيني فلسطينيا في كل حياته، في جوهره ومظهره، في السر والعلن، في الصباح والمساء، في المسرات القليلة والأحزان الكثيرة.
يا أيها الفلسطيني، قالت فتح: كن فلسطينيا، ولكن عليك ألا تستسهل الأمر، فحين تتخذ قرارك النهائي بأن تكون أنت، وتكون كما يجب أن تكون، فسوف تكتشف بنوع خارق من الصدمة والوجع والانبهار، أن أصعب اختيار في حياتك هو أن تكون فلسطينيا!!! وآه وألف آه، ما أصعب أن يكون الانسان فلسطينيا، فحينئذ سيكون في عين الاعصار، وفي بؤرة التنشين، في صميم الأسئلة الناسفة، لماذا حدث ما حدث؟ لماذا وقع الخيار على الفلسطيني في ذروة الزمن المعاصر أن يكون الضحية بالمطلق، الضحية النموذجية، وأن ترتكب ضده الجريمة الكاملة والخطيئة الشاملة؟ وأن ينكر الفاعلون أياً تكن صفاتهم هويته، ويقول له أعداؤه مخاطبينه بقوة السلاح الظالم وعربدة المؤامرة: أنت لست أنت، ولا مكان لك هنا، لا مكان لك حتى في ذاتك وتحت عنوانك الذي خلقك الله له، اذهب من هنا، اشلح نفسك من نفسك! ابتسم وأظهر الرضى حين ينادون عليك بالأسماء الجديدة المزورة، اللاجئ، حامل وثيقة السفر، ساكن المناطق المدارى، العربي الاسرائيلي، الدرزي، المسيحي، المسلم، الغزاوي، الضفاوي، ولكن لا تكن أنت، اشلح نفسك من نفسك، ودعنا نرى بعد ذلك كيف سنحسن اليك، ونجعلك تعيش، هل تريد أكثر من مجرد أن تعيش؟
وبما أن فتح ولدت في زمن ديكتاتورية الأيديولوجيا، وديكتاتورية الجغرافيا، وديكتاتورية الأنظمة، فان وسائل الاقناع العادية لم تكن مجدية، كأن تكون حزبا اسبرطيا، منغلقاً على قواعده الحديدية، أو حزبا دينيا يدخل الناس منذ اللحظة الأولى في جدلية الايمان والكفر، الحلال والحرام، التي لم يستطع أن يهيمن عليها أحد في التاريخ، كما أن فتح كان متناقضا معها بالمطلق أن تكون ذراعا لأحد، بل اعتمدت في بشارتها، وفي أبوابها المفتوحة للفلسطيني في الوطن والمنفى، على النموذج المبهر، النموذج الانساني الساطع الجميل الذي يدعو الفلسطينيين الى أنفسهم بأجمل الأدوار وأكثرها شجاعة وابداعا، فكانت رصاصة الكفاح المسلح الأولى، صحيح أنه لا غابات ولا جبال ولا أنهار ولا مفازات واسعة، بل الأرض محدودة جدا واقعة كلها في مرمى النيران، والأرض المحيطة كلها مزروعة بالأنظمة وأجهزة الأمن والاعتبارات المعقدة، وكان لا بد من تقديم نموذج مذهل ومبدع وجميل يأوي اليه الناس، ويلحقون به كالضوء، دون أن يكون هؤلاء الناس دروعا بشرية، بل تكون فتح نفسها هي الدرع البشري لهم، نموذج مبهر يتعاطى مع واقع الدنيا بحقائقها الكبرى، فكانت الرصاصة الأولى، وكانت الحجارة الأولى، وكانت الهوية الأولى، هكذا قالت فتح: يجب أن لا يقرأ أحد قوائم الحضور في كل ما يتصل بقضيتنا من قريب أو بعيد، دون أن يكون اسم فلسطين بين الحضور، وأول الحضور، وأكثر الحضور اشعاعا واستحقاقا، وصاغت حركة فتح على المستوى السياسي والمستوى التنظيمي فقها خاصا بها، لكي تدير علاقتها مع نفسها، وتدير علاقتها مع غيرها، ومن الطبيعي أن تلك الصياغات تعرضت لصعوبات وتهتكات واختراقات وانشقاقات مؤلمة أحيانا، وهذا أمر طبيعي، لأن أعداء فتح ما زالوا هم الأقوى في العالم، ولأن تأثيرات النسق المحيط بنا بالمنطقة جعلت المياه مضطربة دائما أمام سفينة الخلاص الفلسطينية، لأن هدف حركة فتح كبير، انه انقلاب هائل في المنطقة، انه القيامة، فهل يوجد ما هو أكبر من الموت نفسه سوى القيامة من الموت؟
وهذا هو بالضبط هدف حركة فتح الذي تعلنه مرة بصخب، ومرة بهدوء وتواضع، ولكن الأقطاب الذين يسيرون هذا العالم لا يمكن التمويه عليهم بالكلمات البسيطة الناعمة، فهم يعرفون أن قيامة الكيانية الفلسطينية، وحضورها، سوف يكون أعظم شيء خارق في تاريخ حياة هذه المنطقة منذ عقود طويلة.
هذا الهدف العظيم والمقدس والصعب تحمله فتح على كاهلها، تحميه من كل الذين يناوشونها بالجراح لكي يستولون عليه ثم يبيعونه بعد ذلك بالأسواق!!! وفتح يجب أن تظل قادرة على حمل هذا الهدف، وحمايته، والمرور به سليما عبر الحواجز المعادية، وأن تنخر به عباب الأمواج المضطربة، وأن تجتاز به حقول الشوك ورمال الصحراء التائهة.
يجب أن تنجح فتح بذلك، ولهذا فهي ضرورة وطنية، ووقفتها مع ذاتها بكل لحظة لتستطلع الطريق ضرورة حاسمة، واستعادة فقه الصبر والمحبة حين تتأزم العلاقات الداخلية أمر ضروري، فانه حتى الخاطئون هم أبناء الرب، وحتى الأبناء الضالين هم أبناء العائلة، وأن فتح في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل معاناة جديدة، تؤمن أكثر، ويضيء فيها اليقين بأنها ضرورة وطنية.















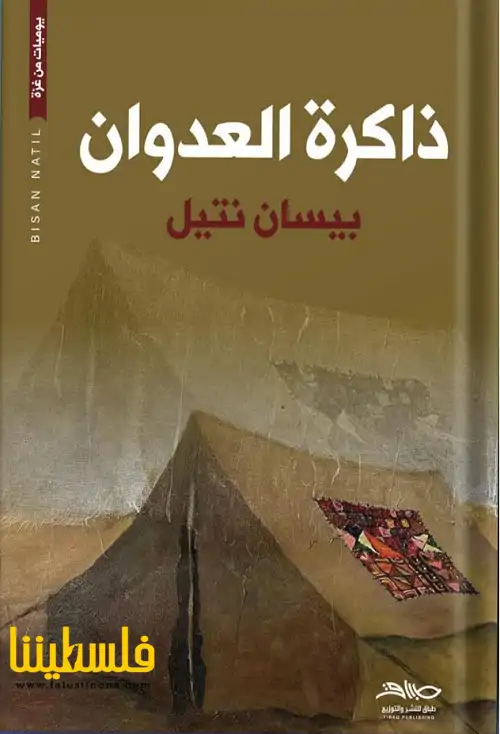
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها