بقلم/ محمد سرور
تزداد في أيامنا هذه صلافة الخطاب المذهبي والطائفي، بحيث بلغت حداً من الجرأة والوضوح الداعي إلى تصنيف الهويات وفق انتماءاتها الدينية وعصبياتها الأثنية، انطلاقا من المبالغات السياسية التي تشكل أساس الخطاب ومبتغاه.
الطوائف والمذاهب باتت معسكرات تغرف منها قوى "الأمر الواقع" ما شاءت من متعلمين وأخصائيين وجيوش مدربة ورداحين وشتامين. فيما الأوطان أصبحت مجرد محميات لأولئك المتخاصمين، وممالك تصول فيها الأجيال التائهة بحثاً عن غد تسطع شمسه أو يبزغ فيه الرغيف... كالقمر.
وحسب الطريقة التي تتمنهج هذه الأيام، فإن الأديان والمذاهب تنزاح باتجاه أن تصبح أطراً للسياسات وثقافات النبذ والتعصب. فنقاط التقائها باتت تتباعد، تنشرخ وتضمحل، لدرجة أن الولاءات السياسية وحدها هي التي تختصر التواصل بين المذاهب والأديان، وبشكل فردي أو فئوي- بالمعنى الحزبي للكلمة. وبدقة أكثر بتنا نصنف هذا الدين أو ذاك المذهب بهذا الإتجاه السياسي أو ذاك، متجاهلين الأكثرية الصامتة هنا وهناك.
ولكي تضيق دائرة الإستقطاب السياسي بين الأديان والمذاهب، أصبح المعارضون لسياسات الطوائف والمذاهب مدانين بتهمة "العلمانية والشيوعية وما يعادلهما من صفات ثقافية عالمية تعني التكفير والخروج على الإجماع المعني والمحدد".
فاستثمار الدين في السياسة هو الآن الأكثر رواجاً وازدهاراً، بحيث أصبح الدين أمام خطر فقدان هالته الروحية، ورجال الدين أمام خسارة ما اعتبروه "توكيلا مفتوحاً" من العامة لحسابهم.
والغريب أيضاً أنه أصبح لكل فئة سياسة – حتى لو كانت تنتسب للمذهب نفسه – مجتهدوها ومفتوها ورجالات تحرسها من الفئة أو الفئات الأخرى. مما يعني أن حالة من التفكك والتصادم المبني على البعد السياسي قد تحصل بين هذا الطرف أو ذاك، ناهيك عن تهم الإنحراف والتكفير التي تؤججها كل فئة للأخرى.
قد يرى البعض أن اختلاف المدارس والإجتهادات الدينية مسألة عريقة ودليل صحة، كونها خلاصات نتائج بحث عميق، فيما الواقع الحقيقي يذهب عكس ذلك تماماً، كون الكثير من هذه الفئات باتت تملك جيشها وخصوصيتها الحزبية والعصبية المنفصلة عن الأخرى. وكونها أيضاً تشحن الموالين لها بطاقة قاتلة من التشدد والتحزب والترغيب والترهيب، المبني على احتمالات التصادم وإزهاق الأرواح.
إن انطلاق غالبية هذه القوى من فكرة أن "الإسلام دين ودولة" وتغلغل الفكرة إلى صميم المكون الروحي – العقائدي لها أضرَّت كثيراً بالمضمون التعددي والحضاري لهذه الجماعات أولا ثم للدول، خاصة تلك التي تحاول النهوض والتطور وفق المقتضيات الثقافية والمستقبلية، بل تكاد تخنق الوعي الجماعي الساعي إلى تغيير الواقع والتقاط الفرص التاريخية السانحة والضرورية. فالأزمات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية والإسلامية تحتاج إلى خطط وسياسات متقدمة حداثوية تستطيع السير بمنهج التطوير المؤسساتي المستند إلى الخبرات والإمكانات التي بحوزتها.
تجربة الإخوان المسلمين في مصر ليست تفصيلية أو عابرة، إنما أصابت المشروع الإسلاموي في الصميم، كونها تجربة افتقرت إلى الرؤية وقادت البلد بروح الإستئثار والتفرد الأعمى، إذ كان يلزمها الثقة بالآخر والإنفتاح عليه من خلال مشاركته المسؤولية ومقاسمته الغنم والغرم معاً. فالذي أطلق رصاصة الرحمة على المشروع من أساسه هو الأنانية الحزبية الناطقة بلسان حزب إنطوائي- منفصل وجدانياً وحسياً عن الشعب المصري. أمام أمواج الثائرين من أبناء مصر، أين أصبح شعار "الإسلام هو البديل"؟ هل بات من المستحيل إعادة ترميم المشروع الإسلامي الناطق بلسان "قوى مصر الإسلامية"؟.
لم تدرك حركة الإخوان في مصر أن حالة الشعب لم تكن تحتمل أي خطأ في الأولويات، فأخونة الدولة وتطويق طاقاتها ومؤسساتها الفاعلة والقوية، هي التي كسرت ظهر السلطة الجديدة الحالمة بالحكم منذ العام 1928، فيما كان الشعب بحاجة إلى خطط فورية وإجراءات تخفف عنه أعباءه التي تعجز عن حملها الجبال.
لا أعتقد أن الثغرة في الدين- أو أعجز عن الحكم بذلك لحراجته، حين تفترق وتتكاثف أحلام المتأمِّرين والباحثين عن سلطان لهم وسلطة على قدر تطلعاتهم، خاصة عندما يكرِّسون لتلك الأحلام والتطلعات ما شاء لهم من إمكانات اجتهادية ومادية، وما ملكت أيديهم من دعاية وتحريض، وبأية وسيلة ومهما كلف الأمر.
من أعاق التيارات السلفية والمتشددة عن الظهور المبكر: الحاكم الظالم أم النظرة المسطحة للأزمات التي تواجهها مجتمعاتنا، أم خضوع الأزمات للتعريف الديني والمذهبي الذي طغى على واجهة ثقافة الواقع الحالي؟
هل نحن أمام يقظة دينية، تؤشر إلى حالة من القلق الجماعي المفضي إلى حالة انعدام اليقين، والتي تفترض استحضار حالة بديلة يحملها يقين جماعي- ولو كانت غيبية- عن طريق تدوير وإعادة تصنيع التجربة الأولى للإسلام كمعنى للخلاص من واقع اللحظة؟
هل يمكن الإجابة على السؤالين السالفين دون الإجابة الإشارة إلى واقع مجتمعاتنا وتشعب أزماتها، وقراءة التعدد الثقافي، بكل مضامين علاقاته وأنماط إنتاجها؟
بالطبع يسهم القلق العميق وانعدام وجود المشاريع المقنعة التي تحاكي ضمير الناس، إلى الحد الذي تجد نفسها فيه، بتعويم الخطاب الغيبي، وبإحالة قضاياها نحو البعد الذي يجسِّد المآل الروحي للكثيرين.
التماهي العميق لدى العديد من القوى الإسلامية بين الفكرة والوجدان السياسي ، وصولا إلى الربط بين هذين المكونين ونمط الحياة الخاص بهذه القوة أو تلك، يمثل أقصى حالات الخطورة، كونه يبتعد في الربط بين تحقيق الأهداف التي تحملها وتجاهد في سبيلها وبين بقائها أو موتها، ومعها بقاء أو تخريب البلد الذي يفترض قيامة مشروعهم فوق أرضه.
فالذي حصل مع جماعة الإخوان، الذين ينطبق عليهم القول أعلاه، انطلقوا من مسلمة تقضي بإما إعادة الرئيس السابق محمد مرسي ومعه الشرعية الدستورية، التي تلطوا وراءها، وإما الموت.
فالأمر الخطير الذي حدث هناك، هو تخدير الجمهور المؤيد لعودة "الشرعية الإخوانية" وإسقاط أفكار الإخوان على هؤلاء وجعلهم يتطوعون لكي يصبحوا دروعا بشرية، إضافة إلى النساء والأطفال، نظراً لحاجة جماعة الإخوان إلى مظلومية تاريخية تقوم على الدم والأضاحي الكثيرة، تصبح منطلق الجماعة الثقافي والسلوكي، وبالتالي تستقطب الأتباع والمتعاطفين الذين – وحسب نظرية القيادة الإخوانية تبرر لهم جنوحهم إلى التطرف والعودة إلى الحكم بأي ثمن. فنظرية المؤامرة والظلم الذي وقع عليهم يرون فيه واحداً من الأسلحة الأهم التي يجري تعميمها على الأتباع والجماهير الحائرة، لكي تجند في معركتهم الجارية ضد الجيش وقوى الأمن، تمهيداً للتوسع بها في حال بدت لهم بوادر إنجاز ما على هذا الصعيد.
فطوال الفترة الممتدة بين الإطاحة بالرئيس مرسي وفضِّ اعتصام الإخوان في رابعة العدوية وميدان النهضة دأب القادة الإخوانيون على شحن الجموع المعتصمة بالوعود التي تؤكد عودة رئيسهم من خلال الحق المشروع لهم بذلك، والعهود التي تؤكد أيضاً أن لا فضَّ لاعتصامهم إلا حين يتكلل بالعودة الميمونة إلى الحكم.
الغريب في الأمر أن لغة التهديد والوعيد للحكم الجديد وللجماهير التي ثارت ضد نظام الحكم الإخواني في الميدانين أباحت لغة الحديث عن الدم والشهادة، وربطت بين حق الإخوان في استعادة الشرعية وبين وقف العنف والإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وبشكل لا يدع مجالا للشك بتقاطع الخطوط – المصالح بين جماعة الإخوان والجماعات الجهادية. تلك المسألة وضعت الإسلام السياسي بكل تياراته وأطيافه أمام واقع العزل السياسي والإنعزال الثقافي- الأيديولوجي من جديد. ومن مفارقات القدر، بدت تهديدات قادة الإخوان خاوية وفاضحة في آن، فبدل من أن يقدموا نموذجاً ساطعاً في الإستعداد لدفع الأثمان – الشهادة مثلاً كما وعدوا – لم يصب أي منهم بأذى، بل اعتقل العديد منهم إما في مخبئه بإحدى الشقق الفخمة –بديع ومن قبله الشاطر، وإما خلال محاولته اجتياز الحدود إلى بلد آخر – صفوت جحازي.
إضافة إلى ما سبق، استطاعت سلطات الأمن المصرية إصابة جسد الإخوان المسلمين بمقتل، من خلال هدم الجسور التي تربط بين توجهات القيادة وقاعدتها التي تلتزم تنفيذ سياساتها، بتوقيف العدد الاكبر من الكادرات الوسطية النشطة، مما أفقد الشارع الإخواني القدرة على الحشد والإنتظام والتواصل، وبذلك بدا جلياً تفكك القاعدة الشعبية الإخوانية إلى شلل ومجموعات فاقدة الفاعلية والقدرة على التحرك وإرباك السلطات الأمنية والسياسية.
بالطبع حاولت الجماعة استغلال الإنحياز الأميركي- الأوروبي والتركي والقطري لصالحها، فأضافت إلى خسائرها الجسدية – المظلومية- محاولة تعميم الفوضى باستهداف الكنائس وتوزيع الرعب في أنحاء مختلفة من الداخل المصري، لكنها بدت في النهاية أقرب إلى اليأس من أن تستطيع إنجاز شيء ما يعيدها إلى دائرة الضوء والقرار من جديد.
المواقف الأميركية – الأوروبية وقفت بين المطالبة بالمصالحة الوطنية في مصر وبين حق الخوان في الحكم، وبطريقة لا تلامس التوازن الذي فرضه الشارع المصري في الثلاثين من يوليو وما تلاه، كأن مراكز القرار الأميركي – الأوروبي تحاول غسل ماضيها العدواني – في العراق وليبيا على حساب الساحة المصرية. وبمعنى أدق، مارست هذه الدول ولم تزل نوعاً من الغزل المبطن – إنتهازية ولا أخلاقية - مع الجماعات الإسلامية لكي تضمن تحييد نقمتها وعدائها لها، حتى لو دفعت مصر فاتورة كبيرة جراء ردة فعل الجماعات الإسلامية على خسارتها الحاضنة التي اعتبرتها إستراتيجية في عهد الإخوان.
فالديمقراطية من وجهة النظر الأميركية – الأوروبية هي فقط صناديق، فيما من حق الناخب الأميركي سحب الثقة التي سبق ومنحها لأي قائد أو نائب في البرلمان من خلال إعلان ذلك، ودون الحاجة إلى الدورة العادية للإنتخابات.
هذه المواقف غير المنسجمة مع عجلة الواقع المصري- وللأسف- تشجع فلول الإخوانيين على التماهي معها وبالتالي ربطها بمعادلة: استقرار مصر لا يمكن أن يتم دون عودة الإخوان المسلمين إلى السلطة.
الجماعات الإسلامية المتواجدة على الساحة المصرية ليست على وفاق، إذ هي تختلف فيما بينها اختلافاً جوهرياً عميقاً على العديد من النقاط المفصلية الروحية- الايديولوجية والسياسية، ومع ذلك وجدت هذه الجماعات حركة الإخوان في مصر مظلة هامة تحميها الملاحقة والمطاردة، فيما الإخوان وجدوها إحدى الأوراق التي يستطيعون من خلالها تمرير الرسائل المتعددة، لجهة قدرتهم على احتوائها وتنظيم مخاطر أعمالها، وبالتالي الإثبات بقدرتهم على فرض حالة من الإستقرار المشروط بضمان بقائهم في السلطة.
أين حماس مما يجري في مصر وخاصة في سيناء؟
المستغرب أمام ما يجري في مصر، الصمت المطبق لزعيم حركة حماس خالد مشعل، وترك المجال مفتوحاً لتصريحات الناطقين باسم الحركة وسلطتها في غزة، حيث لم ينجح هؤلاء في رد التهمة الملقاة على الحركة لجهة اشتراكها في الأعمال العدوانية ضد الجيش المصري، بل زادوا من درجة الشبهة الملقاة على حركتهم، والخطيئة الثانية التي ارتكبتها بحق القيادة المصرية الجديدة والشعب الفلسطيني معاً هي نفيها من خلال الناطقين باسمها في القطاع الإتهامات الموجهة إليها باعتبار ان استهداف حماس ووضعها في خانة الإدانة له دلالة "التنكر للقضية الفلسطينية ومعاداة لشعبها".
قدر الشعب الفلسطيني، التزام أقصى حدود اللياقة وحسن الضيافة والجيرة، وبذات المستوى الربط الأخلاقي- المصيري بين مصالح الجيران والمضيفين لشعب فلسطين وقضيته. فلا يجوز الاخلال بهذه المعادلة وتمرير السياسات الفئوية الخاصة على حساب الشعوب المضيفة وسلطاتها القائمة. كما لا يجوز المراهنة هنا وهناك على مسارات وتغيرات قد تأتي بواقع آخر، ليس حباً بالراهن ولا التزاماً بخياراته السياسية، بل تأكيداً على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى بمأمن عن التجاذبات العميقة بين القوى المتصارعة، وعلى أن لا نحشر قضيتنا في دوامة المعادلات المتحركة منعاً لإتاحة الفرصة أمام نوايا المتلاعبين بمصيرها. الموقف المستقل والحريص على القضية هو الذي يحصنها ويقويها في كل الظروف.
الإتهام الموجه للحركة يجب أن يقابل بسلوك مغاير، يدحض التهمة ويؤكد عكسها، فلا ينبغي تعويم الخطاب وتضمينه إفراطاً في الهروب إلى الأمام. ف "حسبنا الله ونعم الوكيل" ليست دلالة على البراءة، ولا هي رد على اتهامات مباشرة ومحددة تشير إلى مسؤولية الجناح العسكري لحماس عن جزء مما يصيب الأمن الوطني في مصر.
لذلك على حركة حماس التمييز بين مشروعها الحزبي الضيق والفاشل وبين مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته. والتمييز أيضأً بين علاقتها بقوى متطرفة، لم يكن وجودها يوماً خادماً أو مساعداً في النضال الوطني الفلسطيني ضد الإحتلال، إنما تعايشت هذه القوى ولم تزل معه وبين أكنافه، بحيث لم يستشعر بوجودها أي خطر أو خوف على الأمن الصهيوني.















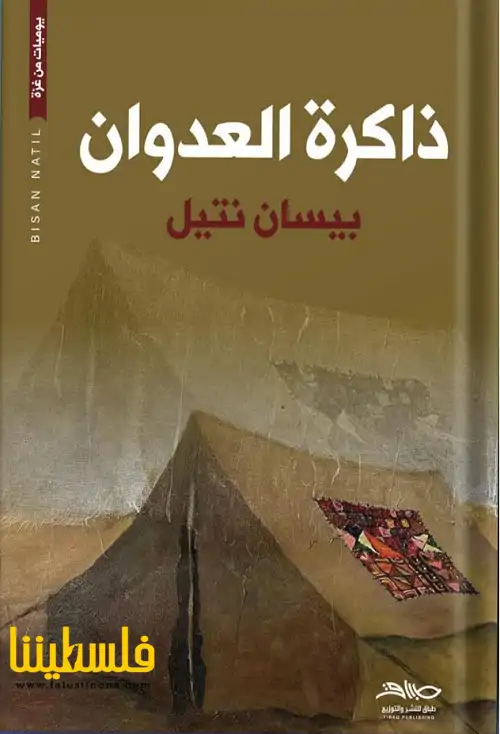
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها