خاص- مجلة القدس- العدد 334 شباط 2017
بقلم/ صقر ابو فخر
يتخوف الفلسطينيون من أن انتقال الرئاسة الأميركية من باراك أوباما إلى دونالد ترامب سيؤثر، بكثير من السلبية، في مكانة القضية الفلسطينية في النطاق الدولي. وهذا التخوف بدهي، وصحيح إلى حد كبير، بعد التصريحات المتعددة التي أطلقها ترامب في سياق حملته الانتخابية، والتي شددت على نقل السفارة الأميركية في اسرائيل من تل أبيب إلى القدس. لكن، ما لا يجب ان يغرب عن البال أن باراك اوباما لم يكن، على الإطلاق، صديقاً للفلسطينيين. فلنتذكر أن أوباما عطّل قراراً في مجلس الأمن في شباط 2011 يدين الاستيطان، ورفض انضمام فلسطين إلى اليونيسكو كعضو كامل العضوية، وأقر قطع المعونات المالية عن هذه المنظمة الثقافية الأممية عقاباً لمجلسها لقبوله فلسطين عضواً فيه. لنتذكر أيضاً أن أوباما هو الذي وافق على رفع مقدار المعونة العسكرية لاسرائيل إلى 38 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، أو 318 مليارات دولار في السنة بعدما كانت 3.4 مليارات دولار.
غياب الغرام بين أوباما ونتنياهو لم يكن يعني، في أي يوم من الأيام، انحيازاً أميركياً لمنظمة التحرير الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية، بل كان مشكلة سياسية لم تؤثر في مكانة اسرائيل لدى الادارة الأميركية التي ما برحت ترى في اسرائيل ثروة استراتيجية لأميركا لاعبئاً عليها. أما المشكلة فتجسدت بالنقاط التالية:
• أفشل نتنياهو وعود أوباما في شأن حل القضية، التي أطلقتها في بدايات عهده في القاهرة واسطنبول.
• أفشل بعناده جهد وزير الخارجية جون كيري الذي كرس وقته في إحدى المراحل للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل، وللتوصل إلى نتيجة ما في شأن حل الدولتين.
• عمل بقوة وشراسة على إفشال الاتفاق النووي مع ايران، وهو مصلحة عليا لأميركا وأوروبا.
• الدعم المكشوف للمرشح الرئاسي ميت رومني الذي خاض المعركة الانتخابية في سنة 2012 ضد أوباما.
الوعود الخُلبية
لا معلومات واضحة عن وجود علاقات خاصة للرئيس ترامب بإسرائيل، بل مجرد مناسبات تلقى فيها شهادات تقدير من مؤسسات يهودية مثل "جائزة شجرة الحياة" (1983) من صندوق مالي يهودي، وهي جائزة تُمنح في سياق العلاقات العامة. وشارك ترامب في سنة 2004 في احتفالات "يوم اسرائيل"، ودعا إلى دعم ترشيح نتنياهو في انتخابات 2013. وهذه المناسبات لا تشير إلى وجود رؤية سياسية إلى قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما أنه رجل أعمال في الأساس، ولم يمتلك أي خبرة سياسية كأن يكون حاكم ولاية مثلاً، أو وزيراً سابقاً أو غير ذلك . وجل ما نُقل على لسانه هو مواقف عامة تقتضيها المناسبة التي صدرت مواقفه في خلالها. ففي أحد التصريحات قال: "السلام بين اسرائيل والفلسطينيين يتحقق بالتفاوض المباشر بين الطرفين". وهذا كلام عام يطابق مواقف نتنياهو الذي يرغب في إبعاد اللجنة الرباعية عن أي تفاوض. لكن ترامب لم يتورع عن القول في إحدى المناظرات في شباط 2015 إنه يريد أن يكون محايداً في مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وكلمة "محايد" تعني الكثير من السلبية لدى اسرائيل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه قال في كانون الثاني 2015، غامزاً من اسرائيل، إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يعتمد على السؤال عما إذا كانت اسرائيل تريد التوصل حقاً إلى صفقة أم لا؟ وهل إن اسرائيل مستعدة للتضحية ببعض الامور أم لا؟
غير أن ترامب دان في كانون الثاني 2016، أي في ذروة حملته الانتخابية، قرار أوباما الذي قضى بالامتناع عن نقض قرار مجلس الأمن رقم 2334، أي استخدام الفيتو. وفي ما بعد، وللبرهان عن تقربه من اسرائيل، عين صهره جاريد كوشنر، وهو يهودي، مشرفاً على مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، واختار دايفيد فريدمان، وهو يهودي أيضاً، ليكون سفيراً لأميركا في اسرائيل، وهو مشهور بتأييده الاستيطان في الضفة الغربية والقدس. وتعهد في خطبة له أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية – الاسرائيلية (إبياك): أي اللوبي اليهودي في أميركا في آذار 2016 بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. لكن ترامب نفسه عاد، بعد وصوله إلى البيت الأبيض، ليعتدل في مواقفه. ففي حديث إلى صحيفة "يسرائيل هايوم" (اسرائيل اليوم) في 10/2/2017 قال إن توسيع نطاق الاستيطان لا يخدم السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس ليس قراراً سهلاً. وهذا التصريح جعل نتنياهو يخفض توقعاته من النتائح التي تطلع اليها في زيارته الى أميركا في 15/2/2017.
ثمة مخارج لدى إدارة ترامب في شأن قضية نقل السفارة الأميركية إلى القدس، كأن تبقى السفارة في تل أبيب، لكن السفير يمارس مهماته من مكتب خاص في القنصلية الأميركية في القدس، أو من مكتب في فندق أو مبنى خارج القنصلية. ومن المتوقع أن تتسامح إدارة ترامب مع التوسع الاستيطاني بحيث لن تجد حركة السلام الآن على سبيل المثال آذاناً صاغية في الادارة الاميركية، وسيتبدد كثير من وعوده على غرار وعود أوباما، ومع ذلك لم تؤثر وعود أوباما الخُلبية في إعاقة عودته مرة ثانية إلى البيت الابيض وهكذا لن تؤثر وعود ترامب في إمكان إعادة انتخابه مجدداً للرئاسة، وهو أمر يؤخذ في الحسبان دائماً.
السلام ليس أولوية
لم تظهر، حتى الآن، ملامح صريحة للسياسة الخارجية الأميركية في المشرق العربي، ولم تُصغ رؤية سياسية متماسكة نحو قضية السلام في فلسطين. غير أن في الامكان القول، استناداً إلى الاتجاهات السياسية لكبار أركان الادارة الجديدة، إن السلام في فلسطين لن يكون من أولويات ترامب في الولاية الأولى، لأن أولوياته ستنحصر في المحيط الهادئ والتنافس مع الصين، والتصدي لاتساع الهيمنة الايرانية في محيطها الجغرافي، ومواجهة الارهاب، وقضايا الهجرة والمهاجرين، والتفاهم مع روسيا على مكافحة الارهاب ولجم ايران عن مشروعاتها النووية. وبهذا المعنى فإن سياسة ترامب ستكون في المرحلة الأولى مزيجاً من سياسة جورج بوش وأوباما معاً. وفي أي حال فالرئيس الأميركي لا يتخذ القرارات المهمة وحده، بل يعلنها، لأن القرارات الاستراتيجية تخضع لمجموعة من الاجراءات تسهم فيها المؤسسات الأساسية مثل الأمن القومي ووزارة الخارجية والجيش والمخابرات ووزارة المالية ومراكز التفكير والمشورة Think tanks، فضلاً عن المصالح الكبرى كالصناعات الثقيلة (التعدين والسلاح) والمصارف والنفط الصناعات الغذائية والدوائية والتكنولوجيا العالية. وفي سياق المشورة والتفكير صدر في سنة 2017 تقرير بعنوان "استراتيجية جديدة للشرق الأوسط" وضعته مادلين اولبرايت وزير الخارجية الأميركية السابقة، وستيفين هادلي المستشار السابق للأمن القومي. وهذا التقرير هو محصلة نقاشات مستفيضة وأوراق عمل قدمها مستشارون وباحثون وخبراء وسفراء ورجال استخبارات في الشرق الأوسط. وهذا التقرير يتناول المخاطر المحدقة بالعالم كالإرهاب وايران، ويدعو إلى التدخل المباشر في الشرق الأوسط لوضع حد لطموحات ايران في الهيمنة على الدول المجاورة لها. وهذا التدخل في حال أخذت به إدارة ترامب سيعني حروباً جديدة. والعودة إلى سياسة جورج بوش والمحافظين الجدد. ويرفض التقرير سياسة العزلة التي انتهجتها الادارة الأميركية في عهد أوباما، ويحذر ترامب من مخاطرها. والمعروف أن ترامب يؤيد جوانب من سياسة العزلة للتركيز على المشكلات الداخلية خصوصاً الاقتصاد والمهاجرين، وللانصراف إلى معالجة المنافسة الصينية الخطرة جداً في بلدان المحيط الهادئ.
الاستقطاب والاستتباع
تخضع قضية فلسطين اليوم لعاملين متنافرين ومتجاذبين في الوقت نفسه هما الاستقطاب الاستتباع. ويأتي ذلك في سياق تدويل قضية فلسطين كما ظهر في مؤتمر باريس، وفي اجتماعات موسكو للفصائل الفلسطينية التي دعا إليها معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم في روسيا، وهو أحد معاهد المشورة والتفكير، وكما سيتجلى في المؤتمر الشعبي الفلسطيني في اسطمبول، وفي مؤتمر دعم انتفاضة الفلسطينيين في طهران. وهكذا بات التدويل الذي تجري في سياقه عملية الاستتباع لتركيا، وعملية الاستقطاب في طهران، خطراً داهماً يسلب الفلسطينيين، وحتى العرب، استقلاليتهم. ولقد باتت اسطمبول مقراً لصوغ السياسات الفلسطينية التي تنحو إلى تأليف بدائل من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو شأن خطير جداً. ولعل من مخاطر الاستتباع والاستقطاب، علاوة على تدمير منظمة التحرير ومؤسساتها، هو أن مواقف ترامب المتطرفة من ايران قد تدفع الاخيرة الى تنشيط علائقها ببعض الجماعات المتطرفة، خصوصاً في غزة، ودفعها إلى تنفيذ عمليات غير محسوبة النتائج ضد اسرائيل. وهذه العمليات ربما تخدم ايران في صراعها مع أميركا ومع بعض دول الجوار الإقليمي، لكنها ستكون وبالاً على قضية فلسطين التي تتقاذفها اليوم الرياح الهوج الآتية من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب.










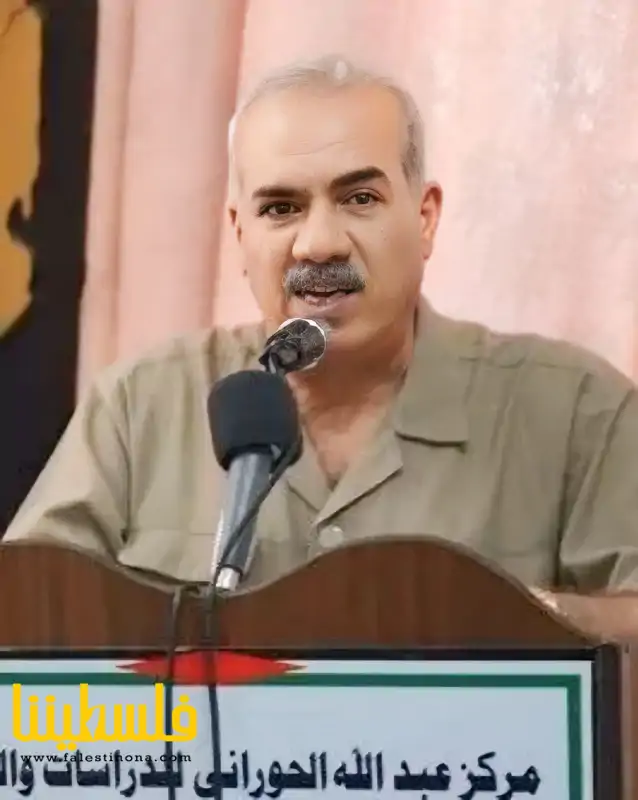



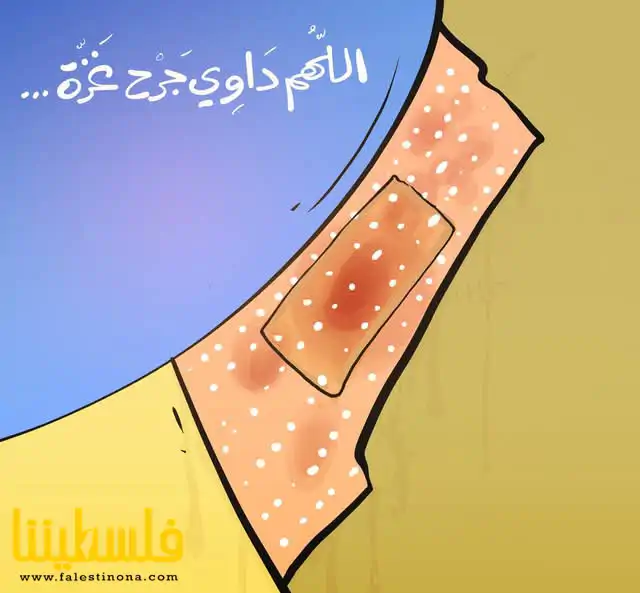



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها