بقلم: هيفاء داوود الأطرش
خاص - مجلة القدس العدد السنوي 333
مثل كل القضايا، التي تبدأ ساخنة، وصوتها هدير، ووقعها مجلجل، فتفتر فجأة، لتنطوي في ثنايا النسيان، حتى إن الذاكرة يتم إحراجها لمجرد مرور أطياف الخبر أمامها.
هكذا بدأت قضية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بعد الأزمة التي عصفت بالدولة السورية منذ خمس سنوات إثر اندلاع إعصار ما سمي بالربيع العربي، والذي انطلق في لحظةٍ تناسب الاستعمار الجديد، وبالتأكيد لأنها مدروسةٌ وبإحكام.
هذا الربيع الذي يستهدف تدمير سيادة وكيانات الدول العربية البارزة في الوطن العربي بغض النظر عن سياساتها الداخلية التي أثقلت كاهل شعوبها من ظلم وفساد يتفاوت من دولة إلى اخرى؛ وعندما نقول تدمير الكيانات، لا يقتصر ذلك على مؤسسات الدول وأنظمتها إنما مقدرات الشعوب العربية وتركيبتها، حيث أن تلك الدول كادت أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي بدءاً من العراق – قبل الربيع العربي – وانتهاءً بسوريا التي كادت أن تنتهي قبيل الحرب، من وضع آخر حجرٍ في الحضارة العربية السورية وتوطيد دولة بكل المقاييس العالمية.
وبالعودة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا جزءاً من النسيج العربي السوري دون ذوبان هويتهم الفلسطينية، والذين بلغ تعدادهم أكثر من خمسماية الف لاجئ في سوريا، فإن الجدير ذكره، أن الاستقرار الذي وصل إليه أولئك اللاجئون، والذين تساوت حقوقهم في الدولة السورية مع مواطنيها الأصليين، وبعد نكبة فلسطين عام 1948، قد وفر لهم أن يشكلوا مشهداً وطنياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً متميزاً على امتداد الجغرافيا السورية وضمن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وخارجها، مشهداً كان له الأثر الكبير داخل سوريا وخارجها، وفي المحافل العربية والإقليمية والدولية.
وبعدما لمسنا نتيجة وتداعيات الحرب على سوريا من الناحية الفلسطينية، عبر هذه السنوات، فإن القول بأن اللاجئين الفلسطينيين كانوا ضمن مساحة الاستهداف المعادي لسوريا، قد أخذ منحاه بشكلٍ فعلي بسبب تأثر التجمعات الفلسطينية بشكلٍ مباشر، رغم التأكيدات الرسمية السورية النظامية بتحييدها عن أتون الحرب الدائرة، لكن براثن التخريب المسنونة ضد سوريا كانت أكثر حدة ضد الكينونة الفلسطينية المتميزة، حيث مزقتها إرباً وبوحشية الحاقد، حتى آل المصير بهم إلى تشردٍ جديد أخذ شكلا ً أكثر صعوبة من تشرد الأجداد عن فلسطين عام النكبة، حيث حقق هدفاً أساسياً هو ضرب التجمعات الحافظة لشكل قضية اللاجئين في الشتات، وتفريق العائلات بشكلٍ لم يحصل له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية، فقد استهدف نواة العائلة الفلسطينية الصغيرة التي توزع أفرادها على أكثر من دولةٍ في العالم، وحتى داخل سوريا بين من هو موجودٌ قسرياً ضمن حدود المخيمات المتضررة، والمهجر قسرياً خارج حدودها وضمن الأراضي السورية.
وبينما تم تواجد 85000 لاجئ فلسطيني من سوريا في لبنان، إثر الحرب السورية وبعد هجرة قسرية تعرضوا لها، ثم تقلص عددهم إلى 31000 حالياً في نهاية عام 2016، بسبب الهجرة إلى دول أوروبا التي تواجد فيها أكثر من 79000 لاجئ فلسطيني حتى منتصف 2016، وبينما تم تواجد 15500 لاجئ فلسطيني في الأردن، حسب إحصائيات الأونروا حتى تموز 2015 و 6000 لاجئ فلسطيني إلى مصر، و1000 لاجئ فلسطيني إلى غزة، بالإضافة إلى 280000 لاجئ فلسطيني مشردين داخل سوريا وخارج أماكن سكناهم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، فإن تلك الجموع اللاجئة قد شكلت مشكلة ً كما عبـَّرت عنها الإجراءات العربية المجاورة لسوريا، والتي راوحت مكانها من خلال استمرارها في رفض دخول حاملي جواز سفر وثيقة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إلى أراضيها إلا بمعاملات خاصة جداً قبل الأزمة السورية، والتي توقفت بعد الأزمة، نهائياً وفورياً في بعض الدول العربية، وبالتدريج في دول عربية أخرى دون مراعاة أن اللاجئين الفلسطينيين هم لاجئو حرب، حتى إنهم لم يتم العمل بالاتفاقات العربية والدولية التي تراعي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحدياً في هذا الظرف الطارئ وخاصةً فيما نصت عليه أثناء الحروب.
ولم تقتصر المشكلة على مشكلة العرب مع الوضع الجديد الذي أقحم فيه الفلسطينيون، بل تعدَّت إلى مشكلةٍ أكبر وهي وصولها إلى معضلة عدم قدرتهم على إيجاد حلٍّ ولو مؤقت، بل زيد الطين بلة، وعومل اللاجئ الفلسطيني كأنه لوثة يجب الوقاية منها، وبدا ذلك واضحاً من الازدواجية في التعامل مع اللاجئ السوري الأصل واللاجئ الفلسطيني، من حيث إجراءات الإقامة في البلد المضيف أو المساعدات الإغاثية، وحتى التعليمية بكافة مراحلها ، والاستشفائية أيضاً، بحجة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) هي المسؤولة عنهم، وبحجة أن التمويل العربي أو الدولي شحيح من المصدر للدول المضيفة وأنه محصورٌ باللاجئين السوريين بالأصل فقط .
وبين مقصات الإجراءات غير العادلة، والملاحقات المعنونة بالأمنية لمنع الفلسطيني من العمل حتى في الأعمال التي يرفض المواطن في البلد المضيف القيام بها وممارستها، يبقى اللاجئ الفلسطيني تائها في متاهات حياةٍ فرضت عليه وتم تحميلها على كاهله ضمن تركيبةٍ عجيبة وصلت حد الغير معقول، والمزاجية البيروقراطية التي تحكمت به حسب كل منطقة داخل البلد المضيف، دون مراعاة أنه إنسان وقعت عليه ذات الظروف التي وقعت على باقي اللاجئين السوريين.
وإننا لنجد أن اللاجئ الفلسطيني في تلك الدول أصبح يجيد لعبة القط والفأر، بينه و بين ما يمثل القوانين المطبقة في دول اللجوء العربية، فقط من أجل تأمين قوت يومه وعائلته، محققاً في الوقت ذاته رُقيـّـاً ملحوظاً وهو ليس بالغريب عليه، من خلال عدم تسجيل أي قضية جنائية ضده، وذلك يعود بالطبع إلى أصول تربيته وثقافته الحقوقية والقانونية داخل البلد المقيم فيها وخارجه، حتى ولو لم يكن متعلماً أوحاصلاً على درجةٍ علمية ٍ معينة.
وبالمناسبة فإن تجربة تواجد اللاجئين الفلسطينيين ضمن تجمعات مواطني البلدان المضيفة، قد عكست ثقافتهم ووعيهم العالي والتي كانت تظهر ضمن تطبيق البرامج التي كانت تقيمها الجمعيات الاجتماعية الوطنية والمنظمات غير الحكومية، والخاصة باللاجئين أوقات الحروب، وباعتراف المثقفين والقائمين على الأنشطة والبرامج في المؤسسات المعنية، وهو ما يجب أن يشجع الدول المضيفة لتحسين التعامل الإيجابي المتبادل بين طرفي المعادلة المستجدة على دول الجوار السوري والإقليمي.
لذلك على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من سوريا أن يقدروا حرص أولئك عابري السبيل على الحفاظ على السلم الأهلي المـُـرَاعـَى في بلدانهم، وأن يجدوا فسحةً في منطق إجراءاتهم وقراراتهم، وأن يجدوا ممراً نحو قوانين تتوافق مع الاتفاقات الدولية التي تراعي حقوق الإنسان في حالات الحروب وبالتالي يحقق العدالة ويرسخها على الأرض، مما يرفع من شأنها بين الدول، فيـُحـتَسَب في ميزان نفوذها وإنجازاتها في حالات الكوارث الإنسانية والحروب.
إن اللاجئ الفلسطيني من سوريا يواصل كونه جزءاً من قضية الثوابت الوطنية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين، وهو يتعرض حالياً إلى تضييقات عدة ترزح تحت عناوين لا ينبغي بقاؤها هناك، وهو يعض على الجراح للحفاظ على صورة الفلسطيني الوطني الحامل لرايته الوطنية من أجل تحرير وطنه فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، لكنه بحاجة ماسة لتقوية مواقفه، وذلك من خلال تأمين مقومات صموده في أماكن تواجده داخل وخارج سوريا، حسبما دفعت به ظروف الحرب البشعة بكل المقاييس، وتأمينها يأتي من ذوي القربى أولاً، وهم إخوانهم العرب، ولن يخيب ظنـّهم أو زرعهم إن فعلوا أبداً.



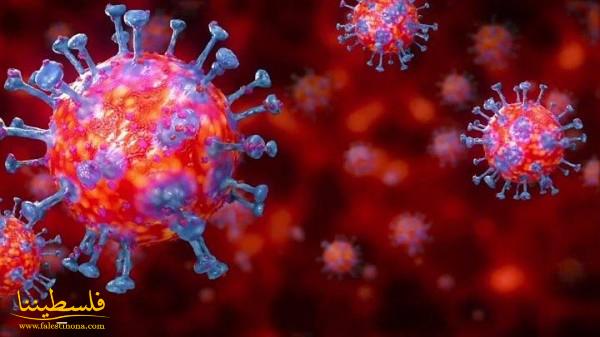




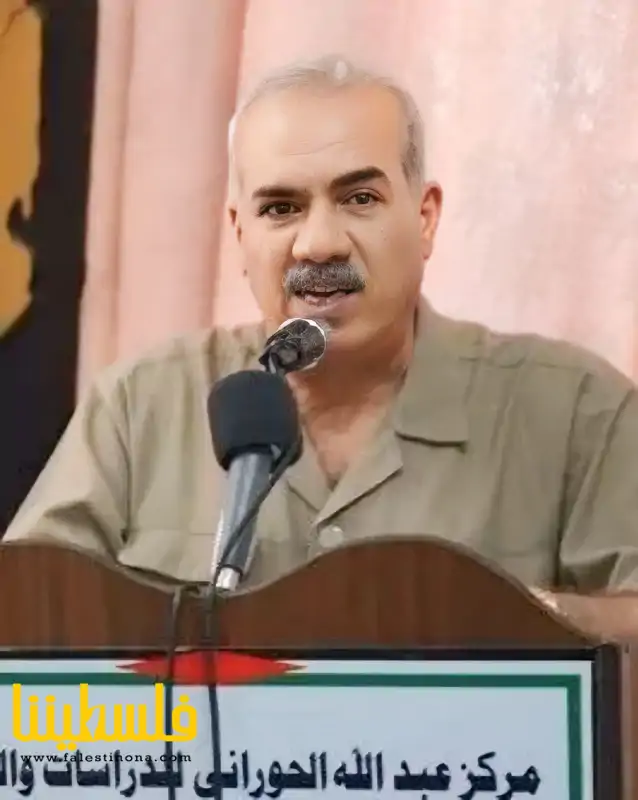






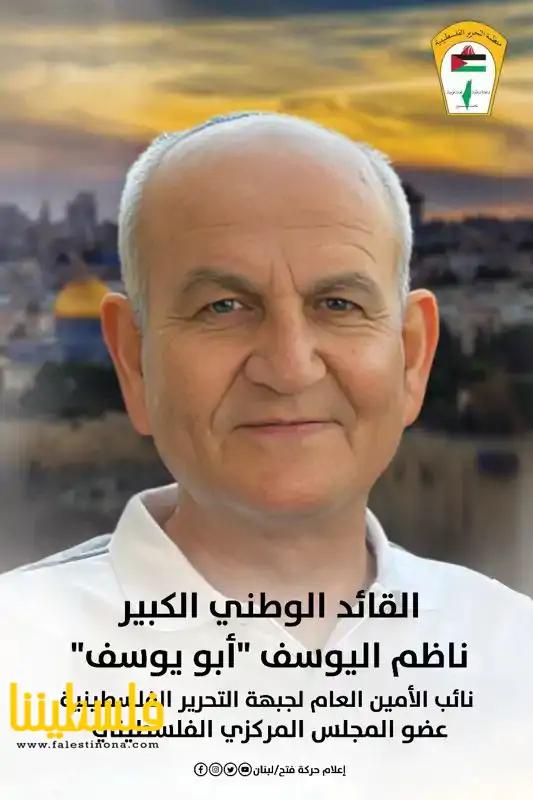

تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها