الشاعرة الفلسطينية نهى عودة
لم تكن النَّكبةُ إحراق البيوت وتهجير الناس والتنكيل بهم فحسب، بل طمس هويَّتهم التاريخية المُمتدَّة إلى قرونٍ طويلةٍ من الزمن، طمس الذكريات الكثيرة، والعبثُ بالقبور التي تعجُّ بالأجداد المناضلين، فتاريخ النِّضال الفلسطيني لم يكن مُرتبطًا فقط بما فعلَه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بل بما سبقه من تخطيطٍ وقتلٍ في ظلِّ الانتداب البريطاني أيضًا.
في عام 1924 ولِدت الجميلةُ (آمنة) لعائلةٍ فلسطينيَّةٍ طيِّبةٍ مُطمئنَّة، وكان قد سبَقها إلى الدُّنيا الأخُ الأكبر فقط بثلاثة أعوام، ولم تلبث فرحتُها أن تكتمل، وهي تترعرع تحت سماء فلسطين، ففي الرابعة من عمرها تُوفيت والدتُها تاركةً بصمةَ اليُتم الحقيقيَّة لطفلين صغيرين يحتاجان إلى رعايةٍ كبيرة وحُبٍّ أكبرَ، ومَن غير الأمِّ يستطيعُ أن يوفِّرَ الأمانَ الروحيَّ، والرَّجلُ دومًا مُنغمسٌ في عمله، لكن والد آمنة تكفَّل بذلك، فقد كان يُطعِمها بيديه، وخصوصًا التَّمرَ الذي كانت تذكره جيِّدًا، ويجدلُ لها ضفيرتَها.. مُتَّخِذًا دور الأمِّ والأب في آنٍ واحدٍ.
كان والد آمنة يمتلكُ حنانًا فيَّاضًا يملأ فراغَ الفقد الذي تركه رحيلُ الأمِّ، لكنه في الوقت نفسه كان مناضلاً ضد المُحتلِّ البريطاني. لم يعش طويلاً، فقد استشهدَ وآمنة في الثامنة من عمرها، على يد القوات البريطانية (الإنجليز) كما كانت تُخبرُنا باسمهم.
سكَنَ الحزنُ مُبكِّرًا في قلب جدَّتي منذ طفولتها عندما فقدت والديها قبل أن تُكملَ العقدَ الأوَّل من عمرها. نَذكُر الأيَّامَ التي كانت تبكيهم وتحِنُّ إليهم وخصوصًا والدُها الذي أتقنَ دوره. انتقلت هي وأخوها العمُّ (أسعد) إلى بيت عمِّها فقد تكفَّل برعايتهما وتربيتهما حتى شَبُّوا وتزوجوا وصار لكٍّ منهما أسرَةٌ داخل الوطن. كانت آمنة تستحضرُ في كل فرحةٍ حزنًا كبيرًا على والديها اللذين لم يُشاركَا في أيّ فرحٍ من أفراحها، وأكثرُ ما أحزنَها أنَّ والدتها لم تكن هي أوَّلُ مَن احتضن مولودَها البِكر، على عادةِ النَّاس في وقتها، رغم الحب الكبير الذي أنعم به العمُّ وزوجتُه عليها وعلى أخيها "أسعد".
لم يحظَ العمُّ (أسعد) ولم يُكتَب له أن يُرزق بأطفالٍ، أمَّا جدتي فقد رُزِقت بخالي الأكبر (صالح) المولود عام 1944، وبعدهُ رزِقت بفاطمة (والدتي) ببضعةِ شهورٍ قبل نكبة 1948. وقد كانت والدتي هي البنت الوحيدة مع خمسةِ أبناء آخرين هم أخوالي.
لم تنعم عائلةُ جدَّتي طويلاً بالطمأنينة والاستقرار والحياة الهانئة، فسرعان ما امتدَّت أيادي المُحتلِّ بالقتلُ والتَّنكيل والنَّهبُ إلى القرية، مِمَّا اضطرَّ العائلة مع عائلاتٍ أخرى كثيرةٍ إلى الخروج من شمال فلسطين نحو جنوب لبنان، مُخلِّفين وراءَهم قبورَ آبائهم وأمَّهاتهم وذكرياتهم.. غيرَ أنَّ أرواحَهم وآمالَهم بقيت متعلِّقةً بتراب قريتهم، لأنَّهم اعتقدوا بأنَّ رحيلهم طارئٌ قد يمتدُّ إلى سنواتٍ مهما طالت فلن يكون رحيلهم بلا رجعةٍ.
قبل خروجهم من القرية، عملوا على إبقاء مُقتنياتهم الثَّمينة داخلَ حفرةٍ كبيرة خبَّأوا فيها أيضًا ثيابَ العُرس (جهاز العروس) وحُليِّها.. ويقينُهم أنَّهم سيستخرجونها من الحفرة بعد عودتهم. ولم يعلموا، وكيف يعلمون، بأنَّه الخروج الأخير الذي لا عودةَ بعده إلى قريتهم (البروة)، هذه القريةُ التي اشتهرت في شمال فلسطين بقوَّة نضالها ومقاومتها للاحتلال الإنجليزي ومن بعده الاحتلال الصهيوني.. ولم تزل (البروة) يومنَا هذا مُدمَّرة بالكامل، يحيط بها سياجٌ على امتداد محيطها، ولم يُسمَح لأيّ فلسطينيِّ أن يعيدَ البناء والسَّكَن فيها.
كانت الأيامُ قاسيةً جدًّا في طريق الخروج من الوطن، حيث كانت جدَّتي تحمل والدتي على ذراعيها، وجدِّي يحمل خالي الأكبر، وباقي أفراد العائلة يسيرون معًا نحو خطِّ تهجيرٍ وتشرُّدٍ واحدٍ، وقد كانوا أصحابَ الأرضِ والميراثِ والكلمة العليا في بلدتهم.. ثم انقلبت الحياة فوجدوا أنفسَهم يلتحفون السماءَ وتمتدُّ بهم الخُطى نحول المجهول، فيمرضُ هذا وذاك في الطريق، والبعض منهم يموت ويدفن قبل أن يصل إلى الشريط الحُدودي الفاصل ما بين لبنان وفلسطين.
أيامٌ لم تَمرّ كما الأيام التي اعتادوا عليها في قريتهم الآمنة المطمئنة، ففي ذلك الخروج كانت النَّظرات تستدير إلى الخلف وتلاحق البيوت وهي تصغُر وتصغرُ حتى صارت مثل نقاطٍ سرعان ما اختفت في الشُّحوب.. كان الذُّهول وحشًا يفترسُ الجميعَ، ومن حينٍ إلى آخر يتسلَّلُ إلى القلوبِ وعدٌ بالعودة السَّريعة إلى أرض الوطن، ولا أحد كان يعرفُ مِن أين جاء ذلك الوعدُ ومَن كان الضَّامن بتحقيقه، ولكنَّه كان عزاءً للقلوبِ المُنكسرةٍ..
أصواتُ الأطفال، في المُخيَّمات التي نُصِبت من الخِيَم للاَّجئين أو المُهَجَّرين بتعبيرٍ أعمقَ تعبيرًا، كانت أكبر وأعلى من أن يستوعبَها المكانُ ولا حتى الزمان.. كيف تنفى الأرواح والأجساد هكذا؟ وكيف يبكي الرجال من القهر، وكيف تمتلئ عيونهم بنظرة الخيبة والأسئلة الكثيرة؟ وكيف يمكن أن يتحوَّل من كان سيِّدًا في أرضه فيصير لاجئًا في غمضةِ عين، ينتظرُ دورَه حتى يحصل على ما يسدُّ به رمَق جوعِ أطفاله وهو الفلاَّحُ الأصيلُ الذي يزرع بيده ويأكل من خيره ويحمد ربه في تراب بلاده؟


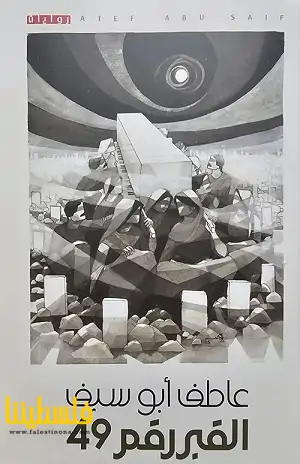













تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها