بقلم: الشاعرة نهى عودة
لم تكن فلسطين كأيّ وطنٍ آخرٍ، ولم يكن التواصل الاجتماعي مثلما هو عليه الآن، كنَّا نعلم عن وطننا مِمَّا يُقال لنا من أجدادِنا، ومن مَدارِسنا وتحديدًا من مُعلِّمِينا الذين وجَّهوا قلوبَنا دومًا نحو وطننا، ولهم الفضلُ الكبير والعميق في بناءِ عناصرٍ كثيرةٍ من شخصياتِنا.
كانت المناهجُ المُتَّبعة في مدرستنا هي المناهج اللبنانيَّة، فنحن نعيش في كنَفِ لبنان ونتنَّفسُ هواءَه، ونسيحُ في ربوعه، ونعجُّ بالكثير من الذكريات المرتبطة بالأماكن هنا وهناك في هذا البلد الذي آوانا، وما زلنا على قيِدِ أملِ العودة إلى فلسطين.
نظامٌ صارمٌ كان يحكم مدرستَنا في كل شيء، اللِّباسُ المَدرسيُّ المَوَحَّد، وتقليمُ الأظافر، ومنعُ ترْك العِنان للشَّعر أنْ ينسدلَ على الأكتاف، حيث يتوجَّبُ على الفتاة أن تشدَّه. في كلِّ صباحٍ، يعتمدُ ناظِرُ المدرسة سياسةَ التَّفتيش اليوميِّ، والمشْي بين جميع الصفوف، حتى أنَّنا لم نكن نجرؤ أنْ نهمس إلى من يكون أمامنا في الصَفِّ.
واقعٌ جميلٌ ومنظَّم، ربَّما يزعجك في بعض الأشياء لأنك لم تكن بكامل نُضجك، وكانت المدرسةُ تُنهي خدماتها أمام الطلاب عندما تكتملُ المرحلةُ المتوسِّطةُ (الصف التاسع)، ولم يكن هناك ثانوياتٌ تابعةٌ إلى وكالة الغوث، كان الأمر متروكًا إلى الأولياء بأنْ يتدبَّروا أموره أبنائهم في الثانويات اللُّبنانيَّةِ الرسمية أو الخاصة حسب قُدُراتهم الماديَّة ومستوى مَعيشتهم.
كنت أذهبُ إلى المدرسة في الصباح المبكر قبْل أن يرِنَّ جرسُ الدخول. كنت أشعرُ بالانتماء إلى هذا المكان، وبأنَّه جزءٌ أساسيٌّ من حياتي اليوميَّة. مدرستي كانت بمثابةِ منزلي الذي ينبضُ بالذِّكريات الجميلة، فمنذ وقت طويل وأنا أجلسُ في المقعد نفسه وأتأمَّل من نافذة الفصْل الشجرةَ نفسها، والعصافير الجميلة وهي تتلقَّطُ رِزْقها أو تلهو من غُصنٍ إلى آخر.
في المدرسة، شعرتُ للمرة الأولى بنبْضٍ جميلٍ لم أعلم تفسيره ولم أعرفه من قبْل. رأيتُ وجهًا اعتدْته، لكن هذه المرة كان شكلُه مُختلفًا. خشِيتُ من الأمر وما يُمكن أنْ يترتَّب عليه. كنَّا نتعامل بأخويَّة عاليةٍ ضمْن مجموعات، ولم يكن هناك تعقِيداتٌ ولا اختلاف بين أنثى وذكر، هكذا نشأْنا وترعْرعنا، لكن إذا وصَل الأمرُ إلى الخصوصِيَّة المُرتبطة بالمشاعر وشؤون العواطف والقلب، فالأمرُ يصيرُ مُعضِلةً كبيرةً جدًّا، لأنَّ الجميعَ يعرفون من أنت وأين تسكن ومن هُم إخوتك وأخواتك. لذلك تتوجَّهُ الفتاة إلى الصمت، فلا تعلم كيفيَّة اكتشاف مشاعر الحبِّ القادمة إلى طريقها لا محالة، وتكتسبُ صمْتًا خاصًّا يخدمها، وتُحاول أنْ تُبقِي لَمْعة العينِ محفوظةً وعصيَّةً على اكتشافها.
تكبر أعوامًا وأعوامًا، وتترفَّعُ من صف إلى آخر، تستعجل المراهقةَ والثانوية والجامعة، ولا تعلم بأنَّك ستقف قبْل مرحلة الجامعة وقفةَ الحائر، حيث تصطدمُ بواقعك الفلسطيني في مُخيَّمات اللُّجوء، عندما تعلم بأنكَ ممنوعٌ من مُزاولة المِهَن والوظائف الكثيرة في لبنان، يَصِل عددُها إلى 73 مهنةً، فتدركُ بأنَّ اختصاصك وعملك المستقبلي له سقفٌ يحُدُّ رأسك وطموحاتك، فتبدأ حربَك المرئية واللاَّمرئية في مرحلة جديدة من العمر. كان هذا شأني وشأنُ كلّ فلسطينيٍّ في مُخيَّمات اللاَّجئين في لبنان.













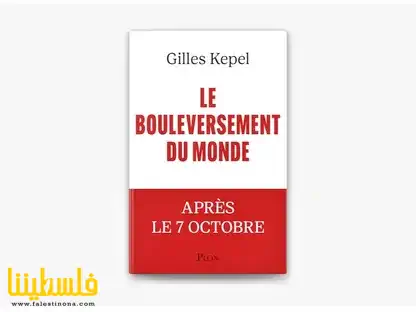


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها