نعم، كاد قلبي أن يتوقف وأنا أتابع هذا الطراد الغريب العجيب، لطلاب المدارس، بسيارات الجيب الإسرائيلية من شارع إلى شارع ، ومن حارة إلى حارة، وزعيقها الرّاعب يدويّ، وبنادق الراكبين فيها ممدودة بشراسة وغطرسة وقحتي من النوافذ، كيما تطلق النار على الطلاب الذين استتروا بالبيوت والأشجار والمنعطفات، والزوايا، وخوفهم يتجلى على شكل ركض محموم، ولاهاث عالٍ، وصفرة للوجوه، والتواء للأرجل الباحثة عن مأمن من الرصاص الذي راح يتعالى بالوحشية التي تليق بتاريخ الجنود الدموي طوال 74 سنة من ثقافة الاخافة.
هذا الطراد الوحشي، لم يكن في غابة، ولا في برية، ولا قرب شواطئ بحيرة، بل كان، أيها العالم الأخرس الأطرش الأعمى، في مدينة بيت لحم، مدينة سيدنا المسيح عليه السّلام، وفي أثناء خروج تلاميذ مدرسة ابتدائية أصغرهم في السادسة من عمره، وأكبرهم في الثانية عشرة من عمره أيضاً، كانوا قد خرجوا من المدرسة، فرأوا سيارات الجيش الإسرائيلي تطوّق المكان، وتسدّ الطرق، والجنود المدججين بالسلاح يعتقلون الرجال والشبان، ويشتمون النساء، لذلك راح التلاميذ يهتفون: بلادي.. بلادي، ويرفعون أصابعهم بشارة النصر، وهنا جنّ جنون الجنود، فتحولوا نحو التلاميذ وراحوا يطاردونهم بسيارات الجيب، لكن الأزقة والأدراج، التي أسسها وبناها أهل البيوت منذ آلاف السنين، حمت التلاميذ وسترتهم عن أعين البنادق الشيطانية، وحالت بين سيارات الجيب الرعناء، وهذا الجنون الحامضي، وبين التلاميذ الذين واصلوا الركض نحو البيوت، وقد نجوا جميعاً من بطش الجنود عدا ريان ياسر سليمان، ابن الصف الثاني، ابن السبع سنوات، الذي لم يعش بعد طعوم مسرّته في الصف الثاني سوى أسابيع قليلة، منذ افتتاح أبواب المدرسة لعامها الجديد، وصل عتبة البيت منهكاً من التعب والخوف، فارتمى قرب العتبة ظناً منه أنه نجا من الرصاص الإسرائيلي، وأنه ربح الطراد، فالجنود لم يلحقوا به، وعيون بنادقهم الشيطانية لم تلحق به أيضاً، لكن التعب والخوف أحاطا بقلبه الصغير، فتوقف عن الخفقان؛ مات ريان ياسر سليمان! وليس قربه سوى حقيبته الملآى بالكتب والكراريس والأقلام، وقد تناثرت حوله، فبدت شاهدة الحضور والغياب، وشاهدة المطاردة ما بين البنادق والرصاص والهمجية من جهة، والطفولة والبراءة والكتب والخوف من جهة أخرى.
لقد لحقت سيارات بالطفل ريان ياسر سليمان، ورأى جنودها موت الطفولة، وهمود الجسد، والكتب والكراريس والأقلام والمسطرة والمبراة والممحاة تحيط كلّها به مثل السّياج، كان الغضب يلفّهم مثل زوبعة غبار عاتية، لهذا داسوا الكتب والحقيبة، والكراريس، والأقلام، والمسطرة، والمبراة.. مزقوها، وطحنوها، عدا الممحاة فقد بقيت سليمة، وكانت عينا ريان ياسر سليمان تنظر إليها، لأنها ستكون لاحقاً بيد تلميذ يشبه ريان ياسر سليمان، كيما تمحو هذه الممارسة الهمجية لجنود الاحتلال، بل لتمحوهم هم أنفسهم!
أجل في دارة سيدنا المسيح، عليه السلام، في بيت لحم، تحدث هذه المطاردة الوحشية من قبل الجنود الإسرائيليين، بسياراتهم وبنادقهم، للتلميذ ريان ياسر سليمان، ابن السنوات السبع، وما من حياء ولا أخلاق ولا ضمير، ولا أعراف، ولا قوانين، تردع هؤلاء الجنود أهل الجلافة والبطش والدموية، والعالم، وعبر وسائل الإعلام، يسمع ويرى ويعي، ولكن لا يحرك ساكناً، العالم المتنفذ كلّه، بمؤسساته وسياساته، ومنظماته، أخرس أطرش أعمى منذ 74 سنة، لا يريد أن يتكلم عن الحقّ الفلسطيني، ولا يريد أن يسمع البكاء والصراخ والجهر بالألم والمظلومية الفلسطينية، ولا يريد أن يرى ما يحدث في القدس، وبيت لحم، وجنين.. من قتل يومي لا يحدث إلا في البلاد الفلسطينية.
ريان ياسر سليمان، الطفل الشهيد، وأمثاله من تلاميذ المدارس الفلسطينية هم غزلاننا، وهم مستقبلنا، وهم رايتنا العالية الخفّاقة، وهم شمسنا الشّارقة بالأمل الذي يتعالى بهتافنا الأعز: بلادي.. بلادي! وهم، بأجيالهم الجديدة، كابوس الخوف والرّعب الذي قرّ في قلوب الجنود المتوحشين الذي توارثوه من أجدادهم الطغاة خلال ليلهم الطويل في بلادنا العزيزة.
المصدر: الحياة الجديدة















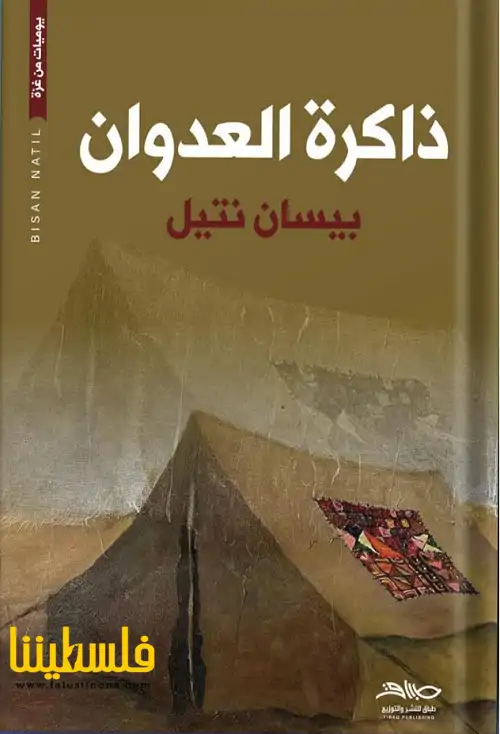
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها