في ثمانينيات القرن الماضي، فوجئ هواة الاستماع إلى الإذاعات، ببث لإذاعة جديدة على الموجتين، المتوسطة والطويلة، تبث طوال اليوم أغاني مختلفة وخاصة أغاني السيدة فيروز ومسرحيات الرحباني الغنائية، لم يكن أحد يعلم من يدير هذه الإذاعة ولأي هدف، وظلت على هذه الحال طوال الوقت، الأحاديث المتداولة، من إشاعات ومعلومات وتكهّنات، كانت تشير إلى أن هذه الإذاعة، سورية، إذ إن البث على الموجة الطويلة، "إف. إم"، تسمع بوضوح في دمشق، حينها قيل إن هذه الإذاعة، هي إذاعة بديلة في حال قيام انقلاب عسكري، إذ كان من السائد في الانقلابات العربية، أن الانقلابيين يمثلون أولاً وقبل كل شيء، الإذاعة لإلقاء البيان رقم واحد، وحيث أن سورية هي بلد انقلابات دائمة إلى أن وصلت عائلة الأسد إلى الحكم، فقد كانت الخشية من انقلاب عسكري، أمراً لا يمكن تجاهله، من هنا كانت هذه الإذاعة الاحتياطية في حال حدوث انقلاب عسكري.
موضة الانقلابات العسكرية العربية، تختلف عن تلك في انقلابات جمهوريات الموز في أميركا اللاتينية، حيث كان هدف الانقلابيين الأول، هو محاصرة القصر الجمهوري ثم اقتحامه، وكذلك كان الحال في الانقلابات العسكرية في الدول الأفريقية، وعندما كان يحدث خلل ما في إحدى الإذاعات العربية، وتتوقف عن البث للحظات، بسبب هذا الخلل، كان الاعتقاد يسود بأن هناك انقلاباً ما، لارتباط هذه الإذاعات بالانقلابات العسكرية.
تذكرت هذا السياق، وأنا أتابع ما جرى في ماسبيرو بالعاصمة المصرية، ولم أتخلّ عن ذهنية "المؤامرة الانقلاب" أثناء تلك المتابعة قبل أيام قليلة، انقلاب يأخذ من مآثر تاريخ الانقلابات العربية، الإذاعة والتلفزيون كهدف، لكنه يأخذ من تداعيات "الربيع العربي" والثورة المصرية تحديداً، الانقلاب الشعبي، وهذه المرة، ليس هناك انقلاب يقوم به الجيش، بل انقلاب الشعب على الجيش في الكورنيش الملاصق لمبنى الإذاعة والتلفزيون، والذي هو بالصدفة بجانب "ميدان التحرير" وسط القاهرة!
لم نكن في الواقع أمام انقلاب أو ثورة بالمعنى الواضح للعبارة، لكن اجتماع عدة عناصر في وقت وزمان ومكان واحد، جعل الأمر وكأنه يبدو كذلك، وهو المشهد الأول الذي يشير إلى تعقيد وأبعاد ما جرى قبل أيام قليلة في ماسبيرو، إلاّ أن هذا المشهد لا يكتمل إلاّ بالإحاطة على الأجواء التي أحاطت به، وأقصد بالتحديد، تلك الدعوات والمليونيات والجُمَع التي طالبت الجيش المصري بالعودة إلى الثكنات، والحملات الإعلامية التي استهدفت المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة، بعد أن استطاعت تشويه صورة قوى الأمن الداخلي، ناهيك عن اعتداءات وإهانات واستفزازات قامت بها مجموعات وأفراد ضد قوى الجيش، واتهامات قوى وجماعات أخرى الجيش والقوات المسلحة بالفشل، لا لشيء إلاّ لأن المؤسسة العسكرية، وأثناء وبعد الثورة، أعلنت أنها لن تطلق الرصاص على المتظاهرين، والمتظاهرون هنا، ليس فقط شباب الثورة، ولكن أيضاً، فئات تحاول إما المحافظة على مصالحها، أو الاستفادة من ظروف الثورة لنيل مكاسب لم يكن بالإمكان الحصول عليها من قبل، فئات مصالح، تعبر عن مصالحها من خلال التظاهر والاعتصام والاقتحام وحتى القتال في بعض الأحيان، لكن الجيش الذي أنقذ البلاد من حال غياب السلطة، ظل متهما بالفشل لأنه لم يطلق الرصاص، ولو أنه قد أطلق الرصاص، لاتهم بأنه من أنصار العهد البائد والمعادي للثورة!
يريد الشعب من المجلس العسكري أن يستمع إليه، وهذا حق طبيعي، غير أن المجلس عندما أراد ذلك، استمع إلى أكثر من 180 ائتلافاً حزبياً وحركات شبابية، مختلفة المشارب والانتماءات والأهداف، وعندما أراد أن يعدل قانون الانتخابات، قام بذلك بعد اجتماعه مع أكبر هذه القوى والأحزاب، اقتنعوا بالتعديلات أثناء الاجتماع، وبعد انفضاضه، وإعلان الأحزاب التي لم تشارك في هذا الاجتماع عن عدم رضاها، عادت بعض الأحزاب الأساسية عن موافقتها على التعديلات، وهكذا تجري الأمور في ثورة تحولت إلى فوضى سياسية، الناظم الوحيد لها، هو المجلس العسكري الذي يطالب البعض بعودته إلى الثكنات من دون أن يحسب حساباً لليوم التالي، إذ ماذا لو أن المجلس العسكري قد تخلى عن مهامه الوطنية في حفظ استقرار واستقلال البلاد، وتنحى عن السلطة قبل أن تنضج الظروف لتسلم المدنيين للحكم، التي تستمر بعض الجماعات والأحزاب في رفض هؤلاء المدنيين، للأسباب نفسها، والمتعلقة أساساً بالمصالح والتطلعات. ولعل العديد من القوى والأحزاب، لن تجد حلاً إلاّ بعودة المجلس العسكري إلى الحكم من جديد، فهل يعود؟!
كل ثورة تحمل في طياتها الجديد، لكنها مع ذلك تظل أسيرة القديم، والمجلس العسكري الحاكم انتقالياً في مصر، ليس شاذاً عن هذه القاعدة، وهو بالتالي عرضة لارتكاب الأخطاء، ونعتقد في هذا السياق، أن اختيار المحافظين الجدد للمحافظات، هو أحد أخطر هذه الأخطاء، لأنه اعتمد في اختياره على "الألوية العسكرية" كمحافظين جدد، وهو أسلوب النظام السابق نفسه، وعند اختياره لم يحسن اختيار البعض منهم، ومن بينهم محافظ أسوان، والذي بدلاً من دعوة المواطنين إلى الالتزام بالقانون في حل إشكالية المضافة المخالفة، والتي يقول الأقباط أن مرسوماً منذ عهد الملكية بتحويلها إلى كنيسة قد صدر موثقاً، بدلاً من ذلك، دعا المحافظ المواطنين إلى هدم الكنيسة التي كانت قيد الإنشاء، وأكثر من ذلك، فقد صرح المحافظ هذا، بأنه لو أن المواطنين لم يستجيبوا لدعوته لكان قد هدم الكنيسة بنفسه! ما يشير إلى أن هذا المحافظ، بدلاً من الالتزام بالقانون، يقوم بتنفيذ قانونه الخاص، وبفرض أن هناك مخالفة ما، فمن الطبيعي أن تخضع للمعالجة من خلال أحكام القانون والقضاء وليس بتشجيع المواطنين على أخذ القانون باليد، وعندها يأتي مثل هذا التشجيع من الجهات المخولة بحفظ النظام والالتزام بالقانون!
الثورة المصرية في خطر، لكن أخطر ما تواجهه هذه الثورة العظيمة، هو إهانة وتدمير الجيش المصري العظيم، وهو الذي لم ينزلق إلى الحكم، بل اقتيد إليه لإنقاذ البلاد من الفراغ الدستوري والسياسي، ظل صبوراً على الاتهامات والإدانات وتحميله مسؤولية الفشل والتردد، وظل عند وعده بعدم إطلاق النار على شتى أنواع المظاهرات، متلقياً قذائف من الإهانات والسباب والشتائم والاتهامات، من غير أن يحيد عن مسؤوليته الوطنية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، وفي مرحلة انتقالية، انبعثت عنها العديد من المشارب والأهواء والتطلعات.











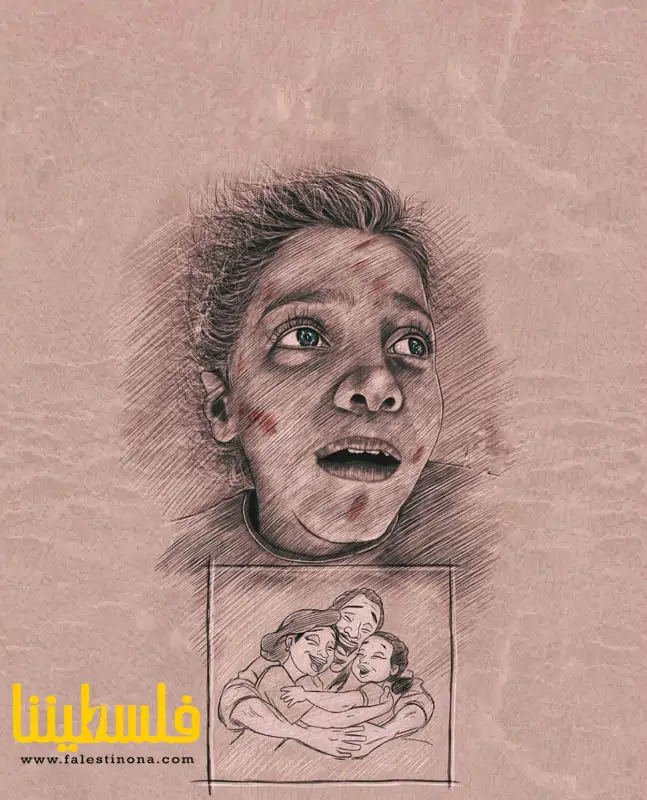



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها