بقلم/ محمد سعيــد
أتمنى لأمنياتي أن تكبر، وأن لا يشوّش عليها أحد، يمكن أن أفتح بوابة ذاكرتي وأطلّ على مكان بعيد يهدر موجه دفعة وراء دفعة، وأسمع صوته بداخلي واضحاً، لكن أدواته لا تقوى على مواجهة عالم يهدم باسم المؤاساة والعدالة، صورة مكان يخيم عليه قطيع من الغيوم المصحوبة بجراحات البؤس والتشرد، مكان مثقل بأساطير غبية تنمّ عن سذاجة وتراجع الى ما لا نهاية أمام ظلاّم وقساة وهمجيين فقدوا معنى الشعور حتى ولو بمقدار لمسة أو اشارة اوطرفة عين وجِلَة.
يلفحني هواء ساخن كلما تذكرت المأساة التي حلّت بنا ولم تجد لها الشرعية الدولية دواء شافياً أو علاجاً نهائياً يمكن أن يؤدي الى عودة الملايين لديارهم التي هجّروا منها تحت وطأة القتل والتشريد والمجازر. أحسّ بهدوء متآكل، أحاول من خلاله أن المس جسدي لأتأكد من أني موجود ولست أعيش على هامش الحياة كما تعيش الخراف! أحياناً أسترسل في الغرق وأتبرأ من ذاكرة منحتني الوهم برفض واقعٍ لا بد من تغييره، وتغيير زيف الصورة، وقتل الجمود المتجمّع في الرأس والقلب. أفتّش عن الفجر في أقلام تعيد لغة الحياة، وترسم صورة للأمنيات والأحلام رغماً عن هؤلاء السادة المتربعين على عرش الكون، أقلام تطرق رؤوسهم بشتى ارتال المطارق، من أجل أن يتحرّك هذا السكون القابع في جوف الحياة المدعوسة تحت اقدام خيول هائجة لا ترحم، ولعلها تطرق بابي كما يطرق الثلج زجاج النوافذ في الزمهرير. في خضم هذه الفوضى اتساءل متى امسك وريقات الزعتر في جبل البلوط الشامخ، ومتى أشمّ رائحة الاجداد على خشب المعاول. بعض الاحيان احسب ان الفرج قادم، ولكن الامل المفقود منذ عقود أصبح متعثراً ومترنحاً. أحاول أن أحافظ على دفئه وملمسه على أرض حياتي لعله يبزغ مجدداً كما زهور الاقحوان على مدرجات الربيع؛ لكنني أكتشف ثانية وثالثة وعاشرة أن الحنين، الحنين إيّاه الذي نتغنّى به ونخبئه في خزائن الصدور من اجل تلك البلاد، بدأ يشبّ رهيفاً في الغابات كحباتّ الزعرور بين زهور الاقحوان، متخفيا وملتحفا أعشاب البرية خوفاً من ثعالب جائعة لا تريدنا أن نبصر النور، حتى ولو في مغاور الظلم. ثم اتساءل في اليوم عشرين مرة، لماذا كل هذا الضعف وأفعال الظن المصاحبة لكل توقعاتنا التي تبقى معلقة في السقوف ولا تغني شيئاً عن الخلاص، رغم السنوات المعطوبة بسكاكين الملل والانتظار! هذه هي الحياة التي لا نريد لها ان تبقى في محطات الانتظار والعنصرية والعقاب الجماعي، وان يقترب الغد الذي نرنو اليه من دون شوشرة وكذب ونفاق، نترقب أوهام العودة مع اننا نؤمن بهذا الغد وبوجودنا في هذه الحياة، وبأننا لم ننفصل يوما عنها ولم نتبخّر، رغم أن العالم يعيش اليوم على القبح واللا معقول والخوار.
ثم أسأل لماذا لا يتحرك هذا الجمود في الاماكن التي استيقظنا فيها على قراءة الفاتحة، وعلى البرودة، وأثواب الحداد، وفناجين القهوة المرة، ومجالس العزاء، وتقبل التعازي، وانتظار الجنة عند محطات السفر؟ لماذا هذا الوهن في المفاصل والآمال والنظريات والعواطف والتفكير وعدم الاتعاظ مما حدث ومما سوف يحدث؟ ماذا لو ظلّ العالم مقفِلاً أبوابه وصامّاً أذنيه ومغمِضاً عينيه؟ أي مطرقة هذه التي تدق رأس اللاجئ في الليل والنهار، وهو يتطلع الى الحياة من باب الأمل على انها صخرته وطوق نجاته من هول هذا القدر ومما هو فيه الذي يلف حبله على عنقه؟! فلا يجد غير السراب. أين هذا الشيء الذي "هرمنا" من أجله ومازلنا نبحث عنه الى الآن. هذا الشيء الذي يدفعنا لنخرج من المياه العكرة الى رحاب الضوء لنعلن أن كل الذي بين أيدينا أقلّ بكثير مما نطمح اليه؟ ما يجعل طريق العودة مقفَلاً الى ما لا نهاية، وان مغزى البحث عن وجود هذا الشي ء يرسم لوحة وطن على هذا الكوكب في الاحلام.


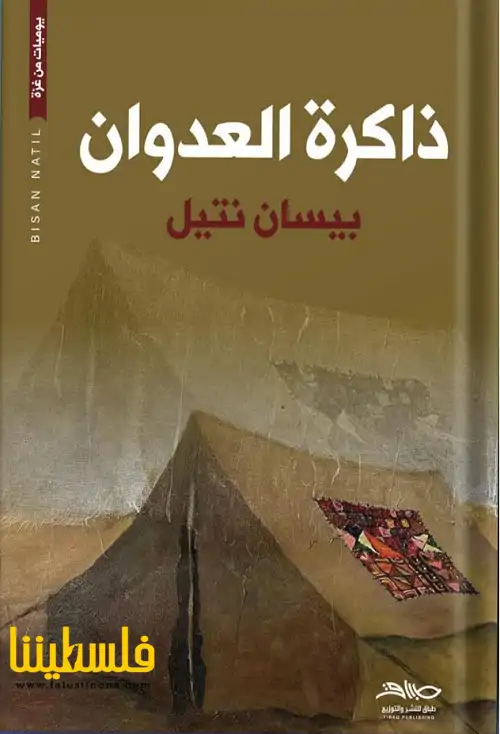







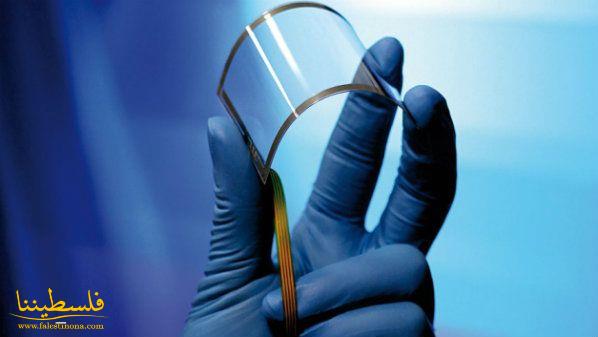





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها