لو حكمنا على مجتمع منصات التواصل الاجتماعي واعتبرناه سلبيًا من جوانبه كافة، فهذا حكم مناف لقواعد العدل، والعكس صحيح إذا اعتبرناه إيجابيًا، لكن ماذا لو قلنا بصفة عامة إن هذه المنصات عاكس طبيعي لحال المجتمع، فنعتقد أننا اقتربنا قليلاً من منصة العدل، أما إذا قلنا إنها عاكسة لنمط تفكير فردي وجمعي مؤطرمعين، وغير مؤطر خاضع لواقع التسليم، وفاقد لعقلية التفكر والتحليل والاستخلاص، فنعتقد أننا بهذا التشخيص نكون قد اقتربنا أكثر من وضع الإصبع على الجرح وموضع الألم.
يستطيع الباحثون تشخيص صحة أصحاب منصات التواصل الاجتماعي النفسية والسلوكية وتحديدًا (الفيسبوك والتويتر) بمنهج علمي للوصول إلى نتائج منها الغث والسمين والمفيد، والموضوعي، والعلمي التثقيفي المعرفي، وما يستحق صفة الإبداع، وفي الجانب الآخر سيجدون الفظ، الباعث على اليأس والإحباط، والعدمي العبثي، والمضلل – (الموجه وغير الموجه) – والمنبعث من مداخن الجهل والتجهيل، والظلم المسلط على قيمة الإنسان وعقله، وفكره، تطلقها فوهات حقد وكراهية وعدائية معلبة جاهزة، فتقصف بعبارات انحطاط أخلاقي - هذا وصف محسن نوعاً ما – كل مخالف أو معارض أو صاحب فكرة أو رأي جديد سديد !...والمؤسف أن هذا الجانب السلبي جدًا، والباعث على الاشمئزاز والمنفر سيحتل نسبة مرعبة، وهذا بشهادة رواد وأصحاب المنصات العقلانيين (المؤدبين) الذين يحترمون أسماءهم وصورهم وأسماء وصور أصدقائهم.
إن أي باحث أو دارس يقرر تشريح جسد منصات التواصل الاجتماعي المحلية والعربية بالبحث العلمي والدراسة، عليه التأكد أنه يتمتع بجرأة الطبيب الجراح، فالباحث سيضطر للتعامل مع عفن، وروائح نتنة، وكائنات لزجة تدفع المرء نحو ذروة التقزز، الباعثة على التقيؤ، والغريب في الأمر أن معظم هذا المشهد يتم تكوينه بأفظع عملية اغتصاب للغة العربية الفصحى المحكية على حد سواء، أما الصورة، فإن مزوري العملات الصعبة يقفون مبهورين مستسلمين أمام قدرة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حتى أن جريمتهم الضاربة لأمن واقتصاد الدولة تعتبر درجة ثانية، فالنصابون المزورون الذين يحتلون هذه المنصات هؤلاء يضربون العمود الفقري للمجتمع، ويدمرون مركزه العصبي، ويعطلون خلايا الدماغ المتخصصة بالذاكرة، ويصيبون البصيرة بداء الزيغ والانحراف البصري، أما مواضيع التحليل والتركيب والتجربة والتفكير عند المتصفح البسيط فتصبح في خبر كان...فالمنصات ( إياها ) تشبه تسونامي يجرف كل ضعيف أو خفيف أو غير متجذر حتى الأعماق أو من دون أساسات فكرية ثقافية أخلاقية وطنية متينة قوية، قادرة حتى على الصمود بوجه زلازل وأعاصير الغزوات من أي جهة أتت.
تكشف هذه المنصات عورات اصحابها أدعياء ريادة في السياسة والمجتمع والثقافة، حتى الأرصاد الجوية صارت عند هؤلاء أشبه بقراءة عرافة لفنجان قهوة، كما تكشف الذين يعتقدون أنهم فريدون لا توجد نسخة أخرى تماثلهم في العالم، وتفضح الدكتاتورية والاستبداد والرغبة الشديدة في ممارستها بأشد أدوات القمع والتنكيل الكامنة لدى نفوس البعض المريضة، فالأحكام على هذا أو ذاك بالخيانة، أو بالكفر، أو بالانحراف والشذوذ أو تجريده من الأخلاق والسلوك الحسن باتت ألغامًا موقوتة، لن تبقي للمجتمع قائمة إذا انفجرت.
كانت وما زالت وسائل وتكنولوجيا الاتصال عاملاً ثوريًا في نشر قضايا الشعوب والمجتمعات البشرية على تنوع أعراقها وأجناسها، الأفكار الخلاقة الممكنة لحلها، وفضاء لا محدودًا للتواصل بين الناس في الدنيا دون الحاجة لقطع المسافات والمرور عبر معابر الحدود الدولية، فعوائق اللغة وحواجزها أزالتها الترجمة الفورية بأشكال متعددة، وبات ممكنا للفلسطيني مثلاً مخاطبة الأميركي والفرنسي والألماني والأفريقي والبريطاني والصيني والأسترالي والكندي مثلا، بكلمات محدودة مرفقة بصورة أو شريط فيديو لا يتعدى الـ60 ثانية، فيكسبه صديقا للشعب الفلسطيني، أو على الأقل يخلق عنده حالة من النقاش الذاتي، لكن
بعد نقاش موضوعي عقلاني يبدأه صاحب القضية أو متبنيها...فكيف إذا وظفنا هذه الوسائل لتعزيز الالتقاء حول أفكار وأهداف نبيلة، واستغللنا فرصة المكان والزمان المفتوحين بلا حدود لمناقشة قضايانا بهدوء وعقلانية وموضوعية، دون ارتكاب جريمة القدح أو الذم أو القذف.. فنحن إذا زاوجنا الحرية وتكنولوجيا الاتصال، فإن المولود سيكون عقلاً إنسانيًا متنورًا مشعًا على العالم بالإبداع والمحبة والسلام.
المصدر: الحياة الجديدة









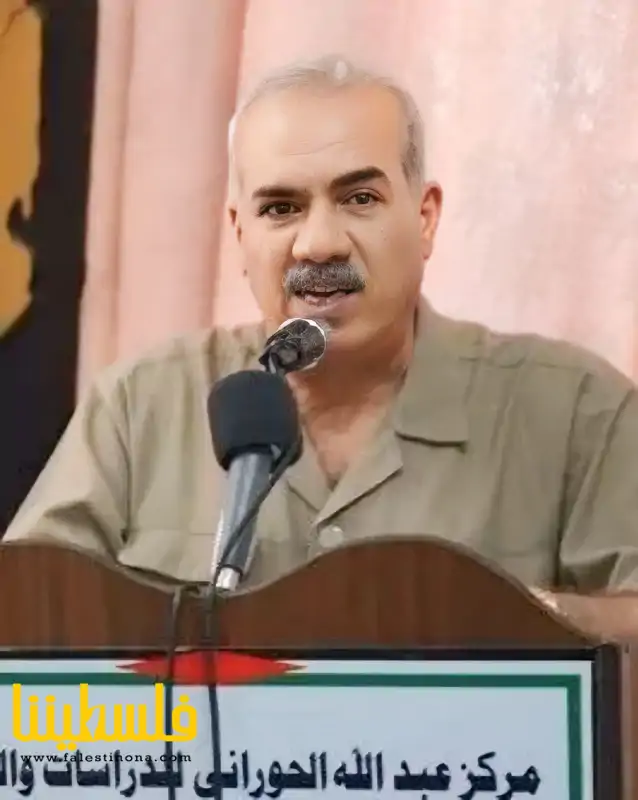




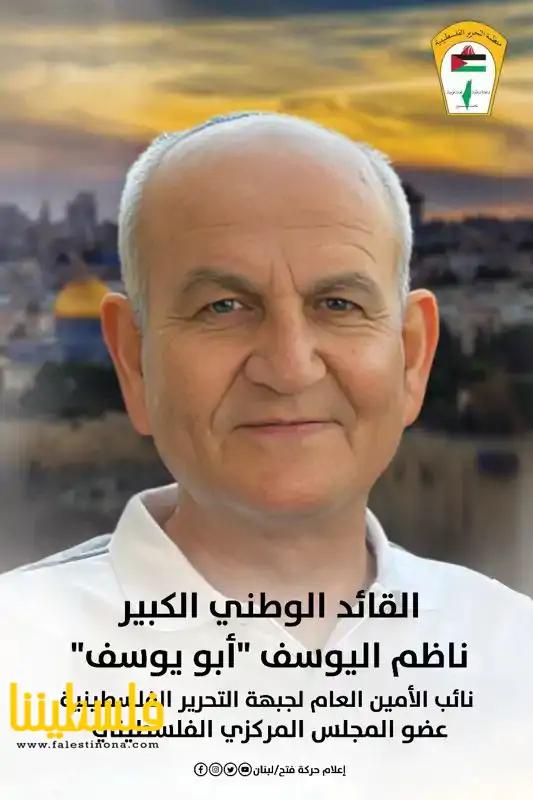

تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها