من بديهيات القول، إن الحروب والاشتباكات المسلحة، وكل الأعمال الإرهابية، هي سياسة بأدوات عنفية، كما أن العمليات الاقتصادية والمالية ليست سوى السياسة بأدوات معيارية أخرى. بتعبير آخر، تعتبر السياسة العامل المحرك لكل مناحي المجتمع البشري على المستويات المختلفة: المحلية والإقليمية والدولية، ولا يمكن فصل أي عملية اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية / فنية عن السياسة.
وبالعودة لعمليات التصعيد العسكرية على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية في محافظات الجنوب مطلع الأسبوع الحالي، لا يمكن فصلها عن السيناريو السياسي الأعم، الذي يجري إخراجه بمجموعة من الأدوات: الإنسانية، الاقتصادية، البيئية ... إلخ لبلوغ الهدف المراد، وهو تمرير الحل الأمني الإقليمي، الذي هو جزء من صفقة القرن الترامبية، إن تمكن "البطل" الأميركي الإسرائيلي ومساعدوه العرب والعجم من تحقيق غايته.
وللأسف هناك أدوات يتم إقحامها في الفيلم المروع، دون أن تدرك حقيقة اللعبة السياسية، لأن خلفياتها مختلفة ومغايرة لخلفيات اللاعبين الرئيسيين. ما يضفي نوعا من الضبابية عند عامة الناس على هذه العملية أو تلك. لأنهم يسقطون في دائرة المعيار الشكلي عند محاكاة ما يجري. وبالتالي سقوط الضحايا، وعمليات التدمير الملازمة لها، وصخب الشعارات الديماغوجية المرفوعة بين الجانبين، ومساعي الأطراف العربية والإقليمية والدولية لتهدئة الأمور أو رش السكر على الموت، ليست سوى المساحيق التجميلية لعملية الإخراج.
غير أن لقراءة المشهد وجهين، الأول يهدف كل من دولة الاستعمار الإسرائيلية وحركة الانقلاب الحمساوية إلى تحقيق مصالحهما التكتيكية من خلال عملية التصعيد لبلوغ أكثر من هدف: أولا مضاعفة المشهد الغزي الفلسطيني مأساوية وكارثية أكثر مما هو عليه، لتعميق وتعميم البعد الإنساني على حساب البعد السياسي؛ ثانيا تلميع حركة حماس الإخوانية، وتعزيز دورها في المشهد السياسي الفلسطيني عموما والغزي خصوصا، لإضفاء "الشرعية" على سلطتها الانقلابية؛ ثالثا ترسيخ عملية الانفصال بين جناحي الوطن الفلسطيني، عبر عزل القيادة الشرعية عن ملفات القرار الوطني في محافظات الجنوب، هذا من جهة، وعبر عمليات التحريض عليها في أوساط الشعب نتيجة إقدامها على بعض الإجراءات، التي اتخذتها لمحاصرة الانقلاب الحمساوي فقط، وليس شيئا آخر، أي أنها لا تستهدف الشعب؛ رابعا استخدام التصعيد كورقة من أوراق الضغط على القيادة الشرعية، لثنيها عن رفضها لصفقة القرن الأميركية. والإيحاء لها، بأن من مصلحتها "البقاء في الحلبة" بدل الابتعاد عنها، لأن ذلك يكون على حساب حضورها وموقعها في العملية السياسية. لا سيما وان البديل الانقلابي الإخواني موجود وجاهز للقيام بأي دور يوكل له.
لكن من زاوية أخرى، لا يمكن اعتبار العلاقة النفعية المذكورة أعلاه بين طرفي معادلة التصعيد العسكري (إسرائيل وحماس الإخوانية)، هي علاقة دائمة، وقابلة للحياة في كل المراحل، حتى وإن تم إنشاء وخلق كل من جماعة الإخوان المسلمين ودولة إسرائيل كأدوات لخدمة أهداف الغرب الرأسمالي لتفتيت وتمزيق وحدة دول الوطن العربي، ولتطويعها لنهب ثرواتها وموقعها الجيوبوليتكي في معادلة الصراع الأعم مع الأقطاب الدولية الأخرى، مع الفارق بين المشروعين وأولويتهما وضرورتهما للغرب الرأسمالي. إلا انهما ورغم الخلفية الدينية والسياسية المتشابهة لكليهما، يسيران في المحصلة إلى نقطة الصدام في المستقبل البعيد، لأن حدود سيطرة الغرب عليهما، أو بتعبير آخر على جماعة الإخوان المسلمين قد تخرج عن السيطرة في لحظة سياسية محددة، لأن التعبئة القاعدية للجماعة تنتج وعيا وأهدافا مغايرة للقيادات المتنفذة فيها، والملتزمة بأجندة وأهداف الغرب الحامي والداعم لها، وبالتالي يمكن حدوث تمرد في زمن لاحق. أضف إلى ان تأجيج المشاعر الدينية، وحرف العملية السياسية برمتها من قبل دولة إسرائيل الاستعمارية باتجاه الصراع الديني، وما يتلازم معها من شحن متواصل من قبل إدارة الرئيس ترامب الأفنجليكانية للشارع المسيحي الغربي المتساوق معها واليهودي الصهيوني، قد يدفع الأمور دفعا إرادويا إلى متاهة الحرب الدينية الأشمل والأكبر وعلى حساب العملية السياسية.
لكن ذلك الصراع المحتمل في المستقبل غير المنظور، لم يلغ المصالح المشتركة بين الطرفين (حماس وإسرائيل، ومن خلفهما الولايات المتحدة) لأن مصالحهما المشتركة الحالية، تحتم عليهما تبادل الأدوار وصولا للأهداف المشتركة، وهي تمرير صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية إن تمكنوا من ذلك. ولكن هيهات أن يبلغوا مبتغاهم في ظل القيادة الشرعية الوطنية، ورفضها لتمرير الصفقة المؤامرة.















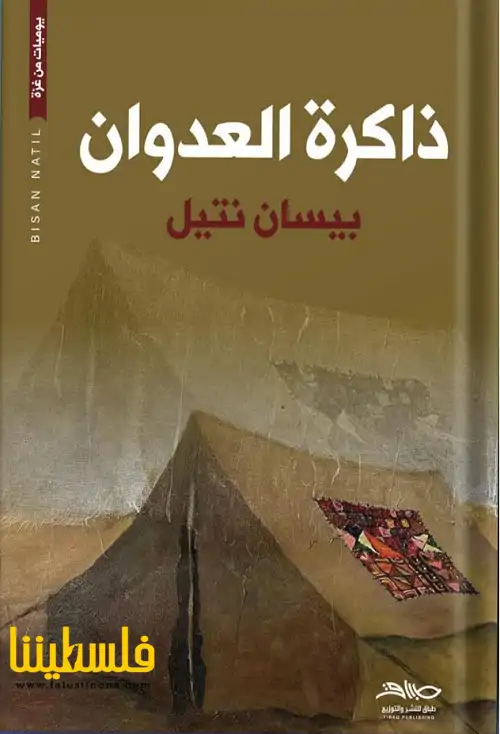
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها