بقلم: محمد سرور
تتميز ألحقبة الاوبامية بكونها تبالغ في تحولاتها التكتيكية والإستراتيجية أيضا فسيدة العالم بلا منازع، ومنذ أكثر من عقدين كتب فوكوياما عن "نهاية التاريخ" ما عناه يومها المفكر الأميركي هو نهاية النسخة التقليدية- القديمة للعالم، بصفته محاوراً ومعسكرات وحروباً ساخنة وباردة...قد انتهى وحل مكانة التاريخ الأمريكي بصفته الدائمة التي ترتفع إلى مستوى القدر.
بعد العديد من المغامرات المكلفة التي قادها سادة العالم الجديد، بدءاً من حرب الخليج، مروراً باجتياح أفغانستان، ثم باحتلال العراق، وما رافق ذلك من نوبات جنون العظمة التي أصابت جورج بوش الابن والمحافظين الجديد الذين قادوا حقبته من خلال اعتماد فلسفة الحروب الاستباقية التي جرى تعمُّد تضخيمها وتزوير حيثياتها بحيث تتناسب والنوايا الانتقامية التي كانت مصممة على خوض مغامرات الحروب.
المقاييس التجارية للمصالح- حتى مصالح الدول- تقوم على احتساب الكلفة مع المردود، ومن خلال ذلك تتم الصفقة أو يصرف النظر عنها. ولأن الولايات المتحدة اعتبرت نفسها الوريثة الشرعية والوحيدة للحقبة السوفياتية كلها، فإنها بنت كل ما أعقب تفكك الاتحاد السوفياتي من مغامرات وفتوحات بمثابة الاستثمارات المؤجلة التي سوف تسهِّل عليها استباحة الأسواق وتحديد حصص كل دولة في هذا العالم، وبالطبع تكون هي الرابح الأول وبكل المقاييس.
لم تحسب إدارة بوش الابن ضريبة قيادة العالم وما ينبغي تقديمه من إثمان باهضة لحراسة "المصالح الحيوية" للولايات المتحدة فعصر العولمة بقدر ما هدد ورفع منسوب المخاطر على الكيانات الهشة والضعيفة، فانه وبقدر اكبر رفع منسوب الكلفة على الإدارة الأميركية دون مردود يذكر.
فانتقال العديد من الشركات العملاقة لأسواق اقل كلفة، والبذخ على الحروب دون تحقيق أية انتصارات تذكر، والاستغراق في مراكمة الدين الداخلي- في العام 213 بلغ الدين 16,7 تريليون دولار- وبالطبع الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ حوالي الخمس سنوات، والتي أول ما ظهرت بالخلل الفادح في ميزان أسعار العقارات والقروض المتعلقة بها والمقدرة بمئات المليارات ما أدى إلى انكشاف الولايات المتحدة على عجز لاقيامة قريبة لها منه في المستقبل المنظور، رغم وصول إنتاجها من النفط إلى الرقم التاريخي المحدد بثمانية ملايين برميل يوميًا.
ما سبق رافقه عجز تجاري على مستوى العالم، أسهم في حالة الجمود الدولية، وبالطبع أصاب الولايات المتحدة أكثر. مقابل ذلك اعتمد التنين الصيني طريقة السلحفاة في التمدد الهادئ إلى الأسواق العالمية وبأساليب تشجيعية لا تقاوم، بحيث تجاوز التأثير الاقتصادي الصيني حشر الولايات المتحدة، فوصل إلى أوروبا واليابان أيضا.
النجاح الصيني لا يعد طفرة عابرة على مستوى الاقتصاد العالمي، بل هو نتاج تخطيط ثابت حثيث. فالانفتاح على الرأسمالية اكسب الصينيين الخبرة والقدرة على امتلاك التقنيات الغربية دون أن يغامروا باشتراكيتهم وضبط مجتمعهم. فهموا أسواق العالم وبدأوا بإنتاج السلعة التي تتناسب والقدرة الشرائية لدى مختلف الشعوب، ناهيك عن عدم ربط الشعوب والدول بشروط تعجيزية أو ابتزازهم على الطريقة الأميركية-الأوروبية، بل أن حكومة الصين توفد الوزراء والمخلصين لديها لدعم وتطوير البنى التحتية وبإقامة المشاريع المنتجة وعلى أكثر من صعيد في أفريقيا وآسيا وسواهما. أضف إلى ذلك تميز السجل الصيني بنظافته من الغرق في مستنقعات القضايا المحلية والدولية من الصراعات، مما جعلها بمنأى عن توجس الدول وخوفهم من بناء العلاقات التجارية والاقتصادية معها رغم تطور أسطولها البحري ودخولها ساحة الفضاء من باب الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية ورغم المشاكل التاريخية على بعض الجزر مع الجارة اللدود-اليابان.
روسيا استطاعت وبثبات تجاوز عقد سقوط الحقبة السوفياتية فأعادت بناء الاقتصاد الروسي على مستويات الصناعة والتجارة والغاز. تم القضاء على الجسم الحيوي من المافيا التي كانت تؤثر عميقاً في مجريات النهوض الاقتصادي بما فيها الزراعي خاصة القمح.
فرحل ال"ك ج ب" التاريخي- بوتين- أعاد لروسيا هيبتها من خلال تثبيت مؤسسات الحكم وتطوير الصناعة خاصة العسكرية منها كما انه ومنذ انتهاء الحقبة السوفياتية لم تستدرج روسيا إلى مغامرة عسكرية خارج حدودها على الرغم من الملفات الكثيرة والمعقدة مع الدول المجاورة التي كانت منضوية إلى الاتحاد السابق.
الرئيس الروسي المتمسك بالدبلوماسية أسلوباً للحفاظ على المدى الحيوي لبلده دون السماح باختراق جدار الدول العازل ما بين روسيا وأوروبا، وعليه فإن هذه المهمة الشاقة والمعقدة كونها ترتبط بنوعية أنظمة الحكم التي تتولى إدارتها وبذات القدر بالموقف الأوروبي الساعي إلى توسيع الاتحاد شرقا ليشمل غالبية الدول المحيطة والقريبة من روسيا.
ولأن روسيا والصين تواجهان سويا الأولويات الأميركية والأوروبية على تخوم البلدين فان تحالفاً عضوياً بتنا نشهده بين العملاقين متمثلاً بتزاوج الترسانة العسكرية الروسية مع المجال الحيوي للاقتصاد الصيني ورغم طغيان الخطاب الدبلوماسي لكلا الدولتين إلا إنهما تحتفظان بالكثير من أوراق القوة للمرحلة القادمة.
الدبلوماسية الروسية الهادئة والمتماسكة هذه المرة فرضت نفسها على صعيد الاستجابة الأميركية التي ،وعلى ما يبدو، كانت بأمس الحاجة إليها خاصة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إحباط محاولاتها الخجولة لفرض حق استعمال القوة ضد النظام السوري بعد أدانته العام الماضي باستعمال الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع حددتها بعثة خاصة بالأمم المتحدة.
وهنا لابد من سؤال يتعلق بتسوية أميركية ضمنية مع الروس تراعي مصالحهما في المنطقة، واستطرادا في البر الروسي التاريخي فهل جرت التسوية بينهما؟
الوقائع التي أعقبت طرح مسألة معاقبة النظام السوري تشير إلى ذلك حقيقة، والتي أضيف إليها الاتفاق الإيراني مع الأمم المتحدة حول نسبة التخصيب وتفتيش المواقع الإيرانية يقابلها تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية والحصار والذي توج بالاتصال الأول لرئيس أميركي برئيس إيراني منذ العام 1979 على الرغم من الضغوط التي تعرض لها السيد اوباما من قبل متشددي الكونغرس الذين حاولوا إضافة عقوبات جديدة بطلب من إسرائيل التي لم يرقها موقف الإدارة الاوبامية من الإنفاق مع إيران.
تم وبطريقة بهلوانية الإقفال النهائي على مسألة استعمال السلاح الكيميائي، بما في ذلك المقاييس الأخلاقية التي تشددت من خلالها الولايات المتحدة في الترويج للضربة العسكرية فيما العراب الروسي البارع كان يصوغ الاتفاق الذي وافق عليه الجميع-أوروبا والولايات المتحدة- والذي ينص على تجريد سوريا من ترسانتها العسكرية مقابل صرف النظر عن التلويح بالعمل العسكري.
لكن الاتفاق الضمني بين روسيا والولايات المتحدة لم يتوقف عند هذا الحد خاصة إن لها حساباتها الخاصة التي لا تسمح بالتردد حيالها وتتلخص بالموقف المتشدد من الحركات الإسلامية المتطرفة.
هذا التطرف الذي لا ينحصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، بل يتعداها إلى آسيا والعديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة. فتجربة الشيشان الدموية لم تزل فاشلة في الذهن الاستراتيجي الروسي مضافا إليها قرب الحديقة الخلفية الروسية من أفغانستان وباكستان،حيث تتقاسم روسيا مع الصين التشدد والمخاوف أيضا.
الولايات المتحد بدأت تتحسس مخاطر ما يجري من عمليات دموية في العراق الذي تربطه علاقة استراتيجية متقاطعة بينها وبين إيران كذلك تم الطلب من دول في المنطقة بوقف تمويل المنظمات المتطرفة. فالمعارضة السورية المعتدلة والتي حاول الغرب التعويل عليها،لم تفشل فقط بالاستجابة لمتطلبات المرحلة، بل عجزت عن التوحد على برنامج سياسي- انتقالي وواقعي يستطيع إنتاج مسار سلمي لتسوية مع النظام. أضف إلى ذلك التمدد المخيف لقوى التطرف، حيث جبهتا النصرة وداعش المرتبطان بالقاعدة قد نجحتا في الاستيلاء على الجزء الأكبر من الجغرافيا التي كان يتحصن بها الجيش الحر، وباتتا تفرضان شريعتهما على السكان الخاضعين لحكمهما مناصبة العداء الحقيقي لقوى المعارضة والنظام في سوريا.
فغربي العراق يتواصل مع شرقي سوريا ويمثل المدى الحيوي لها بين الجبهتين، وبالتالي يمس بأمن واستقرار العراق وبذات القدر سوريا أيضا... لذلك ينظر الآن إلى "الجبهة الإسلامية" كمعيق حقيقي وخطر طويل الأمد يؤجج ويؤجل أية تسوية مفترضة، بما فيها مؤتمر جنيف 2 ولا مجال للقضاء على التطرف إلا بتظافر جهود أكثر من دولة قوية ومكتفية التجهيز واعتماد حرب حقيقة طويلة الأمد.
الواضح أن اتفاقاً ضمنياً يقوم على قناعة مشتركة روسية – أميركية حول عدم وجود البديل للنظام القائم في سوريا وان قوى التطرف تتعمد التنكيل بالمكون ألتعددي السوري لنسف أسس الوحدة والتعايش بين أطياف البلد الواحد، الأمر الذي يهدد مناعة وقدرة هذا البلد على البقاء، ناهيك عن نشر عدواه إلى الدول المجاورة التي غصت بأكثر من ستة ملايين لاجئ...لذلك نأسف من عدم وجود أفق للحل في المدى المنظور.
إذا التهديد للمصالح المشتركة الروسية- الأميركية قائم فعلاً، حيث أن حركة التبادل والإنتاج وازدهار الأسواق تحتاج استقراراً وثباتاً على المستويين الأمني والسياسي. فمخزون النفط والغاز الذي يرقد تحت مياه بحر لمنطقة لا يمكن استثماره إلا من خلال توافق الطرفين على بلورة آلية للكل تكون مقرونة بتفاهم مسبق على تقاسم الحصص والمجالات الاستثمارية والتسويقية.
ويبدو أيضا أن روسيا أعمق خبرة بالحركات الإسلامية من الولايات المتحدة كونها على تماس تاريخي ودائم معها. فهي قرأت متغيرات المنطقة بكثير من الحذر لدرجة أنها لم تبادر لحظة إلى إلقاء صنارتها نحو القوى الإسلامية التي تسلمت زمام الحكم في أكثر من بلد عربي، على عكس الولايات المتحدة التي بدأت ومنذ العام 2009 تنسيق صلاتها بحركة الإخوان المسلمين، بحجة وسطيتها وقدرتها على القيادة بأسلوب منفتح ومعتدل، وهي أي الحركة تستطيع تجفيف بؤر التطرف والإرهاب الناتجين عن قوى إسلامية محبطة وناقمة من خلال استيعابها ورد الاعتبار لقادتها ورجالها.
التجربة المصرية أظهرت بالملموس التقاطع العميق بين حركة الإخوان وقوى التطرف الأخرى. فالقوى"الجهادية" في مصر عملت ولم تزل بتنسيق وتكامل واضحين مع المجموعات الخاضعة للإخوان ناهيك عن فضح الصلة بين أيمن الظواهري والرئيس السابق لجمهورية مصر العربية.
الولايات المتحدة بنت استراتيجيتها في المنطقة على أساس أن السنوات العشرين القادمة اخوانية بامتياز، وان المشترك بينهما من الأفكار والمشاريع القائمة على اتفاقات ثنائية سوف يسهم في استقرار المنطقة ويخدم السياسة الأميركية تجاه ضبط الملف الغزي واستقطاب قوى المقاومة وتثبيت حالة وئام طويلة الأمد مع إسرائيل إضافة إلى الدفع باتجاه توسيع الشريط الغزي لكي يصل إلى تخوم ومدينة العريش كخطة نهائية لحل القضية الفلسطينية.
أصاب الإخفاق الولايات المتحدة في نقطتين:1- عجز بنيوي في حركة الإخوان لجهة الاعتدال واحترام القوانين والديمقراطية التي اتوا بموجبها، وعجز آخر أعمق، فبدل أن يتجه الإخوان الى ترويض الحركات المتشددة نراهم ذهبوا باتجاه تلك الحركات وبدل أن يعملوا على تبييض سجلهم لكي يعودوا حركة معترف بها، آثروا الانتحار الجماعي وباتوا حركة إرهابية بنظر القانون المصري.
خلال زيارة وزير الخارجية الأميركية الأخيرة إلى مصر، ظهر تباين واضح في موقفي الرئاسة والخارجية. فالناطقة باسم الرئاسة لم تزل تعتبر الرئيس السابق "محمد مرسي" رئيساً منتخباً تطالب بإطلاق صراحة والعودة عن الانقلاب، فيما الوزير جون كيري حمل الإخوان مسؤولية ما جرى وبالتالي فان إطاحة مرسي وما تبعها من عمل على خارطة طريق تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئيسية أعمال تكفي لطمأنة العالم بأن الديمقراطية في مصر لم تزل بخير.
وزير الخارجية الروسي الذي زار مصر برفقة عدد من الوزراء في الحكومة اكتفى باستطلاع الأجواء المصرية الداخلية، وكان حذراً من إثارة حساسية الإدارة الأميركية رغم وصف الزيارة بالتاريخية.
لم ينتهز الوزير الروسي فرصة الخلل في العلاقات المصرية – الأميركية لكي يعيد الصلة بالساحة المصرية كما كانت قبلاً بل اكتفى بالموافقة على دراسة حاجة السوق المصرية للقمح إضافة إلى بيع الجيش المصري معدات عسكرية تقليدية – كقطع السلاح والذخيرة مما يدل على وجود مجال واسع من المرونة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
الملفان الكيميائي السوري والنووي الإيراني كانا يقضا مضاجع إسرائيل وبعض دول المنطقة التي على خلاف مع الجمهورية الإسلامية.
على الرغم من تعمد الحكومة الإسرائيلية الإثارة الدائمة لمسألة خطورة إنتاج إيران للسلاح النووي إلا أن تلك المحاولات لم تعد تلقى استجابة الإدارة الأميركية والأوروبية نظراً لانكشاف أسبابها السياسية في تحديد مسألة التسوية مع الفلسطينيين مما يعني استمرار تلاعبها بالأولويات لكي تمنح الاستيطان مساحة الوقت الكافية لتبديد معالم الأرض المفترض قيام الدولة الفلسطينية فوقها.
خلاصة:
نجح اوباما في إخراج الولايات المتحدة من سلسلة المغامرات التي قادها بوش الابن وعصابة المحافظين الجدد وبالتالي وفق في لجم الدور الخفي الذي كانت تلعبه شركات السلاح ومن ورائها العديد من المستثمرين في الإدارة السياسية للبلاد بحيث أصبح الانكفاء العسكري والسياسي أيضاً نوعاً من إجازة لالتقاط الأنفاس ولإعادة صياغة جديدة لعلاقة أميركا بالعالم.
مصافحة اوباما للرئيس الكوبي خلال جنازة الراحل نيلسون مانديلا تشير إلى قفزة نوعية في مسار البراغماتية الأميركية...نعم في السياسة لا صداقة دائمة وأيضاً لا عداوة دائمة حتى أن نشر الدرع الصاروخية في أوروبا لم يقصد منه تحدي الروس بقدر ما قصد إثبات الوجود وطمأنة الأصدقاء. حتى لو تعلق الأمر بالسباق الروسي- الأوروبي لاستقطاب عدد من دول الحقبة السوفياتية.
لكن الاستعصاء المزمن في المنطقة، والمتعلق بتسوية سلمية للصراع في فلسطين وحولها، لم يزل رهينة سياسة التفرد الأميركي، مقرونة بسلبية إسرائيلية حاسمة تجاه رفض الانصياع لمقتضيات السلام العادل والشامل.
الواقع يشير إلى غياب الأفق القائم على مسعى دولي جدي وحثيث تجاه حل القضية الفلسطينية. فالمساعي الحالية التي تخوضها الخارجية الأميركية لم يتمخض عنها ما يشرِّع أبواب الآمال، فيما جرائم الاستيطان تهضم ما تبقى من أرض الوعد الفلسطيني.









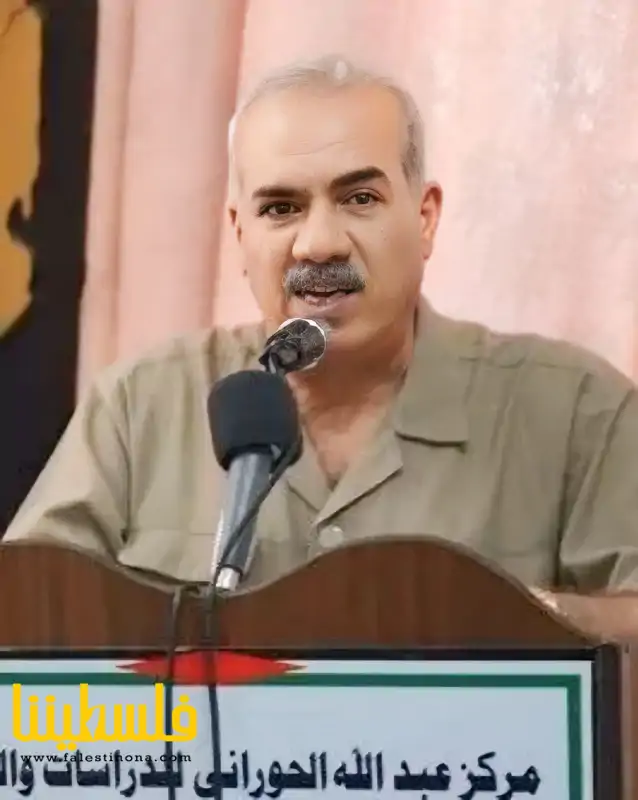






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها