بقلم محمد اسعد
يكون الانتماء،عرفاً، للوطن كونه مسقط الرأس والجامع لشعب يجمعك به مصير ومصالح مشتركة ولغة مشتركة وتاريخ مشترك.
ويمتد هذا الانتماء لكل من يشاركك المصير والتاريخ واللغة والمصالح والمستقبل، أي يشمل الانتماء للوطن الكبير، رغم تقسيمه إلى أوطان ودويلات وكيانات متعددة ومختلفة أحياناً، ذلك هو الوطن العربي من محيطه إلى خليجه. هكذا ربينا منذ طفولتنا. حفظنا خارطة الوطن الكبير دون أن نتعرف إلى أرضه وعادات شعبه، جمعنا الانتماء واللغة والمصالح، والتربية القومية التي كانت سائدة منذ أجدادنا وعملاً بالقول: أحب أبنائي صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يحضر، كان الميل إلى فلسطين، جرح الحكاية في الطفولة وألم الأحاسيس في مرحلة الشباب ووجع الزمن والعجز في سن متقدمة. وتعود معرفتي بالفلسطينيين في سن مبكرة، فأنا ولدت مع النكبة، وطفولتي في قريةٍ صغيرةٍ من قرى جبل عامل لجأ إليها عدد من العائلات الفلسطينية، وكان بعضها من الجليل حيث التزاوج كان قد حصل قبل اللجوء. وطبيعة القرى، وسهرات المواقد، تفتح سجلات الحكايا، كل الحكايا تدور حول الجرح الحاصل إذ الدم لم يجف بعد، والطفل يحفظ ما يسمع وتحفر في ذاكرته المآسي وما واجهت هذه العائلات من ظلم العصابات المسلحة، كما تشمل تلك الحكايا وصفاً للقرى وطبيعتها وبياراتها وبساتينها والمقامات المقدسة التي لا تبعد كثيراً عنها.
كل هذه المقدمات شكلت لدي الهاجس لرؤية الأرض والانتقام ممن سبب هذه الآلام وشرد هؤلاء الأطفال أترابي وحوّلهم من حلم السعادة في الوطن إلى بؤس اللجوء.
اذكر إنني ذهبت بصحبة والدتي لزيارة أقرباء في يارون الحدودية وذهبت مع أحد الأقرباء (يكبرني بسنتين أو ثلاث) إلى مكان مرتفع اعتقد انه حاووز الماء للقرية حيث رأيت بعض ارض فلسطين وبعض القرى المغتصبة، ومزارعين يحتلونها والنساء تلبس لباساً غريباً قال قريبي أنه لباس يهودٍ يمنيين.
تمر سنوات من العمر نكبر ويكبر الحزن والغضب والشعور بالعجز لفتى لا بعرف كيف يترجم غضبه إلى فعلٍ يهدئ الغضب، وانتقلت مع والدي إلى بيروت عام 1958، لم تمض أشهر حتى تعرفت إلى حركة القوميين العرب وكنت في الحادية عشرة من عمري، ضموني إلى حلقة تثقيفية وقراءة كتاب لمحسن إبراهيم وهاني الهندي حول فلسطين والحركة الصهيونية ونشوء العصابات أمثال الهاغانا وغيرها.
اشتريت كتاباً بعنوان شعراء الأرض المحتلة لم أعد أذكر اسم جامعه لكن اعتقد انه من آل الخطيب ورحت أحفظ شعر محمود دروش وسميح القاسم وتوفيق زياد وذلك ألهب العاطفة والحماس حتى غدا الكتاب أيقونتي الخاصة.
وشعاري: أهون ألف مرة أن تُدخِلوا الفيل بثقب ابرة من أن تُميتوا وميض فكرة.
أذن لابدّ من ترسيخ الأفكار وصقل الذات والعمل على ترجمة الغضب إلى فعل منهج، قائم على فهم أعمق للعدو وكيفية مواجهته.
قرأت ساطع الحصري وقسطنطين زريق وأشعار فدوى وإبراهيم طوقان وناقشت أحزاباً تنادي بتحرير فلسطين لكنها تعمل على خلاف ذلك ويريد كل منها إن يلغي الآخر ويحتكر النضال ويعتبر أن الآخرين على خطأ ترددت إلى النادي الثقافي العربي في الحمرا تعرفت إلى جوزيف مغيزل مفكر أعجبني، متحمس للقضية، زرع في نفسي حبها ورسَّخ قناعاتي وبدأت أشارك في كل المناسبات.
ذكرى النكبة... وعد بلفور...واستمع إلى الكثير من الخطب الحماسية.
التي تملأ وجد خطبائها باللون الأحمر ويعلو صوته من الحماسة، لكن بعد خروجنا من القاعات (عادة قاعات سينما مستأجرة لتلك المناسبات) انظر حولي فلا أجدني أحفظ كلمة من تلك الخطب الرنانة...أو أجد لها معادلة على طريق التحرير .. فقط مزايدات وتسجيل مواقف.
انتقلت سنة 1965 إلى حركة ثقافية اسمها لبنان الاشتراكي.
وكنت قبل تخرجي من دار المعلمين في بئر حسن، وهي حركة ماركسية، أدهشتني بكتاباتها وزادت قناعتي عندما أصدرت نشرة عامة اسمها طريق الشعب تنظر فيها لتحرير فلسطين بدءاً من إصبع الجليل. راقت لي الفكرة خاصة حين انظر إلى تلك الإصبع على الخارطة المتداخلة بين ثلاث كيانات، لبنان وسوريا والأردن والقريبة من الضفة...وأسال نفسي ما أسهل تحرير هذا القسم!!
إذا ما هوجم من الدول الثلاث وسجلت تلك الدول أول علامات التحرير عندها ستلتهب مشاعر الناس المتشوقة إلى هزيمة إسرائيل وسترفد المهاجمين والكل يتشوق إلى القائد الشجاع الذي يجمع هؤلاء في خطة مدروسة والأمر سهل..سهل جداً... تلك نظرية عاشت معي ردحاً من الزمن ابثها بين معارفي وأعمل على تأطير الأصدقاء حولها. وكانت خيبات الأمل عديدة حين يضحك كثيرون من طفولتي ويسمونها طفولة يسارية.
وأنا مصرُّ على أنها بداية عمل ناجح..
تخرجت وانتقلت إلى الجنوب،عينت في جويا، رحت أبث الحماس بين طلابي عبر أشعار الأرض المحتلة وأعمل على خلق مجموعات تؤمن بما أؤمن وتعمل لما أعمل من اجله وما زال فريق من هؤلاء الطلاب البررة يحملون تلك الأفكار وشاركوا في كثير من النضالات وبعضهم الآن يعمل في تنظيمات وجهتها فلسطين...
زارني، ذات مساء في البيت الذي كنت استأجره كمعلم واستقبل فيه طلابي ومن يثق بي، صديق فلسطيني اسمه احمد كانت تربطني به صداقة دون أن اعرف انتماءه اعتقد انه لا يعرف عملي... وعرض عليَّ أن يعرفني إلى مناضل فلسطيني من الفدائيين...
كانت سمعة الفدائيين كسمعة الأنبياء..أعمالهم بطولية... تحاك حولها القصص التي تلامس الخرافة... سحناتهم الغاضبة.. ترعب الأعداء لمجرد ذكر صفة الفدائيين ..وكأنهم أناس من كوكب آخر.. تركوا كوكبهم...وامتشقوا السلاح.. تركوا بهرج الدنيا حملوا أرواحهم على كفوفهم يفتدون بها الأرض.. وجهتهم فلسطين يزرعون فيها دماءهم فتنبت زهور الأمل ويطوون المسافات. يختصرون الزمن...
رحبت بالفكرة بحماس وجاءني في اليوم التالي وكنت قد اعتذرت من جميع من يتردد إلى سكني..
حضر الرجلان احمد الذي اعرفه ومعه رجل نحيل مدني عليه هيبة الرجال ودماثة الأطفال وتواضع القديسين .. قدمه صديقي إليّ: الحاج طلال من حركة فتح فدائي ممن تسمع عنهم ولا تعرفهم.
تلعثمت في اللقاء الأول...وأصابتني الحيرة ... فالفدائيون ليسوا على هذه الصورة وقد رسم صورهم في مخيلتي أقوياء بيدهم السلاح وهذا مدني لا يحمل سلاحاً.
لكن الحقيقة أن تلك الزيارة شكلت انعطافاً حاداً في حياتي السياسية. ورحت أنهل من حديثه تعابير جديدة وأفكاراً منيرة وزرع بي الشوق إلى أسماء كانت تمر بحديثة وأصر عليه أن ألتقي بها ولكنه لم يكن متسرعاً.. ولا بخيلاً لا يجيب الطلب..
حين أَنِس مني تقبلي فكرة الكفاح المسلح.. وأن أطروحة إصبع الجليل التي تلوتها على مسامعه يجب التخطيط لها ودرس الأولويات..
وتلا على مسامعي مقولة فتح بالدوائر الثلاث، الوجود الاستراتيجي الدفاع الاستراتيجي. والهجوم الاستراتيجي. شعرت بضآلة معرفتي وبطولتي اليسارية. وإصراري على معرفة المزيد..
لا أدري ما كان قصده حين أرشدني إلى مغارة الهبارية. حيث شاهدت ولمرة واحدة ذلك الهرم الكبير أبا علي إياد.. وعرفت لأول مرة صورة الفدائي الذي رسمت ملامحه في مخيلتي.. وكانت تلك المغارة على مشارف إصبع الجليل ومن كفر حمام وكفر شوبا أرى مساحاتٍ أكبر وأوسع من الأرض التي أحببتها.
أعترف أن هيبة أبي علي إياد أرهبتني وشعرت أنني ذلك الصغير الصغير أمام هذه القامة الجبارة القوية الصارمة. ابتسامته كابتسامة الأسود التي تصورها أشعار العرب.
ظل خياله في ذهني وعندما وصلني خبر استشهاده في الأردن كان وبقي يحيا في عقلي ووجداني.
وكرت المسبحة فتعرفت إلى القيادات وعلى رأسها القائد العام الذي كنت أتباهى إذا ما رافقته في سيارته الصغيرة الشديدة التواضع ولتلك حكايات لا يتسع لها المجال.
وتجذرت علاقتي بحركة فتح. رافقتها في ياطر ومجدل سلم أو في إطلالاتها العلنية على الأرض اللبنانية. ساندت دورياتها وعملياتها ورافقت كثيراً منها حتى ملامسة الأرض الطيبة، ولا أدعي أنني شاركت في عملياتها النضالية. لكنني عشت مع مجاهديها في القواعد وتقاسمنا الطعام من وعاء واحد. وافترشنا الأرض وواجهنا الصقيع معاً. وعرفنا زيتون الجنوب في مختلف قراه.. ووطأت أقدامنا وهاده ووديانه وجباله وصار قندول الجنوب وبلانه يعرف طعم أجسادنا. تلك علاقة استمرت سنين.. كانت جميلة على صعوبتها.. وكان الختيار يردد أن هذه الثورة اعقد ثورات العالم وأصعبها، إذا كانت لن تنجح فهي على الأقل ستلد من ينجح ويكمل المسيرة.. هذه ثورة عملت على صهر المخيمات والشعب الفلسطيني مع غيره من الشعوب العربية ووحدت الهدف بعد أن عملت تربية الدول المضيفة على تشتيت الفكر وأضاعت وسائل الوحدة.
لاحظ يا أخي كيف حققت فتح حلم العرب بالوحدة إذ ألغت الحدود وإن لفترة ذلك أن أمر المهمة الصادر عن قيادة الحركة كان بمثابة جواز السفر الذي يتخطى الحدود على كل اشكالياتها وأشكالها دون تأشيرات ومشاكسات، كان يشعر من يحمل هذه الورقة أنه عربي فتحت له الحدود وزالت أمامه العوائق، ليس عبر خطوط عسكرية كما أطلق على سواها فيما بعد، بل عبر الخطوط المعتمدة والمعروفة من الجميع، لاحظ يا أخي كيف أن التجارة بنا دفعت الأنظمة لإنشاء فصائل بمراسيم جمهورية أو ملكية أو ما شابه للإبقاء على تفتيت الجهود أو لوضع إصبعهم بأن لهم نصيب في الجهاد.
تبقى ذكريات الزمن ساطعة بنبلها وصدقها والعمل المدفوع بالعقيدة والحماس (استغفر الله من هذه اللفظة حمالة الأوجه).. تبقى الذكريات تتعلمها أجيالنا والسائرون نحو ارض القداسة فيحاسبون أجيالنا على أخطائها ويصححون المسيرة إذ يتحاشون ما وقعنا به من أخطاء ويعملون بأكثر مما يقولون ويتذكرون ذلك الخليفة الذي قال: الجواب ما ترى لا ما تسمع. ويعدون ما استطاعوا من القوة بحيث يردعون العدو ولا يكتفون برعبه.
هذا فصل من مسيرة أوقفها كبر السن وغربة الرعيل فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.









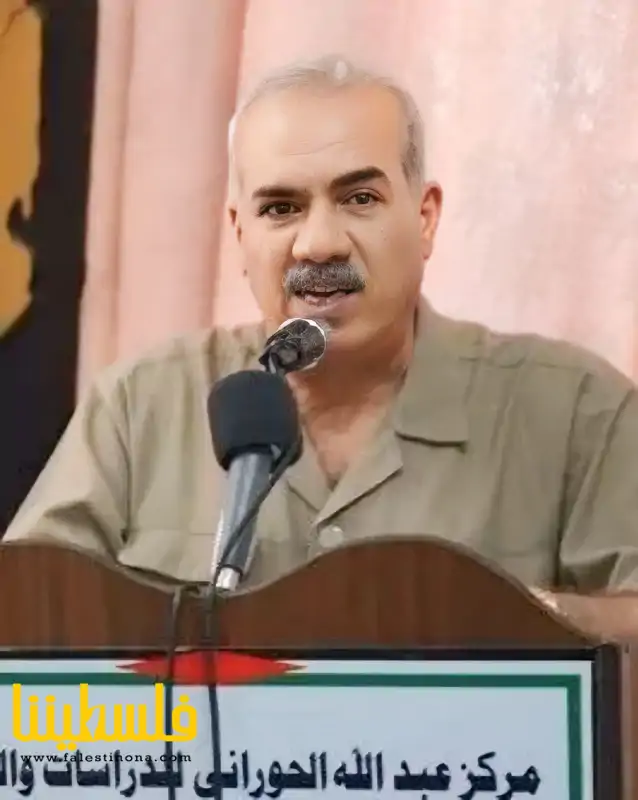






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها