منذ بدايات القرن الماضي، وإلى اليوم، لم تزل الأرض الفلسطينية تخضع لأبشع استعمار استيطاني شهده التاريخ الحديث.
فمنذ مراحله الأولى نهض هذا الاستعمار على قائمتين مركزيتين: الأولى تمثلت بالتجربة اليهودية القاسية في أوروبا، ومشكلة الصراع اليهودي نفسه بين ثقافتي الاندماج والغيتو، وذلك وفق خارطة التمييز المريرة التي مورست بحق اليهود على مدى عقود طويلة، تُوِّجت أخيراً بما سمي الهولوكوست المحرقة على يد النازية الألمانية.
القائمة الثانية تمثلت بالاتحاد بين قوى العلمانية والايديولوجيا، ونجاحهما في انتزاع تمثيل الديانة اليهودية، من خلال كونها المؤسسة المنظمة على المستويات الثقافية- السياسية- الاقتصادية، وذات النفوذ الكبير بين المنظمات والدول.
حتى الآن لم نزل نعيش حالة المشروع الصهيوني الأولى. ولئن تبدلت موازين القوى الداخلية، من خلال انتعاش قوى الايديولوجيا وقبضها على القرار السياسي في إسرائيل، مترافقاً مع جنوح قوى علمانية خرجت من النسخة الأصلية لحزب العمل وأخرى خرجت من الليكود إضافة إلى قوة مستجدة- إسرائيل بيتنا- وغيرهم، نحو كونها تعبير ايديولوجي- يقوم على العنصرية ونفي حق الآخر الفلسطيني- وفق منهجية سياسية تتلاقى على مفهوم الهوية والولاء، وبالتالي تكريس الايديولوجيا الصهيونية بصفتها الأساس الذي تقوم عليه القوانين والسلطات في إسرائيل، مما يحتم طغيان سياسة الصراع بوجه أي مسعى للسلام وفق منظور دولتين لشعبين.
هذه القوى التي تلخص مركز القرار الحالي تنفي إمكانية التسوية ببعدها الثنائي أو الدولي مع الفلسطينيين، كون المشروع الصهيوني القائم على السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية لا يحتمل المغامرة والمخاطرة. وكون دعاة هذا المشروع بشَّروا ولم يزالوا يبشِّرون بحتمية أبدية صراعهم مع الآخر، أياً يكن، وبأن أية اتفاقات تتم معه- الآخر- لا تلغي تلك الحتمية. إضافة إلى ذلك يرى هؤلاء أن مركز أرض إسرائيل التوراتية هو الضفة الغربية والقدس، ولأنه لا إمكانية لضرب الأساس العقائدي للنظرية الصهيونية، لا إمكانية بالتالي للتخلي عن الجزء الذي يقوم عليه هذا الأساس.
وبناء على ما تقدم فإنه من المستبعد توقُّع صدور قرار إسرائيلي هادف وصريح للقبول بمفاوضات تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على أي جزء من الضفة الغربية. على الأقل في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية السائدة، وعليه أيضاً سوف تستمر الجرائم التي ينتجها عدوان إسرائيل اليومي على شعب فلسطين وحقوقه الوطنية والخاصة، وهو ما يحتِّم أن يبقى هذا الكيان متنعماً بالحماية والرعاية، وبعيداً عن أية مساءلة أو ملاحقة.
وإذا كان الغرب عامة يكفِّر عن خطاياه التاريخية التي ارتكبت بحق اليهود- والتي اختتمت بما سمّي الهولوكوست- خلال الحرب الكونية الثانية، فإن ذلك لا يعكس يقظة روحية خالصة بقدر ما يعبِّر عن فاعلية زرع جرثومة حيَّة وفتاكة في جسم يراد له أن يتلهى بالضرر الناتج عنها، مع فارق أن الجرثومة هي التي تحظى بالرعاية والحماية والدعم
اللامحدود، نظراً لاستراتيجية دورها في الانخراط في حماية مصالح الولايات المتحدة- الوريثة الحالية لإمبراطوريات الغرب البائدة، إضافة إلى مركزية إسرائيل في الحضور كثابتة مقدسة في الوجدانين الرسمي والشعبي الأميركي، نقية ونظيفة، بل وضحية عدوان وكراهية تحيطان بها من جهات خارطة وجودها.
بالمقابل شكَّل الوضع العربي منذ بدايات استقلال الكيانات العربية منتصف أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن، المادة النموذجية لطغيان وترسيخ المشروع الصهيوني على الأرض العربية. بدءاً من صراع المعسكرات، إلى صراع الثقافات والحزبيات، إلى الانقلابات والتوترات وسوء العلاقات القطرية. إلى تهميشهم التنمية والتطور العلمي- الاقتصادي- والمؤسساتي، إلى تغييب عميق للديمقراطية والمساءلة والعدالة الاجتماعية.
رافق ذلك وجود إسرائيل كنموذج عربي للحكم وتداول السلطة، وفي ترسيخ دعائم التطور على مختلف المستويات، مما أكسبها ثقة تضاف إلى الأسباب الآنفة الذكر في دعمها، مقارنة مع الواقع العربي المهترئ.
معادلتان بسيطتان أمامنا: المستوطنون صعدوا سلم التصنيف، من زعران تلال، إلى عاصين وخارجين على القانون، إلى حالة يجب معالجتها، إلى واقع لا يمكن تغييره، إلى رأي يكتسح الجمهور والحكومة في إسرائيل.
المقاومة، نزلت من سُلَّم التصنيف- أعني دولياً- ومع أنها تتمتع بالأبعاد الشرعية والقانونية الدولية والعرفية كافة، نزلت من فدائيين، وحركة تحرر وطني، وحق تقرير المصير، وحق النضال بكل الأساليب، إلى تعريف وقح هو كلمة إرهابيين الجديد الذي طرأ على العالم هو ثورة تكنولوجيا الاتصالات، التي صممت أسساً لهدفي التجارة وسرعة القيادة والسيطرة على العالم، ومع أنه لا يصلنا منها الحساس والشديد التطور إلا أن منطقتنا، كغيرها من مناطق التوتر والصراع في العالم استطاعت الخروج بإنجازات لا يمكن تجاهل نسبتيها، على صعيد مواكبة الحدث والتأثير بالرأي العام على امتداد الكرة الأرضية.
وقد نستطيع المجازفة بالاعتراف أن ثمة إنجازات ميدانية اخترقت العقل الصهيوني وأعطيت بعض معنوياته، حين أصبح سلوكه الإجرامي تحت أعين العالم، وبالتالي فتحت جرائمه الكثيرة والمدعَّمة بالحقائق المهنية نافذة للعدالة- أي لبعض المؤسسات القانونية الدولية. فهناك شواهد دافعة عن التعرض المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية التي تؤمِّن لهم الاستمرار، مما أدى إلى حصول سجل قانوني في الأمم المتحدة، خاصة في الجمعية العامة ومجلسها لحقوق الإنسان حول الارتكابات الإسرائيلية خلال عملية الرصاص المصبوب أواخر عام 2008.
الناجح الأكبر في تسليط الضوء على العملية الإسرائيلية هو الإعلام بكل تقنياته وأدواته، نظراً لتفاعله المباشر مع الحدث، والناجح الثاني هو الدبلوماسية الفلسطينية- العربية وبعض الدولية في فرض لجنة للتحقيق، وبالتالي للخروج بخلاصات يتمخَّض عنها مسؤوليات، فيما رفضتها إسرائيل، مكتفية وبعد سجال طويل، باستعدادها لتشكيل لجنة خاصة من رجال قانونها للتحقيق.
في التقرير الذي خرجت به اللجنة- والذي سمي باسم رئيسها القاضي الجنوب افريقي غولدستون- تمت مساواة الضحية بالجلاد. لكن مجرد وجود هكذا معادلة- أي اتهام جيش "الدفاع" الإسرائيلي مناصفة مع قوى المقاومة الفلسطينية باستهداف المدنيين- فإن ذلك بنظر إسرائيل يعتبر نكسة كبرى لها على المستويات السياسية والأخلاقية والقانونية، ولا يضيف أية أعباء على الطرف الآخر، كونه مدانا سلفاً من قبل منظومة القرار الدولي. إضافة إلى ذلك ترى إسرائيل أنَّ مضمون التقرير يقيِّد سلوك جيشها في التعامل مع أهدافه العدوانية خلال النزاع المسلح، ويضعها، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة- على مشرحة مشروعية وجودها وحقها في التصرف، لأنها تدرك جيداً وتيرة البند الدولي الذي كانت ستواجهه لولا الاحتضان الأميركي المدعَّم بالفيتو والضغط على دول مجلس الأمن الدولي مجتمعة.
ورغم أنَّ مفعول التقرير لم يرق إلى مستوى السير باتجاه آليات تحقيق العدالة الدولية- لأسباب سياسية مرتبطة بموازين قوى ونفوذ، إلاّ أن له مفعول الإدانة التي لا يستطيع أحد دحضها وإلغاءها. حتى أن تراجع القاضي غولدستون عن مضمون التقرير لا يغير في المعادلة شيئاً، بل يجدد الأضواء على تلك الحقبة ،ويعاكس أمنيات المسؤولين الإسرائيليين، نظراً لاقترانه بالأخبار التي سربت عن المضايقات والتهديدات التي تلقاها غولدستون وعائلته، وحالة الكراهية والنبذ التي يعانيها في كل من جوهانسبرغ ونيويورك، ويعيد إلى الذاكرة جزئية مضمون التقرير، مقارنة مع وقائع أقسى وأعم، لا يمكن لغولدستون وغيره التنصل من حقيقتها.
إضافة إلى ذلك فإنَّ القاضي غولدستون هو فرد من لجنة- حتى لو كان رئيسها، وأنَّ الحيثيات الميدانية التي سجلت خلال عملية التحقيق ليست هي السبب الذي أدى إلى تراجعه عن قناعاته السابقة، رغم الترحيب الجماعي للحكومة الإسرائيلية والنخب السياسية والإعلامية، ودعوته لزيارة إسرائيل، وثم المطالبة بسحب التقرير من أدراج الجمعية العامة للأمم المتحدة. وترافق ذلك مع حملة شعواء على لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة، واتهامها بالتحيز لصالح الفلسطينيين والعداء الدائم لإسرائيل.
القيادة الفلسطينية عبَّرت عن عدم قدرة غولدستون والسلطات الإسرائيلية على التلاعب بمضمون التقرير أو سحبه وإلغائه، وبالتالي طالبت الأمم المتحدة باتخاذ التدابير القانونية التي ترتكز على مضمون التقرير، فيما الجامعة العربية تبنت الموقف الفلسطيني وحذرت من التلاعب به.
اللافت هنا أن الرئيس الفلسطيني وقيادة م.ت.ف كانوا ولا يزالون يتعاملون بجدية مع مقتضيات التقرير ويبذلون الجهود الجبارة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تحقيق إدانة واضحة لإسرائيل، تليها خطوة ثانية باتجاه اتخاذ المقتضى القانوني لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، مما سيتيح المجال مستقبلاً للجم خياراتها وأعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
بالمقابل لم يكن تقرير غولدستون مناسبة لإدانة إسرائيل وملاحقتها في المحافل القانونية والسياسية أولوية لدى حكومة حماس، بل تعاملت مع المناخ الذي واكبه بانتهازية ودناءة، إذ رأت فيه مناسبة لضخ السموم والتجني على السلطة الوطنية وشخص الرئيس محمود عباس، الذي كان يمهد لوضع مثالي لنجاح طرح التقرير على الأمم المتحدة.
وبدل أن يوحد الجهود والإرادة السياسية الفلسطينية لصالح تفعيل الموقف الفلسطيني اختارت حماس، مدعومة ومدفوعة من دول وقوى ومنابر إعلامية إقليمية إلى اختلاق خطاب انقسامي- تخويني، وتعمدت تشويش الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية، دون أن تدرك الظروف التي ينبغي عليها التمييز بين أولويات الصراع وثانوياته، فيما بدا للمراقب المدقق أن صراع حماس في محطات مرحلة ما بعد انقلابها في حزيران 2007 وحتى الآن، هو مع الشرعية الفلسطينية دون سواها.
فهي لا تقاوم وتقمع المقاومين وتهادن العدو من طرف واحد. وورثت البيروقراطية التي راجت على أساس رسوخ مصالح الطبقة السياسية- الاقتصادية المستجدة في قطاع غزة، فيما أجهزتها أدمنت على مطاردة مناضلي حركة فتح والقوى الوطنية الفلسطينية. ومن خلال هذا النفس المتدني، الذي يقود إلى تجهيل الذاكرة الفلسطينية طغى على واجهة الأحداث الفلسطينية حدثان بشعان، نفذتهما أيد نجحت القيادة الفلسطينية بمنحهما صفة الخيانة العظمى، كونها طالت رمزين في النضال ضد الصهيونية واستيطانها وجرائمها، وكونها تؤدي إلى إحباط ومن ثم إبعاد المتضامنين الدوليين عن الأرض الفلسطينية، ليس فقط لأنهم يسهمون في تخفيف منسوب العنف الذي تمارسه آلة العدو العسكرية، وليس فقط لأنهم يفعلون النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال، بل لأنهم شاهد حي وفاعل على معاناة شعب فلسطين، ينقلون هذه الصورة كعار يلاحق العدو وصورته في العالم.
إن اغتيال المناضلين- مخرج وطبيب- عمل أحطُّ من الجبن والقذارة، ويخدم بقوة المناخ الساعي لسحب تقرير غولدستون، وبذات القدر يظهر الصورة السلبية والسوداء لشعب لم يبخل يوماً في دفع الغالي والرخيص في سبيل حريته واستقلاله.
إنَّ مجرد وجود هكذا نوع من القتلة بين صفوف الشعب الفلسطيني هو وصمة على جبين شعب العطاء والتضحية. المسؤول عن وجود هذا النموذج المنحط هو حالة عدوى أيديولوجية تحاول التشابه بنموذج الأيديولوجيين الصهاينة، وهم ينبتون كالجرب في الجلد الفلسطيني بسبب وجود حاضنة سياسية- ثقافية لهم، تتمثل بالخطاب البدائي لدى حماس وبعض رجال الدين داخلها، وبذات القدر تمنحهم حالة الانقسام والتباعد بين أبناء الشعب والمصيبة الواحدة بيئة وجود مناسبة.
المشروع الصهيوني لم يزل في نسخته الأصلية. فهل نتوحد، ثم نرتفع إلى مستوى اشتقاق حالة مواجهة توازي المخاطر المحدقة؟ هل ننجح في سد الثغرات التي تتحول دون تكرار عبث أهل السوء بصورة الشعب الفلسطيني العظيم؟









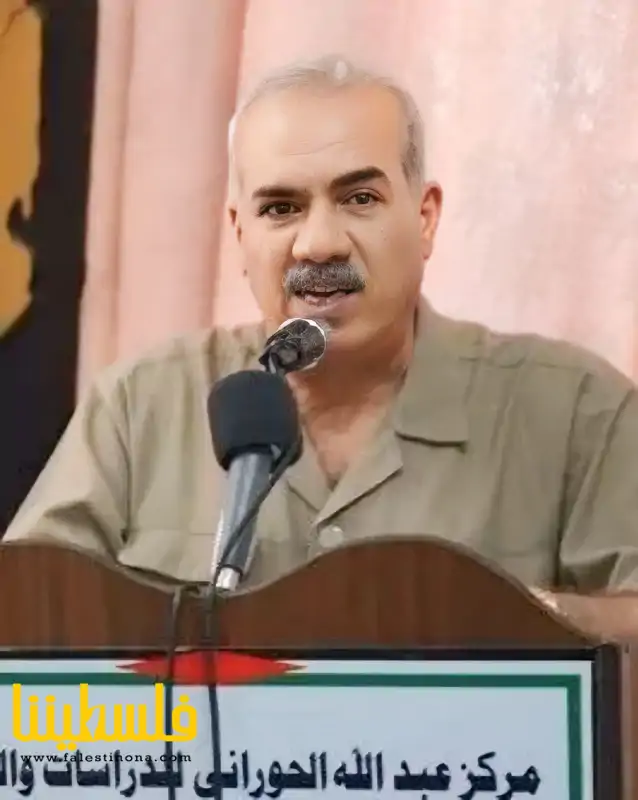






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها