أثار إنتباهي التعقيب الروسي على الذكرى الثلاثين لتوقيع إتفاقيات أوسلو (13 أيلول/ سبتمبر 1993). وهو رد موضوعي، كنت أتمنى أن تكون ردودنا بالطريقة نفسها بعيدًا عن الخطاب الشعبوي، الذي يخلط الطين بالعجين، مستغلاً ما يعانيه الفلسطيني من إحباط جراء عدم تمكنه من تحقيق أي من أهدافه الأساسية، والجهل في تاريخ نشأة القضية الفلسطينية وتطورها عبر اكثر من قرن من الزمان، وعدم الإلمام بما يكفي بالصهيونية ومشروعها وطبيعة الدعم الذي تتلقاه، وأي معالجة بالضرورة أن تفصل بين الإتفاق بحد ذاته والظروف التي جاءت به، وبين الأسباب التي أدت إلى فشله بالطريقة الكارثية التي وصلنا إليها بعد ثلاثة عقود.
ولكي يكون الأمر مفهومًا أكثر يمكن تلخيص التعقيب الروسي كالتالي: إتفاقيات أوسلو فتحت آفاقًا لسلام فلسطيني إسرائيلي، ولكن إنهيار الأفق والأمل بسب الفوضى التي خلفها تفرد الولايات المتحدة الأميركية في رعاية مفاوضات عملية السلام، فالتعقيب الروسي حمل واشنطن مسؤولية الفشل، وميز بين الاتفاق بحد ذاته وبين النتائج والأسباب التي أدت إلى إنهياره والوصول إلى طريق مسدود، بل أكثر من ذلك كيف تم تدمير أوسلو من قبل إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.
والآن نعود للإتفاق، فكما هو معلوم فإن أي إتفاق هو ابن ظروفه، ويكون في العادة انعكاسًا لميزان القوى، ومفهوم ميزان القوى مفهوم معقد بعض الشيء، فهو لا يقتصر فقط على ميزان القوة العسكرية أو الاقتصادية، ففي أحيان كثيرة يلعب الواقع الجيوسياسي، والنظام الدولي دورًا مؤثرًا في هذا المفهوم.
فأوسلو هو باختصار ابن لحظته التاريخية بكل ما فيها من تفاصيل واعتبارات، وهو في الواقع فصل آخر للصراع وليس معاهدة سلام مكتملة الأركان تغلق جميع الادعاءات والمطالبات.
ولا يمكن فهم الاتفاقية إلا في ضوء طبيعة الصراع، وبشكل أدق طبيعة الصهيونية ومشروعها التوسعي، ونظرتها للشعب الفلسطيني، ونفيها لوجوده كشعب يمتلك الحق بتقرير المصير على أرض وطنه التاريخي فلسطين.
بالنسبة للصهيونية، هناك شعب واحد يمتلك حق تقرير المصير على "أرض إسرائيل" من البحر إلى النهر هو "الشعب اليهودي"، والأمر الذي أكده مجددًا قانون "يهودية الدولة" الذي أقره الكينست الإسرائيلي عام 2018.
انطلاقًا من المبدأ الصهيوني سالف الذكر، فإن إتفاقيات أوسلو تعتبر اختراقًا، فقد اعترفت إسرائيل بموجب الاتفاق بالشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، كما اعترفت إسرائيل بأن هناك حقوقًا للشعب الفلسطيني يجب التفاوض بشأنها، وفي مقدمتها القدس واللاجئون والأرض، عبر نقطتي الاستيطان والحدود، وأن للشعب الفلسطيني حقوقًا بالموارد والمقدرات عبر بند المياه.
والأهم أن إسرائيل قد أقرت في الاتفاق أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ولا يحق لها من طرف واحد تغيير الواقع فيها، كما حدد الاتفاق مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات وخلالها يجب أن يكون الاتفاق قد تم بشأن قضايا المرحلة النهائية: القدس، واللاجئين، والاستيطان والحدود والمياه. ولتوضيح ما يعنيه ذلك؟ فعلى سبيل المثال القدس، التي طالما إدعت إسرائيل أنها عاصمتها الأبدية، في الاتفاق أصبح هذا الادعاء محل تفاوض وليس أمرًا محسومًا سلفًا.
أعود للتعقيب الروسي، فالاتفاق هو عبارة عن خريطة طريق تفتح أفاقًا للسلام، وكان الأمر كذلك في البدايات إلى أن اغتال اليمين المتطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 1995. بعد ذلك تسلم هذا اليمين المتطرف السلطة في إسرائيل بزعامة نتتياهو في ربيع العام 1996، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد المفاوضات اي تقدم حقيقي، بل جرى تكثيف الاستيطان ومصادرة الأرض وتهويد القدس بشكل متسارع، هذه الهجمة الإسرائيلية على أوسلو توجت بعملية "السور الواقي" وهي الحرب التي شنها شارون عام 2002 وأعاد خلالها احتلال الضفة بالكامل، وقام بتدمير مؤسسات السلطة الوطنية وكل البنى التحتية وحاصر ياسر عرفات في مقره في رام الله وهو الحصار الذي انتهى باغتياله العام 2004 بالسم.
أما الوسيط الأميركي الذي احتكر عملية التفاوض، فكما ذكر التعقيب الروسي، أشاع الفوضى ولم يكن نزيها ولا محايدًا وساهم في تدمير عملية السلام عندما لم يكن حازمًا بما يكفي بما يتعلق بكافة انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات، وخاصة بما يتعلق بالاستيطان وتهويد القدس. وبلغ التدمير الاميركي لعملية السلام ولاوسلو ذروته مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب القدس "عاصمة الشعب اليهودي"، ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس مما اعتبر في حينه إزاحة لقضية القدس من المفاوضات.
لقد كانت واشنطن وفي مراحل كثيرة متماهية تمامًا مع اليمين المتطرف الإسرائيلي في هدف تقويض أوسلو ومنع تطوره باتجاه حل الدولتين، كما وقفت واشنطن أمام أي تدخل دولي إيجابي لدفع عملية السلام، بل وحرمت اللحنة الرباعية من القيام بأي دور فاعل.
وحتى الادارات الأقل تطرفًا، إدارات الديمقراطيين، كلنتون، أوباما والآن بايدن فإنها وان كانت متناقضة مع اليمين الإسرائيلي- لم تتحرك جديًا باتجاه المبدأ الذي طالما تغنت به ألا وهو مبدأ حل الدولتين.
وفي سياق مختلف، فإن القوى الإقليمية، وهي بالمناسبة عربية وغير عربية، التي ترى في القضية الفلسطينية مجرد ورقة للمساومة في إطار تنفيذ أجنداتها ومصالحها الخاصة، فقد كان لهذه الدول مصلحة بفشل أوسلو، وبقيت تصر على التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي عبر أذرع وأدوات فلسطينية. وهي ذات القوى التي تقاطعت مع إسرائيل في شق الساحة الفلسطينية وحدوث الانقسام في العام 2007، وتقوم حتى اللحظة بتغذيته.
والجدير ذكره هنا أن الانقسام يمثل التهديد الأكثر خطرًا على القضية الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق أية مكاسب برغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها.
إتفاقيات أوسلو هي نتاج اللحظة التاريخية التي أبرمت خلالها موضوعيًا وذاتيًا، فقد جاءت في وقت أحكمت فيه الولايات المتحدة الأميركية قبضتها على النظام الدولي، الذي بات يعرف بعد تفكك الإتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي وحلف وارسو، بنظام القطب الواحد. ولعلنا نذكر أن حرب الخليج في العام 1991، التي جاءت إثر اجتياح العراق للكويت، كانت بمثابة المنصة التي أعلنت خلالها واشنطن أنها صاحبة الكلمة في هذا العالم.
وإلى جانب كل هذه التحولات الاستراتيحية الكبيرة على الساحة الدولية، فإن تلك الحرب أنهت التضامن العربي، حيث انقسم العرب إلى معسكرين متواجهين، وهي المرحلة التي أنتهت باحتلال العراق العام 2003، ولاحقًا بتفكيكك عدد من الدول العربية.
أما على الصعيد الذاتي، فقد وجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها مع الطرف المهزوم في حرب الخليج، وفي الوقت ذاته كانت الانتفاضة الشعبية في الأرض المحتلة قد بدأت تخبو، فقد حرمت التطورات المتسارعة إقليميًا ودوليًا منظمة التحرير من استثمار الإنتفاضة، بالرغم أنها حاولت العام 1988، عندما عقدت المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وتم الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو.
لقد كان مؤتمر مدريد الذي حضرته كل الدول العربية، لحظة تاريخية لتعلن فيها واشنطن أنها هي صاحبة الكلمة الاولى والأخيرة في هذا العالم، وأن حليفتها إسرائيل اصبحت دولة مقبولة في المنطقة، وأن العرب جميعًا جلسوا معها.
وقد ثبت لاحقًا أن الولايات المتحدة لم تكن معنية بأكثر من تأكيد زعامتها وتثبيت الحقيقة الإسرائيلية، إلا أن ان تطورًا حدث في إسرائيل عندما جاءت حكومة رابين -بيريس عام 1992، التي إرتأت أن العنوان هو ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، للتوصل معه إلى إتفاق سلام، والخروج من مأزق السيطرة على شعب آخر، ومأزق الاحتلال.. هذا التحول الإسرائيلي الداخلي هو الذي فتح الطريق امام أوسلو.
لم يدعِ أحد أن أوسلو كان الاتفاق المنشود، فهو مرحلة أخرى من الصراع، ربما تحتاج إلى ذكاء أكثر وكفاح أكثر شدة، وفي الجانب الإسرائيلي كان تقويض أوسلو هدفًا وجوديًا لليمين الإسرائيلي، ومن جانبها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي نشأت لتكون مؤسسة استعمارية توسعية، فقد رأت في أوسلو عدوا لمخططاتها وإيديولوجيتها الصهيونية.
باختصار، لقد كان أعداء أوسلو أكثر بكثير من داعميه وهؤلاء الأعداء موجودون وأقوياء جدًا في الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد لا يستهان به من القوى الاقليمية المتضررة والمنتفعة من استمرار الدم الفلسطيني النازف.
التعقيب الروسي منهجه جيد لكنه كان بحاجة الى توضيح أكثر، إلا أن رسالة التعقيب واضحة: الشتم لا يجب أن يوجه لأوسلو، فهو بالنهاية إتفاق على ورق، وإنما من يجب شتمه راعي عملية السلام الذي لم يكن نزيها وحسب بل وشريكًا لليمين الصهيوني في تدمير حل الدولتين وأي أفق يمكن أن يقودنا إلى السلام العادل.



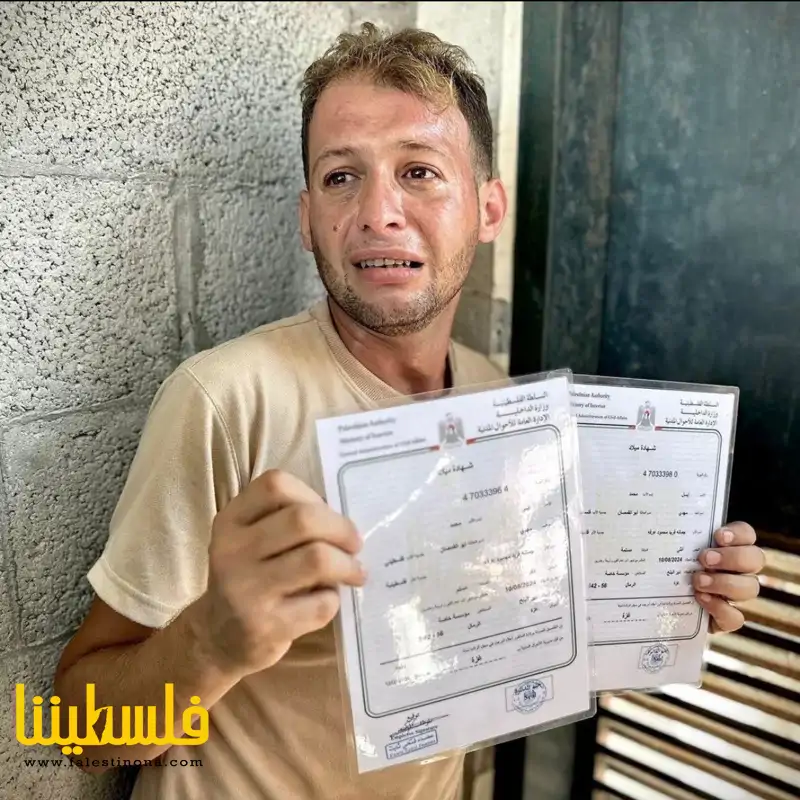














تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها