الشاعرة الفلسطينية نهى عودة
هدأت الأوضاعُ في المُخيّم، بعد تدخّل وساطات كثيرة لوقف المجزرة، فقرّرنا الرجوع إلى منزلنا حيث بقي أبي هناك وحده. سلكنا طريق مُخيّم "صبرا" ومنطقة "أرض جلول"، وعندما دخلنا إلى منزلنا، وجدنا أبي في حالة يُرثى لها، وبدا كأنّه كبُر عشرات الأعوام في الأيام القليلة التي لم نره فيها، من فرط تفكيره في مصيرنا وخوفه علينا. انهمر يسألنا عن أحوالنا وكيف تدبَّرنا أمرنا.. وسرد علينا "مغامراته" عندما كان يخرج من المنزل ليفتّش عنّا في كل مكان كان يستطيع الوصول إليه.
ذهب إلى البحث عنّا في الملجأ، وهناك وجد رجلاً تعتصره الآلام وهو غارقٌ في نزيف يكاد أن يصفّي دمه من جسده، فقد أصابه المُجرمون في رجليه وتركوه في بركةٍ من دمائه ليتعارك مع الموت ببطءٍ.. الرجل كان من معارف أبي ويُدعى "أبو تركي" وله دُكّان في مخيّم شاتيلا.
لم يكن في وسع أبي أن يُسعفه، فقرّر نقله إلى المستشفى، غير أنه لم يستطع حمله بمفرده، فاستنجد بمجموعة من الشبّان كانوا هم أيضًا في الملجأ يفتّشون عن أهاليهم وأقربائهم.. الكل كان يبحث عن الكل، أو حتى عن خبرٍ يُطفئ نيران الاضطراب والقلق والخوف في صدورهم، فقد تكون نتيجة البحث أنّهم استشهدوا أو أُسِروا.. المهم أن يكون هناك خبرٌ عنهم، وقد يسقط الباحث ذاته شهيدًا أو أسيرا!
قال لنا والدي بأنّ المجرمين الصهاينة كانوا يأخذون الناس من البيوت ويجمعونهم عند شارع "العريض" (شارع دلال المغربي) ويطلقون النار عليهم. وفي مرّة من المرات، ذهب والدي للتفتيش عنّا بين القتلى والأشلاء.. فوقف على مشهد يزلزل أكبر القلوب صلابة وقسوة، ولا يُصدّقه عقل أو يستوعبه منطق بشرٍ سويٍّ.. مشهد لمجموعة قتلى فيهم الكبار والصّغار وقد سكبوا عليهم مياه النّار الحارقة "الأسيد" حتى تتبدّد ملامحهم فلا يتعرّف عليهم أحد.
أبي لم يترك المنزل أبدا، فقد اعتقد أول الأمر بأننا في الملجأ، وليس عليه أن يغادر إلى أيّ مكان، حتى إذا ما عندنا نجده في انتظارنا. فلا أحد كان يتوقّع أنّ المجزرة ستمتد إلى ثلاثة أيام متواصلة من القصف والتّقتيل والإجرام الوحشي الذي يفوق قدرةَ الخيال البشري على تصوّره.
كان أبي مع صديقه عندما اقتحم المجرمون الصهاينة منزلنا، وسألوه: لماذا لم تهرب مثل غيرك؟ ألا تخافنا؟ فأجباهم أبي: أنا شيخٌ كبير وحركتي ثقيلة، فقد أعطّل الهاربين، لذلك اخترتُ أن أموت في منزلي! بكل وقاحة، وإن كانت كلمة وقاحة هي تكريم للصهاينة عندما تُطلق عليهم، طلبوا منه أن يُعِدّ لهم إبريقًا من الشاي، لكن أبي رفض بكل عزّة وشموخ وكبرياء، ولم يهتمّ لما سيحدث بعد رفضه.. غير أنّ ما حدَث لم يجد له أبي من تفسيرٍ، فقد قام أحد الصهاينة الذين اقتحموا المنزل بخلع بسطاره (الحذاء العسكري) ثم أخذ حذاء أبي!
تقول مريم: كنت أحسب أنّ الوقت الذي يُعدّ بالساعات صار دهرًا ثقيلا كالجبال، وتلك الأيام الثلاثة للمجزرة كانت عمرًا هرمتُ فيه عقودًا.
الأحداث المتسارعة لم ترحمنا أبدًا ولم تُمهلنا قليلا من الوقت لنلتقط أنفاسنا أو نرى نور الشمس، فقد اجتاحنا شعورٌ بالاختناق تحت سماء فولاذية حجبَت عن أعيننا رؤية الألوان. فكم من القوة والصلابة كنّا نحتاج لنجتاز الأعاصير التي كانت تعصف بأرواحنا وقلوبنا وأفكارنا!؟
بعد انتهاء المجزرة بفترة قصيرة، لا أذكر إن كانت تُعدّ بالأيام أو الأسابيع فقد بدَت لي قصيرة لأنّ هول المجزرة كان يسكنني وكأنها حدثت قبل ساعة، حضرَت إحدى القنوات التلفزيونية لتسجيل شهادات حيّة عن المجزرة، كنتُ حينها في المدرسة، ولا أعلم لماذا اختاروا التسجيل مع التلاميذ؟ ما أذكره أنّني كنتُ من بين الذين أخذوا شهاداتهم، وقد كنتُ أتحدّث بأبجديةٍ امتزجَت فيها الدموع بالكلمات وأنا أستحضر شريط الأحداث التي عشتُها وما زالَت راسخة في ذهني ولن تُمحى أبدا..
عُرِض الشريط التلفزيوني عن المجزرة وشهادات الناجين منها في "النّمسا"، وقد فاجأتني بنت عمّي "أبو عبد الله" عندما اتّصلت بي من خارج لبنان عبر السنترال، وقالت لي بأنها شاهدتني على إحدى القنوات أدلي بشهادتي عن المجزرة، فقد تناقلَت ذلك الشريط قنوات تلفزيونية عديدة.. هكذا نحن الفلسطينيون نصير مادة يستهلكها الإعلام بعد كل مجزرة!



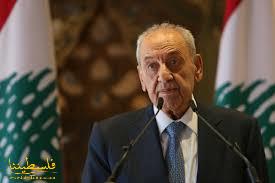













تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها