رحل صاحب القلم الشامخ مع أثر جميل للكسوف الذي تركه في وجدان الناس تحت قبة السماء، رحل في اليوم الرابع من الشهر العاشر لسنة ألفين وثلاثة عشر من عمر الزمن، في موعد محدد لا يتجدد ولا يتبدد، مثل أحرف الشقاء المتكررة التي لاحقت خطواته في كل أشكالها مع صور الينابيع التي كان ينثرها في فضاء قناعاته حتى آخر لحظات هجره. في غابة بعيدة على أطراف أصابعه التي امسكت بالقلم مراراً لكي تمطر أحلاماً كالشتاء، اعتدنا أن نسميها بلغة الكلام شجن النفس أثناء انفطار القلب في سكون لا قرار له.
حارس الاحلام الفلسطينية خطفته الايام
علي الخليلي ابن نابلس (جبل النار)، حائز على مؤهل علمي في الادارة العامة من جامعة بيروت العربية سنة 66، عمل رئيساً لتحرير مجلة "الفجر الثقافي" و"الفجر المقدسية"، صدر له أكثر من أربعين مؤلفاً منوعاً بين الشعر والبحث والسيرة والرواية والادب، أشهرها: "بيت النار". ومن دواوينه الشعرية تضاريس من الذاكرة، نابلس تمضي الى البحر، تكوين للوردة، جدلية الوطن، انتشار على باب المخيم، مازال الحلم محاولة خطرة ، سبحانك سبحاني، هات لي عين الرضا هات لي عين السخط. هو أحد أعمدة صحيفة الايام الفلسطينية، كان رحمه الله دائم التأمل في مجمل النتاج الثقافي والادبي. بعد أوسلو انتقل من أدب المقاومة الى أدب الضحية، لكن الضحية التي كان يرمز اليها هي الضحية التي لا تخشى الهزيمة. مساهماته في الأدب والشعر والمقالة السياسية كنماذج، بعيدة عن النمطية نظراً لاعتماده المفهوم النقدي في كتاباته وقراءاته ونظرته الى كينونة الادب بشكل عام، أخذ على عاتقه رعاية الاقلام الشابة والاهتمام بكل المستلزمات الكفيلة بإنضاجها حتى وصولها الى بر الامان. مع تقديره واحترامه للرأي والرأي الآخر وافساحه في المجال امام الكتابات الجديدة لأن تأخذ دورها، واضطلاعه بدور تنويري وطليعي كان يؤديه ويؤمن به في مجال النظام السياسي المبني على الحرية والاستقلال والديمقراطية. أعماله الادبية توزعت في مجال دراسة التراث والموروث: "التراث الفلسطيني والطبقات"، "البطل الفلسطيني في الحكاية الشعبية"، " أغاني الاطفال في فلسطين"، "أغاني العمل والعمال في فلسطين"، "الغول مدخل في التراث العربي". وفي الابداع السردي له: الكتابة بالاصابع المقيدة، حكايات وجدانية، المفاتيح تدور في الاقفال(رواية). ومن كتبه النقدية: شروط وظواهر في أدب الارض المحتلة. وله ايضاً: موسيقى الأرغفة، النص الموارب. أما آخر أعماله التي صدرت هذا العام فكانت تحت عنوان: مختارات من الشعر الفلسطيني.
احتفى علي الخليلي باتصاراته وانكساراته بالثبات والرحيل والبحث عن معنى آخر وتفسير آخر لكل ما يدور خارج فلك السياسة والنمطية المستهلكة في تناول الموضوعات ذات البعد السياسي والوطني والثقافي؛ لأن علاقته بالوطن كانت من خلال المشاركة في مساحات الذات وليس التحاقاً أعمى بها، ولكنه لم يقف عند هذا المفهوم الضيق، بل هو قبل كل شيء ابن بيئته، محرك لها ومتأثر بها الى أبعد الحدود. وايماناً منه بوضع حركة الادب في مسار التقدم والتطوير البنيوي والضمني ساهم في تطوير العديد من الصحف والمجلات من خلال مساهماته فيها، فترأس تحرير العديد منها في الارض المحتلة، وأسس مع رفاق دربه اتحاد الكتاب ونقابة الصحافيين الفلسطينيين وكان مساعد وكيل في وزارة الثقافة منذ تأسيس السلطة حتى 2005. ويشكل ارثه منارة للادب والثقافة، ولهذا كان دوره مهماً وخلاقاً في تحريك مفاصل البنى الكتابية ومدّها بالزخم والغنى والجهد، وليس من العبث ان يتم اختياره في 2011 شخصية العام الثقافية. آخر ما جاد به قلمه المعطاء والغزير مغالباً احتضاره، ثلاث مقالات من أبجدياته خلال الفترة ما بين 21 - 28/1/2013. أنا والسرطان وعيادة وزيارة، والغياب الوشيك، يقول: " رجلاي حطبتان معلقتان في خصري، اشتاق الى المشي على الارض، غرفتي مليئة بكل الآلات ووسائل المساعدة على تحركي خارج خناق السرير، كرسي متحرك، ووكر، عكاز، لكنها جميعها لا تساعدني على استخدام الادراج..." ويقول: "لا أرى في هذا الاكليل (يقصد زهر اللوز) الظاهر من النافذة غير ما يرى العابرون قربي، أو بعيداً عني أرى أن رجلي صارتا من لحم ودم، لا حطب ولا انفصال. وأنني قادر على المشي على الأرض أمشي في الغرفة خطوة، خطوتين، لا بأس، مشيت، تواصلت مع الارض بجسدي." سيترك غيابه أثراً وفراغاً على حلم ثقافي فلسطيني صادم. توفي شاعر الفقراء والازقة، وهو شامخ دون ترفّع أو مكابرة، ممهّداً الطريق لغيره، وظلّ هاجسه كتابة قصيدة حديثه تضاهي حبه لنابلس.
ياسمينة نابلس ألقت حملها
نقطة ساخنة او مساحة واسعة تصلح لأن تكون شرارة التعبير عن كاتب وشاعر ومفكر وأديب وموسوعة ثقافية. مجموع هذه المسميات في رجل شق طريقه عنوة وبارادة فذّة ليست غريبة على انسان مثل علي الخليلي الذي وجد في الثقافة أداة للتغيير حتى وصل الى أعلى الهرم الفكري والادبي في الثقافة الفلسطينية، فمنذ ان شق طريقه في منتصف الستينات وانخراطه في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية بنسق ابداعي معبّر عن قضايا المجتمع والوطن الفلسطيني، وقد تجلى ذلك في انتاجه الادبي، ومواقفه السياسية والوطنية، مما دفعه لأخذ قراره في العودة الى أرض الوطن ليلعب دوراً مهماً في تأسيس حركة أدبية فلسطينية مناهضة للاحتلال على أرض الواقع وبتوجيه من قيادة حركة فتح في السبعينات من القرن الماضي. فاستحوذ على احترام الجميع ؛ لأنه اراد ان يبني جيلاً مبدعاً في سماء الادب والابداع الشعري والقصصي والروائي الفلسطيني. خصوصاً أنه صاحب ادب جاد وهادف في ما كان يعرف في تلك الحقبة بين ابناء السبعينات من القرن الماضي بجيل عبد الناصر الملتزم بالقضايا القومية والعروبية. ولولا سطوع شعر المقاومة في تلك الفترة ممثلاً بمحمود درويش ورفقائه من شعراء المقاومة الذي جعل الثقافة في تلك الفترة تنحاز الى الحركة الثقافية التي تمثل هذا النوع من الشعر والادب، مع أن علي الخليلي كان من رواد هذه الحركة، وهو متصدر أعلى لائحة الاسماء المبدعة فيها، لكن نجمه لم يسطع حيث خطف الاضواء منه رعيل شعراء المقاومة، ولكن برغم ذلك فإنه شاعر القلق المزمن على القضية الفلسطينية الذي لا تخمد ألسنة لهبه، وهو من أكثر الكتّاب تضحية من جراء عدم الاستقرار والتخبط والاضطراب ومن الذين دفعوا ثمناً لذلك.
لم يترك علي الخليلي لنفسه أن يتصور تلك الاحوال والدمار والخراب في أحوال البلاد، وينصرف عنها بالانشغال في امور اخرى بعيدة عن واقع الحياة وهموم شعبه التي كان يعيشها في تلك الفترة. وبهذا المعنى فهو انسان بكل ما للكلمة من معنى حيث قدم للثقافة الفلسطينية مخزوناً لا يستهان به، كمّاً ونوعاً، من النتاج الفكري والادبي والشعري على مختلف الصعد، ولا شك في أن الحركة الثقافية الفلسطينية خسرت في فقده قمراً كان يضيء مساحة واسعة في هذا المجال. كما أنه خسارة للمشهد الثقافي العربي، فقد كان علماً من أعلام الصحافة والادب والشعر المرتبط باحداث الوطن العربي وتأثيرات هذه الاحداث على الواقع الفلسطيني. فالقضايا التي كان يطرحها تتصف بالشمولية والعمومية التي كان يتشكل منها الفرد والمجتمع على حد سواء، وعلى نطاق الواقع الفلسطيني والعربي والانساني بشكل عام. امتاز باسلوب فريد واضح وصريح واقعي مجرد، له خصوصيته وفرادته الانسان هو الاسلوب من دون ان ينسى امجاد بلاده وكوابيسها واحلامها ولمساتها العذبة، رغم كل ما جرى لها، ووقوعها فريسة المؤامرات الدولية وغير الدولية. علي الخليلي كان مخلصاً لدوره واضحاً في مقارعة الاحتلال ومبدعاً متنوع القدرة الكتابية في أحلك الظروف. استمد ديمومته الثقافية من واقع الحياة، وليس من عملية جمالية مقيدة بالكتمان والاختناقات.
رحل الرجل الحالم البسيط الباحث عن النقاء والتغيير والمستقبل والابداع بالتحدي والامل ونبل المرامي، رحل تاركاً نصاً مقاوماً للاحتلال قبل كل شيء، ومقاوماً لليأس والخضوع قلّ نظيره. وطوال سيرته الكتابية رغب في تناول الحياة بتفاصيلها اليومية وفقاً لعلاقته وتأثره بمحيطه، فسعى على التخلص من مساحة المغامرة والسماح للسرد لأن يكون هو الطريق الآخر لبلوغ الاثارة والاصطدام بالواقع وتأليفه مجدداً، وربما بسبب ذلك اقترب أكثر من الحياة والعيش اليومي غير أن الحياة لم تعترف له بمكانته ودوره الريادي في معالجة موضوعات انسانية وراهنة في اطار ثقافي عام، الا انها ظلت على مكرها وملهاتها المؤلمة له.
بقلم/ محمد سعيد





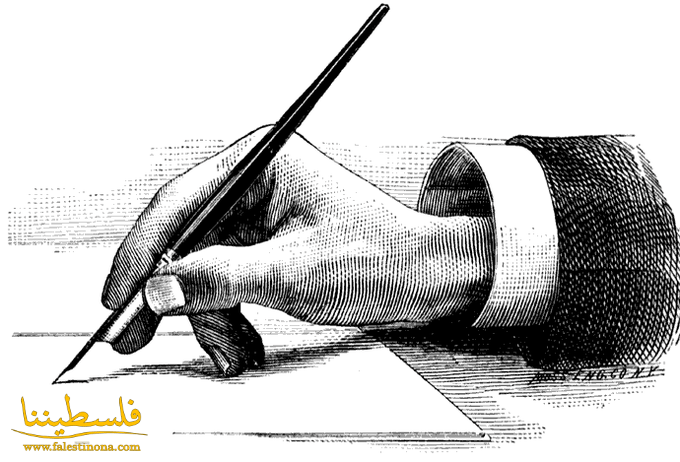











تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها