ما كان يجب أن يدفع فيتوريو أريغوني حياته ثمناً، حتى يكتشف الفلسطينيون، أن بينهم من هو أكثر بشاعة من الاحتلال نفسه، ومن هو أشد من القبح والبشاعة المطلقة، وحتى يعيد الفلسطيني اكتشاف نفسه بعيداً وخارج حدود الوهم، الذي هياً له لوقت طويل من الزمن، على انه قريب من الاكتمال، أو أنه خال من الدناءة أو قلة المروءة، أو ما شابه من صفات البشر في كل مكان، بعد أن طهرته مقاومة الاحتلال من وضاعة العجز عن مقاومته، منذ عام 1948 وحتى عام 1965، وبعد أن أحاطته الدنيا بأسرها بكل الحب والتعاطف الذي يمكن أن يكنه بشر لآخرين في هذا الكون .
لكن الدرس لم ينته، رغم حجم الفجيعة التي لا حدود لها، فالفلسطينيون، كما هو حال كل العرب، على ما يبدو، عليهم أن يدفعوا "فواتير" عهود من التزمت والانغلاق، فحتى يقبضوا على نواصي الحرية، يجدون أنفسهم مضطرين لتقديم الضحايا، وبذل الكثير، حتى يصبحوا جزءاً من هذا الكون، الذي انفتحت أبوابه، وما عادت تجدي فيه نفعاً، كل محاولات وضع الرؤوس في التراب لمواجهة حقائق الواقع العنيدة .
لم تقتصر الصدمة على اختطاف فيتوريو ومن ثم قتله، بهذا الشكل، ولدوافع خسيسة ورخيصة ولا معنى لها، على جموع الناس، بل أجمعت عليها حتى القوى السياسية، دون استثناء، لكن ذلك لا يكفي، ذلك أنه رغم، خروج، حتى السلفية الجهادية إلى العلن بالقول بأن القاتل كان فرداً، قام بالفعل المشين على عاتقه الشخصي، ودون أوامر من أحد، ذلك أن عملية القتل لم تكن على أي حال فعلا جنائيا عابرا، بل كان فعلا يختصر حالة تشبه الوباء، حين ينتشر فإنه يحصد كل ما هو حي، وبرأينا، فإن مجرد كشف القاتل، والقبض عليه لا يكفيان لوضع حد لما حدث، أو لما تكشفه الواقعة من دلالة و على المدى الذي وصل إليه الحال الفلسطيني الداخلي من مستوى حرج .
فقد دلت الحادثة، على أنه حتى "حماس"، بجبروتها وقدرتها، وحتى أدعائها بأنها تسيطر على غزة سيطرة تامة، ما هو إلا ادعاء خادع، ذلك أن تحقيق الأمن له مقتضيات ومتطلبات، تفوق كثيراً وتتجاوز حدود وإطار الترتيبات الأمنية، وتوفر الأجهزة المنضبطة، حيث يتداخل الأمن بالاقتصاد والسياسة، وبحالة الحريات العامة، وحيث لا تكون هناك ديمقراطية أو لا يكون هناك عدل، لن يكون هناك أمن ولا أمان، مهما سعت الحكومات والأجهزة إلى فعل المستحيل، بل ربما كان العكس هو الصحيح، أي أن التشدد والقمع، قد يوفران أمناً مؤقتاً أو عابراً، لكن سرعان ما تنهار المنظومة الأمنية، عند أول حالة احتجاج في الواقع، ولعل الشواهد باتت عديدة وماثلة للعيان في هذه الأيام، فيما تبقى الإشارة إلى حقيقة أن كل أنظمة القمع والتشدد قد ذهبت أدراج الرياح، فيما بقيت الأنظمة الديمقراطية، على قيد الحياة، رغم تقدمها عبر الزمن، تدل بشكل صريح وواضح، على انه لا بديل عن خيار الحرية والديمقراطية .
لقد كانت ردود فعل "حماس" في غزة، تشير إلى مشكلة، فهي سارعت إلى استنفار أجهزتها، التي ما زالت تعتقد أنها قادرة على " تثبيت " حكمها، إلى ما شاء الله، وكانت التصريحات الأولى، تشي بمحاولة، توجيه التهمة للطرف الآخر، بإظهار شيء من التحفظ أو عدم الانخداع في "إيحاء" الخاطفين بانتمائهم للفكر السلفي .
وبالطبع، فإن فجيعة "حماس" في غزة، بالحادثة هي كبيرة، لأنها مست التضامن الدولي مع غزة، ولم تكشف القدرة فقط على "اختراق" المنظومة الأمنية وحسب، بما قد يوجه ضربة موجعة لهذا الجهد الذي تعول عليه "حماس" كثيراً، في تثبيت أركان سيطرتها على غزة، وفي بقائها فاعلاً سياسياً رئيسياً في الشأن والواقع الفلسطيني، لذا فإن مسارعة السلفية الجهادية - التوحيد والجهاد - للإعلان عن عدم مسؤوليتها عن الواقعة، وإن كان محاولة من هؤلاء لتجنب رد فعل "حماس"، إلا أنه في الوقت ذاته، يعلن بشكل سافر عن وجود هذه القوة، وربما، بهذا القدر أو ذاك، يشوش على نفي "حماس" المتواصل بعدم وجود عناصر قاعدية في غزة .
في محاولة استخلاص العبرة، وقراءة كل ما أحاط بالواقعة من ملابسات، لا بد من لحظ أمرين في آن واحد وهما : أنه لا يمكن الاكتفاء بالمعالجة الأمنية لما حدث، بل قراءة السياق كله الذي أنتج هذه الحالة، وأخرج هذه الفجيعة إلى العلن، فجرأة القاتل، حتى لو كانت الدفيئة التي أنتجته بريئة من فعلته، ما كان لها أن تكون لولا أن سلطة "حماس" في غزة، سبق لها وأن غضت البصر عن كل أفعال العناصر السلفية المتزمتة، في السابق، بالتعدي على حقوق الناس وعلى الحريات المدنية العامة، حيث سبق لها ان وضعت العبوات والمتفجرات، في مقاهي الانترنت، وفي صالونات حلاقة السيدات، والتطاول، حتى من قبل عناصر حمساوية، على جمعيات أهلية، دون ان تواجه هذه العناصر بمجابهة صارمة من قبل سلطة الأمن في غزة، وكأن هذه السلطة تسعى "للتدليل" على وسطيتها، إلى "خلق" من هم على يمينها من قوى أشد تزمتاً وتعصباً !
كذلك لا بد من الانتباه إلى حقيقة ان اغتيال فيتوريو، إنما جاء بعد أيام قليلة من اغتيال جوليانو خميس في جنين، وهذا قد يدل على أصابع إسرائيلية، ربما باتت، تفضل بديلاً عن كل من "فتح" و"حماس" معاً، هو القوة السلفية المتنامية في المجتمع الفلسطيني، والتي، قد تفعل فيه ما فعلت "طالبان" و"القاعدة" في أفغانستان وفي الأنبار، من تدمير ذاتي، يأكل ما تبقى من لحم حي لهذا الشعب ولقضيته العادلة، وحيث ان الانقسام والصراع على السلطة، الذي يشبه صراع القوى الأفغانية بعد تحرير أفغانستان من السوفييت، بقدر ما يحبط الناس، ويخلق حالة من الفوضى، بقدر ما يسمح، لمن هم أشد تزمتاً بأن يتقدموا على حساب الجميع .
وقد كان ليس للموقف المتقاطع على جانبي المعادلة السياسية الرسمية، فقط، ولكن أيضاً لما اتخذه الطرفان من قرارات بملاحقة القاتل، والقبض على المجموعة الخاطفة، حتى وأن بدأ الأمر شكلياً، خاصة على جانب السلطة الرسمية، حين اتخذ الرئيس قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، ما يوحي بأنه آن الأوان لأن تدرك "حماس" و"فتح" انهما في مركب واحد، وانه عليهما، أن لا يكررا تجربة النزاع الذي كان بين قلب الدين حكمتيار وأحمد شاه مسعود في أفغانستان، لأن ذلك سيسهل مرور " حالة طالبانية " في غزة والضفة، ذلك أن ملفي اغتيال جوليانو وفيتوريو يجب أن لا يقفلا بأي حال من الأحوال عند حدود المعالجة الجنائية .
الاستخلاص واضح، والمركب الفلسطيني، يبتعد في عرض البحر، ليواجه مصيراً مجهولاً وغامضاً، لن يعرف أحد بعد وقت أبعاده أو حدوده، وبعد أن دفع جوليانو وفيتوريو حياتهما من أجل حرية وسعادة الفلسطينيين، على الفلسطينيين، أن يدركوا أن جوهر الحرية إنما هو إنساني، وأن فيتوريو كان فلسطينياً أكثر بكثير ممن قتله، وأن جوليانو، كان أقرب إلى الجنة من قاتله، وأن حياة الفلسطينيين باتت مرهونة بمدى تحررهم الداخلي أيضاً، وليس فقط بتحررهم من الاحتلال الإسرائيلي وحسب









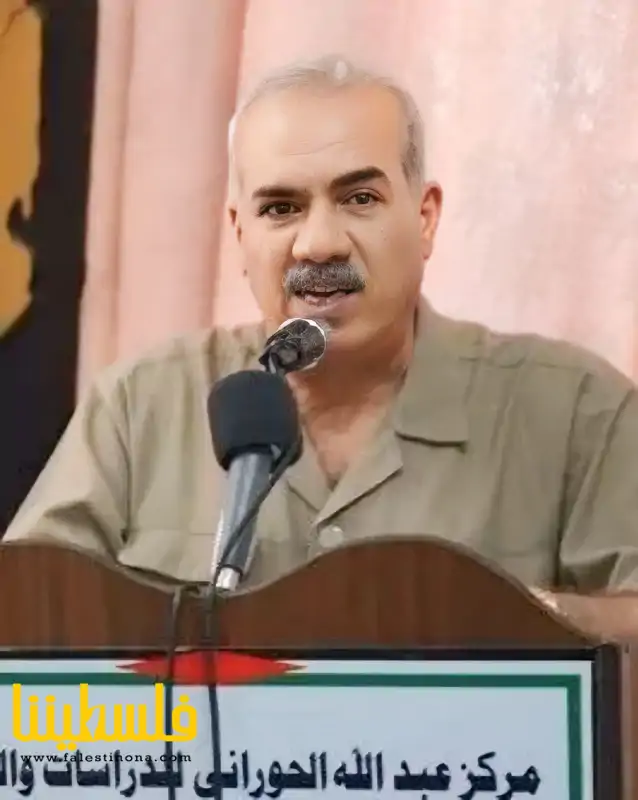







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها