غادة اسعد/ الناصرة
محمود فريج - تجاوز الثمانين بعاميْن – في نبرة صوته قوة الشباب رغم تعبه الجسدي والنفسي بفعل ما عاشه خلال مراحل حياته، وفي عينيه الزرقاويْن، عُمقٌ تخالُه بحراً مِن الذكريات. جاءَ ليلتقيني مُرغمًا، فهو لَم يَعُد يحتمل اقتطاعَ أجزاءٍ من روحه، كلما تحدَّث عن ماضيه، وبالأخصِ عن أخيه الشهيد أحمد فريج، بينما هو – أي محمود، ابنُ الأربعة والعشرين عامًا آنذاك- فيوم أصابته رصاصةٌ في فخذه، أقعدته في الفراش شهراً ونصف الشهر، لكنّ الوجعّ بالنسبةِ له، لم يكن ألم الوجع الذي شعرَ بِه، عندما نزفَ طويلاً لليلةٍ كاملة، بل وجعه في فراقه عن رفيق دربه، شقيقه ومؤنس وحدته، أحمد. أمَّا اليوم وقد عاشَ ثمانية وخمسين عامًا بعيدًا عن أحمد، فلا تزالُ ملامِح ذكريات الطفولة في عينَيه، وفي امتناعه عن الكلام حديثُ الشجون وخطابُ الأحبةِ والشوقُ إلى الماضي، وعهد الطفولة والصبا، وبينهما تفصلُ مجزرةٌ رهيبة، قتلت 49 شخصًا، من قرية كفر قاسم الفلسطينيةُ الثكلى.
كفر قاسم تدخلُ التاريخ!
عن جغرافية بلدته يتحدَّث الحاج محمود فريج (أبو الأمين) فيقول: "لمن لا يعرفها، فكفر قاسم قرية عربية فلسطينية في أراضي عام 1948، وهي إحدى التجمُّعات العربية الحدودية الواقعة غربي الخط الأخضر، وتتبع لمنطقة المثلث الجنوبي، وهي تقع على ربوة بارتفاع 150 متراً فوق سطح البحر، على بعد 20 كم شرقي مدينة يافا التاريخية (تل أبيب اليوم)، و8 كم شمال شرقي مدينة ملبس (الـمُسماة اليوم – بيتح تكفا – مدينة يهودية)"، ويستطرد: "لعلّ الحدث الأبرز الذي حوّل كفر قاسم إلى اسمٍ لن يتجاوزه التاريخ، حصول المجزرة التي ارتكبها جنود حرب الحدود الإسرائيليين، عندما قتلوا بدمٍ بارد 49 فلسطينيًا شيبًا وشبابًا ونساءً رميًا بالرصاص، بينهم و23 طفلاً وجَنيناً لم يرَ النور، كان ذلك مساء يوم الاثنين في التاسع والعشرين من اكتوبر عام 1956، يوم العدوان الثلاثي على مصر."
ويضيف "للعدوان على مصر علاقة مباشرة بالمجزرة. ففي عام 1956 كان الحكم العسكري هو المُسيطِر على البلاد، وكان حظر التجول يُفرض منذ احتلال فلسطين وحتى (1968)، بحيثُ يبدأ من الساعة العاشرة ليلاً وينتهي في الرابعة فجرًا. لكن يوم وقوع المجزرة أبلغ قائد المنطقة الوسطى، الجنرال تسفي تسور العقيد يسحار شدمي (قائد أحد الألوية المسؤولة عن الحدود مع الأردن)، بأن يُسمح للمواطنين بالتحرُّك والعمل دون إزعاجهم شرط المحافظة على الهدوء في منطقة الحدود مع الأردن، خاصةً أنّ الجبهة الجنوبية ضد مصر ستشتعل، لكنّ شدمي قرّر فرض حظر التجول من الساعة الخامسة عصرًا حتى فجر اليوم التالي، تسهيلاً لانتشار الجيش على الحدود الأردنية، فاستجاب قائد المنطقة، وعندها طلب شدمي من قائد حرس الحدود، ملينكي، بتطبيق فرض منع التجول بشكلٍ صارم، وتطبيقه بواسطة إطلاق النار، وحين سأل ملينكي العقيد شدمي عن مصير المواطنين العائدين من عملهم دون علمهم بأمر منع التجول، ردّ عليه شدمي "الله يرحمه"، وهذا ما حدث، فقد تعامل ملينكي بدون عواطف، واكتفى بـ"الله يرحمهم."
ذكرياتٌ لا يمحوها الزمان...
وعن علاقته بشقيقه يقول فريج: "كُنّا جسدًا واحدًا، ولي ذكريات طفولية سعيدة معه. ورغم أنه كان يكبُرني بعاميْن، إلا أن صداقتنا كانت عميقة. خطواتي كانت تتبّع خطواته، وحديثه كان يستهويني فأُنصت إليه. تزوّجنا فرحتُ بأطفاله الأربعة، وفرح بولادة أبنائي الثلاثة. كنا نعمل سوياً في المحاجِر لدى يهودي من المجدل، وكم كان عملُنا شاقاً، إذ كُنّا نقوم باقتطاع الأحجار وطحنها، مقابل ليرتين، وهي مُربحة، لكن – في النهاية – كُنّا نبني بيوتهم وهُم يقتلوننا، علمًا أنّ والدينا امتهنوا الفلاحة وكانا مرتاحَي البال، قبل الجريمة التي نفَّذها الضباط الإسرائيليون".
يواصل فريج سرد الذكريات، بحزنٍ ودموعٍ تحبسها الـمُقل فيقول: "في يوم اثنين من شهر اكتوبر عام 1956 أنهينا عملنا، وعدنا راكبين الدراجات الهوائية قرابة الخامسة مساءً أنا وشقيقي وصديقان لنا، وعرّجنا إلى رأس العين (المجد الصادق)، وفي الطريق، التقينا بمركباتٍ للجيش الإسرائيلي، ولاحظنا حركة تنقُّل غير طبيعية، وحين وصلنا قرب (النصب التذكاري للشهداء)، أي وسط القرية، صُدمنا بصوت إطلاق النار، ينطلق من سيارات الجيش المارّة، باتجاه البلدة، وكُنتُ قد تجاوزتُ شقيقي وصديقي، إلى الناحية الشمالية، أمَّا هم فقد عرّجوا غربًا، وإذا بطلقات الرصاص تُصوَّب باتجاههم، ثمَّ أعاد الجنود بنادقهم ناحيتي، ولأول وهلة أعتقدتُ أنّها رصاصات زائفة لإخافتنا فقط، وإذا بي إصابُ برجلي، وعرفتُ ساعتها أنّها ليست للإخافة فقط، وسمعتُ الضابط يقول لمطلِقي النيران، خُسارة ع الفشك، أعطوا كل واحد رصاصة في رأسه، وارتاحوا، وفي لحظةٍ قبل إطلاق الرصاصة في رأسي، مرّ راعي غنم يسوق قطعيه، فأطلقوا النار باتجاه الراعي وابنه، وأطلقوا رصاصاتٍ أخرى باتجاه شقيقي ورفيقيْنا، ونسوا أنني ممددٌ على الأرض، بلا حراك، فقد شاءت الأقدار ألا أفارق الحياة، وكلما مرّ شخصٌ من أمامي كنتُ أميِّزه من صوته، وأقولُ في نفسي "الله يرحمه"، وفي لحظةٍ مرّت سيارة فيها أكثر من 20 سيدة وفتاة، أنزلوا الركّاب وأطلقوا النيران على النساء ومعهم أربعة أطفال، قاموا بحصدهم جميعًا، إلا واحدة مِن بين الفتيات، أصابتها الرصاصة في أذنها، وقد نجت من الموت. وهكذا استمرَ القتل حتى الساعة التاسعة مساءً تقريبًا، بعد أن تأكَّدوا أنّ جميع العمال العائدين أصبحوا في عِداد الموتى".
وأخيرًا ترك الجنود المكان، فقمتُ وتفقَّدتُ المكان، بحثتُ عن أخي، ناديته "أحمد" وناديتُ صديقي "علي"، لكنّ أحدًا مِن أحبتي لم يُجبني. أما صديقنا الثالث فلم أعثُر عليه، سألتُ نفسي: "ليش قتلونا؟!"، مررتُ مِن فوق الجثث وغربت إلى كرم الزيتون والصبر، اغمضتُ عيوني، لكنّ قلبي لم يستكن، كنتُ خائفًا، وقلقًا."
يصمتُ فريج قليلاً ثمَّ يستدرك ذكرياته فيقول: "لم يتوقَّف النزيف، ولم تهدأ آلامي، حتى أذّن شيخُ الجامع لصلاة الفجر، ونادى المنادي بمنع التجوّل، فتأكدتُ أنّ أحياءً في القرية أيضًا موجودون، وكان بيتُ نسيبي قُرب الجامع غربًا، فوصلتُ اليهم زحفًا، وعرف الجميع أنّ هناك قتلى في رأس العين، واعتقد أبي أنّني بين عِداد الأموات، وبقيتُ ثلاثة أيام، تسلَّل خلالها نسيبي إلى بيت والدي، وأبلغه أنّني حيٌ، وقرأتُ لاحقًا في الصحف أنّ الجيش يتهم الشهداء بقذف الحجارة. ولكنني لن أنسى ما حييت تلك اللحظة، وحين رُفع منع التجول، عند الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء، فحضرَ والدايْ وشرعا يحتضناني ويبكيان على كتفي، فأشهقتُ ببكاءٍ مرير، ووقتها قالَ والدي لوالدتي: "بعوض الله يا عايشة (والدتي) إن كان أحمد قد نالَ الشهادة، فإنّ محمود لا زال حيًا".
45 يومًا في مستشفى "تل هشومير"
أخذوني إلى مركز الشرطة، ثم نقلونا إلى مستشفى "تل هشومير"، في منطقة تل أبيب، وكُنا جرحى كُثر، فسألونا إن كنا عرباً أم يهوداً أم مصريين، فأخبرناهم أننا من كفر قاسم، وعندها قالوا أنتم الذين أطلقتم الحجارة على الجنود؟، ثم سمحوا لنا بالدخول، وكان من بين المصابين اسماعيل العقاب الذي قُطعت رجله. أمَّا أنا فأمضيتُ 45 يومًا يرافقني الوجع والحزن على شقيقي أحمد والمصيبة التي حلَّت بالقرية. ولاحقًا أخبروني أنهم عقدوا صُلحًا بين العرب واليهود في القرية، وعوَّضوا الجرحى بـألف ليرة وعوائل الشهداء بـ5 آلاف ليرة، على اعتبار أنّ المبلغ المدفوع هو فدية لِما لحق بِنا من أذى، وذبحوا الخِراف وطبخوا للاحتفال بالصلحة. من جهةٍ أخرى استُدعي شدمي إلى المحكمة، حيثُ حُكم عليه بقرشٍ واحد جزاء أهدار دماءِ 49 مواطنًا فلسطينيًا!!.
الجريح محمود فريج: وصمة عار في جبين المحتلين!
يقول الحاج أبو أمين: "شاءَ القدر أن نبقى في ديارنا، رغم أنّ قتل هذا العدد من الناس، كان الهدف منه تهريبنا من وطننا. فاليهود يؤمنون أنّ قتلنا يخُيف أكثر مِن 500 شخص، بل 5 آلاف شخص، فيهربون عبر الحدود إلى بلادٍ أخرى، بعيدًا عن فلسطين، لكنّ ذلك كان بعيدًا عن عيونهم وأمانيهم، لأننا بقينا في الوطن وحافظنا على الأرض".
يتابع: "شعرتُ بالظلم الكبير، لكن ما مِن شيءٍ كان باستطاعتنا أن نفعله أكثر، خاصةً أننا في ظل الحكم العسكري، كانوا يمنعوننا حتى مِن قراءة الصحُف، وأبرزها الاتحاد، التي كانت تواجه الاحتلال بالكلمة، فكانَ قارئُ صحيفة الإتحاد محروماً مِن تعليم أبنائه، لكننا رغمًا عنهم تعلَّمنا، وكبر أحفادنا وصاروا أكثر مِنا إيمانًا بالوطن وبالحفاظ على الأرض، وما كان ذلك ليحدث لولا الجرأة (ولو متأخرة) في الحديث عن مجازرنا ونكباتنا، وهي أمرٌ في غاية الأهمية، أنّ نوثِّق مصائبنا، حتى نحمي الأجيال القادمة من مجازر مشابهة، ونجعلهم أكثر تحدِّيًا وثقة بالنفس، مِن جيلنا نحنُ، فقد كُنا نخافهم، ونحسَب أنّ وصمة العار التي التصقت بهم حتى الممات، ستردعهم عن البطش والقتل مِن جديد، لكنهم أبدًا لا يتوقَّفون عن القتل والملاحقة، بشتى الوسائل".
ويستذكر أبو الأمين بعض أبياتٍ من قصيدةٍ مطوّلة للشاعر الكبير توفيق زيّاد تقولُ الكلمات: "ألا هل أتاك حديث الملاحم/وذبح الأناسيّ ذبح البهائم/ وقصّة شعب تسمّى "حصاد الجماجم"/ ومسرحها قرية/ اسمها كفر قاسم".
فريج: واجبي المشاركة في مسيرة إحياء ذكرى شهداء المجزرة
ويؤكِّد الحاج فريج أنه سيواصل اشتراكه في إحياء ذكرى المجزرة في نهاية شهر اكتوبر من كُلّ عامٍ، لكنّه يأمل من الخالق عزّ وجل أن يمنحه الصحة والقوة كي يستطيع أن يرافق أبناء شعبه في المسيرات.
ويؤكِّد الحاج فريج أن ارتباطاً قوياً يربطه بالمكان الذي أصيب فيه، ويضيف "كلما مررتُ مِن المكان أشمُ رائحة الدماءِ وصوتَ أخي قبل أن نفترق، وفي المكانِ شُجيراتٌ كانت هُناك أحِنُ إليها، رغم استبدالها بالنصب التذكاري لأسماءِ شهدائنا، كُلما مررتُ مِن هُناك، أذرفُ دمعةً، تظلُ حبيسةً في القلبِ، وأسمعُ صراخي المكبوت في داخلي "لماذا فعلتم هذا أيها المجرمون؟!!".
تنهَّد وقال: "أجملُ ما عشته في طفولتي هو الحرية والبساطة وعدم سماعِ الأخبارِ المزعجة، بسبب الافتقار إلى المذياع، أما الأسوأ في حياتي التي عِشتها، فهو الفقرُ والاحتلال والمجازر في كُل بقعةٍ من الوطن الفلسطيني".
















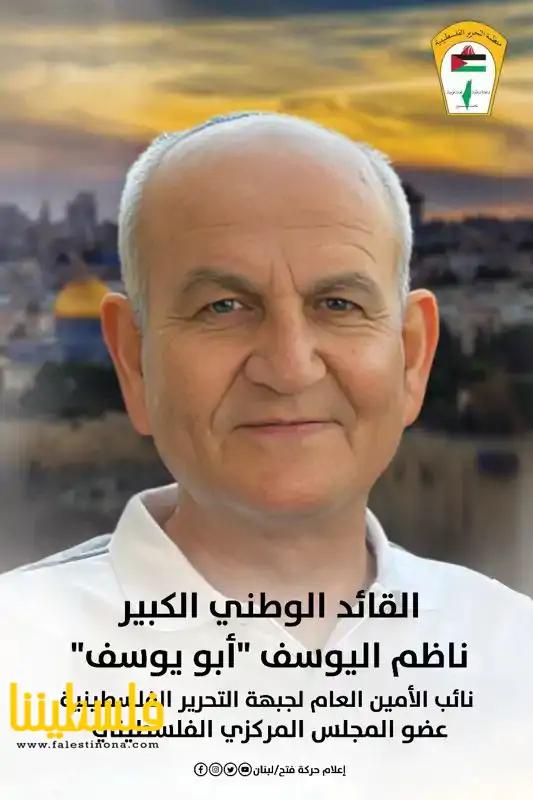

تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها