يطلّ علينا العام الجديد وقد قطعت الثورة الفلسطينية مفازات عدة، واجتازت في المياه الراكدة ودرب الآلام الكثير، ما جعل من تتالي الطعنات التي تلقتها عامل قوة وانبعاث كطائر الفينيق الذي ارتبط بهذه الأرض وياسر عرفات ، وما جعل من سيل المشكلات والأزمات والتأزم الداخلي أو الاقليمي أداة للتنقية والتطهير والمراجعة تستخدم في حين، وتهمل في أحايين.
إن الازمات التي أحدقت بالثورة الفلسطينية كانت مما ينوء بحملها الجبال من تكالبات الاقليمي الذي ينخر في جلدنا، والعالمي الذي يحتفي بالكيان الصهيوني ويقدمه على ما سواه وفوق هذا وذاك اشتبكت الثورة الفلسطينية خلال 50 عاما من الكفاح والنضال مع هذا المحيط المضطرب يموج كالبحر.
لم تكن الأزمات سهلة، اذ أنها فرقت وفتتت وجعلت من رفاق السلاح أورفاق الوطن الواحد يتواجهون معا سواء ميدانيا ، أو سياسيا (خلافات الرفض والقبول، ثم حوارات ثم صراعات فاتفاقات عدن-الجزائر 1984م)، والافتراق على قاعدة فكرة الدولة والمنظمة والسلطة عام 1974 ثم 1988 ثم ما بعد مدريد 1991 و"أوسلو1993" ناهيك عن الاحتراب الداخلي كما حصل في الانشقاق عام 1983 ثم حرب المخيمات التي شارك فيها المنشقون والقيادة العامة والصاعقة ضد الموالين لعرفات كما كانوا يطلقون عليهم (1985-1988)، ثم كما حصل في الانقلاب عام 2007 من قبل "حماس" في غزة.
كانت الشخصية الآسرة (الكاريزمية) التي يتمتع بها ياسر عرفات وقدرته الحركية والاستقطابية الكبيرة، كما قدرته على عقد التحالفات والعمل الميداني عاملا ضابطا لاإتجاه البوصلة ، وموجها لتجاوز مثل هذه الأزمات والتناحرات وإن ظلت نيرانها كامنة.
أما على الصعيد التغيّرات الثقافية التنظيمية فاستطاعت حركة فتح أن تحتفظ بجسم عفيّ في الاقاليم –وإن تقلّصت في مراحل-خاصة تلك البعيدة عن الصراع الميداني الذي تقاطعت فيه مدارس ومذاهب القيادات، لأنه حيث وجدت القيادة بتناقضاتها انعكس ذلك على الكوادر إن لم يكن دورها أساسا قد سُلب لصالح المركز، وظهرت الأطُر الحركية في البعيد (في كوادر الوطن، وأقاليم الخارج بعيدا عن المركز) أكثر قدرة وشبابا وإيمانا بالفكرة الوطنية الثورية النضالية التي ظلت بالنسبة لها لامعة متألقة.
انتقل الثقل للوطن وحازت التجربة منذ الثمانينات، ثم إثر الانتفاضة الاولى انتفاضة الحجارة (1987-1993) على جذوة النشاط والاستئثار بالاهتمام والفعل حتى عادت القيادة الفلسطينية، وتعانقت نظريا تجارب الثورة الكبرى (خاصة تجربة القاعدة وتجربة الوطن ... ) ومازالت الى اليوم في بُعدها السياسي وبُعدها الثقافي وبُعدها التنظيمي وبعدها الميداني بحاجة لدراسة عميقة وتأصيل.
إن حجم الاخفاقات ان تم النظر اليها لوحدها فهي مما يثير الإحباط اوالسخط، وحجم الانتصارات برأي الفريق الآخر تجعل الظن يتجه نحو البُشرى بأننا قاب قوسين أو أدني من النصر النهائي، وفي كلا الحالتين نحتاج للاتزان وحُسن التقييم والمراجعة.
إن حركة فتح بعد 50 عاما من النضال استطاعت رغم عديد الاخفاقات والإشكالات والأزمات كما قلنا، أن تحتفظ بميزتين ذهبيتين أساسيتين كبيرتين الأولى: أنها جمعت الكلّ الوطني بعيدا عن العصبوية الفكرانية والحزبية المقيتة والعشائرية البغيضة تحت مظلة (الوطنية) التعددية ، أكان هذا الجمع تم في وعاء (الكيان) ممثلا بالمنظمة ثم السلطة بعد حركة فتح التي اختطت للنضال دربا صعباً يمازج بين تنكّب السلاح والقلم والحجر ومناهضة الظلامية، أو كان بمضمون (الفكرة) التي تجاوزت الأحلام الوردية بأولوية وحدة الأمة قبل التحرير، أو وحدة التقدميين أو المسلمين في العالم قبل الانطلاق كما نظّر الأخرين.
وجعلت الحركة من همّة العمل والمبادرة الخلاّقة مقياسا أساسيا، ومن التكرُس والتخصص والأولوية مع الإيمان عوامل خمسة رئيسة في بناء مفهوم الوطنية الذي لم يعني يوما حب الوطن المفروغ منه لدى جميع الفلسطينيين . بل كانت الوطنية في المسرح العربي إطارا جامعا مكرّسا للقضية من قبل الفلسطينيين والعرب والأمة جمعاء. وتعدت ذلك لتجعل من مفهوم الوطنية الذهبي الجامع والشامل منبرا للانفتاح الحضاري لا التقوقع والعزلة، ومحطة إطلالة بتميز حضاري عربي إسلامي على المحيط التقدمي بعناوين المدنية المؤمنة والمشاركة الديمقراطية والحقوق الثابتة.
أما ثانيا فلا زالت حركة فتح -ضمن صفات كثيرة أخرى- تحتفظ بألق البدايات الذهبي، وبريق البدلة المرقطة للفدائيين مع سِحر الكوفية السمراء والحجر المقدس، وصيحات بلادي، بلادي، وثمار الزيتون وأغنية أنا صامد صامد، وطلّ سلاحي من جراحي، ومع لوحات الفنانين الكبار وأصوات قريض الشعراء المحلق في سماء النفوس،ومع عبق بحر غزة وجبال الجليل ونابلس، ومع كتابات المفكّرين والاعلاميين والأدباء التي بالدم سجلت لفلسطين الخلود، مع الثوب المطرز الباهي، ومع حبة الجوافة والبرتقال وسنبلة القمح وثمار العنب والرمان لتكوّن هذه اللوحة بتنوعها، وقد يراها البعض بتناقضاتها-وهل الانسان أو الجماعة أو المجتمع إلا مجموعة من كل ذلك – تمثل فلسطين في رداء ثورة، وفلسطين في عباءة حركة فتح، فلم تَحِد عن هذه النظرة أو الثقافة الجميلة، ولم تتعب كثيرا لتعرّف نفسها فكريا كما تعِب اليسار واليمين في محاولات عقيمة للتميّز عن حركة فتح الوحدوية وعن فكرة فلسطين الشمولية.
اختار الناس حركة فتح لأنها تشبه الإنسان الفلسطيني الثائر الصبور، ولأنها تشبه رائحة التراب الوطني المثقلة بالندى، أو لنقل لأن حركة فتح -بكل بساطة- تشبه فلسطين، بتنوعها وغناها وجمالها، فكلما ظل الشبه باديا كلما تواصلت الحركة واستمرت ودامت.
بعد 50 عاما تجد حركة فتح نفسها مازالت في أول الطريق الذي كان لها شرف أن عبّدته بدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى وكل المناضلين من كافة الفصائل، ولأن الطريق طويل والتضحيات لا تتوقف ، فإن الحركة إن كان لها أن تصل نهاية هذا الطريق فإن أمامها مهمّات جِسام على صعيد البناء الثقافي التنظيمي الفكري التاريخي الحضاري جنبا الى جنب مع النضال السياسي القانوني الاعلامي والجماهيري إذ لا يمكن لمقاتل أو مناضل أن يحمل سيفه ويجرّده في وجه عدو ولا يعرف لماذا ؟ وإلا لتحول لقاطع طريق.
ولا يمكن لقضية أن يستمر وقودها محرِّكا دائما لها إن لم يكن هذا الوقود صالحا لأن يجعلها تقطع المسافة المطلوبة دون أن يصيب الجسد العطب في منتصف الطريق.
تحية لجميع الثوار والمناضلين والمجاهدين في فلسطين والأمة، ولكل الأحرار في العالم، وليكن اليوبيل الذهبي لانطلاقة لثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح بداية حقيقية لمراجعة شاملة ونظرات تقييم حقيقية ودارسة جادة للبدائل في زمن صعب بدأ يحاصرنا في أطراف الأمة وجوامعها ووسطيتها.



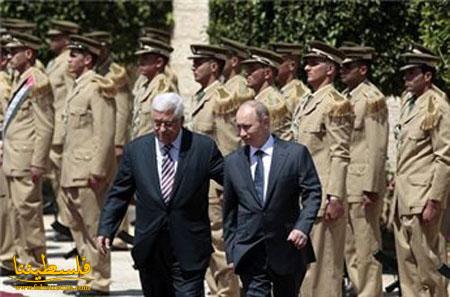




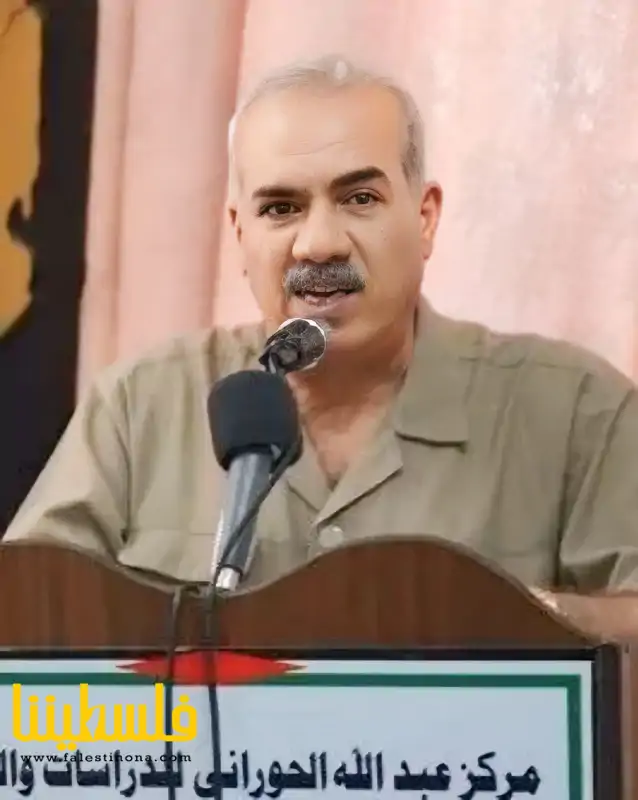






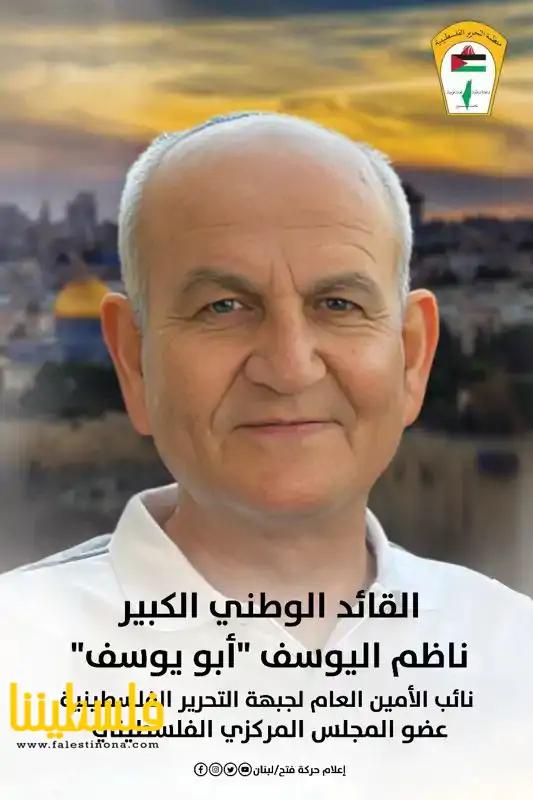

تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها