الشاعرة الفلسطينية نهى عودة
"مريم" امرأة فلسطينية تعود أصول عائلتها إلى قرية "صفوري" من قضاء الناصرة عروس الجليل، وُلدت خلال عام 1969 في مُخيّم "شاتيلا"، بمدينة "بيروت"، وهو مُخيّم دائمٌ للفلسطينيين أسّسته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949.
كانت "مريم" البنت الصغرى في عائلةٍ تتألّف من سبع بنات وثلاثة أولاد، وُلدوا جميعهم في المخيّم، إضافة إلى "عبد الله" الذي وُلد في فلسطين ومات فيها صغيرًا، فلم يشأ له القدر أن يُهجّر مع عائلته إلى لبنان عام النكبة 1948.
تروي "مريم" قصّتها قائلةً: "أمي تزوّجت في فلسطين، ثم خرجت منها مع المُهجّرين، وهي في السادسة عشر أو الثامنة عشر من عمرها. في عام النكبة، لجأت عائلتي، مثل كثيرٍ من العائلات التي كانت تقطن في شمال فلسطين، إلى جنوب لبنان. بدأت مأساة التنقّل من منطقة لبنانيّة إلى أخرى.. حتى استقر الأمر بالعائلة في مخيّم "نهر البارد" في شمال لبنان قريبًا من الحدود اللبنانية السورية. مكثت عائلتي هناك لسنوات طويلة، ثم تجدّدت مأساة التنقّل والنّزوح مرّة أخرى، وانتهى بها الأمر إلى مخيّم "شاتيلا" في بيروت.
في بادئ الأمر، أقامت عائلتي في شوادر (الخيمة)، وكنت لم أبصر النُّور بعد. وكان بناء وتعمير البيوت ممنوعًا على المُهجّرين اللاجئين الفلسطينيين، واستمرّ هذا المنع إلى سنوات طويلة عانى فيها اللاجئون من ظروف الطبيعة ببردها وحرّها ورياحها وأمطارها.. في خيام بائسة، إضافة إلى معاناتهم اليوميّة من أمور كثيرة، أقلّ ما يُقال عنها بأنَّها أساءت إلى إنسانيتهم. وبعد سنوات المنع، سمحت لهم الدولة اللبنانية أن يبنوا بيوتًا بشرط أن يكون سقف البيت من صفيح "زينكو"، كما حدّثتني أمّي. وكان التحمّل والصّبر على تلك الحياة البائسة مشفوعًا بأمل العودة إلى أرض الوطن فلسطين الحبيبة.. وفي يومٍ ما من شهر ما في عام 1969، انضممتُ إلى قافلة اللاجئين الفلسطينيين، واختارت لي عائلتي اسم: مريم".
أسئلة كثيرة بدأت تتفتّح في ذهن "مريم" وهي في الثامنة من عمرها، كانت ترصد حركة الحياة في المُخيّم، وتُنصت إلى الأحاديث اليوميّة التي تدور بين الكبار حول فلسطين والديار البعيدة وحكايا التّهجير.. ومن تلك الأسئلة: هل هذا منزلنا؟ ماذا نفعل هنا؟ هل هذه أرضنا؟ ما معنى وطن ولاجئين واحتلال؟ وغيرها من الأسئلة التي تُسرّع في نُضج طفلةٍ كان يُفترض أن تحتض دميتها وتنام مطمئنّة!
لم تبحث "مريم" عن أجوبة لأسئلتها وتركتها مُعلّقة في ذهنها، ربّما لأنّها كانت تستشعر بأنّه لا ضرورة للبحث عن الأجوبة فهي مبثوثة في كلّ مكانٍ من مُخيّم "شاتيلا"، في عيون النّاس، في غبار المكان، في الآهات التي تُفلت من الصّدور وكأنّها أطيارٌ من حرقةٍ وحنين..











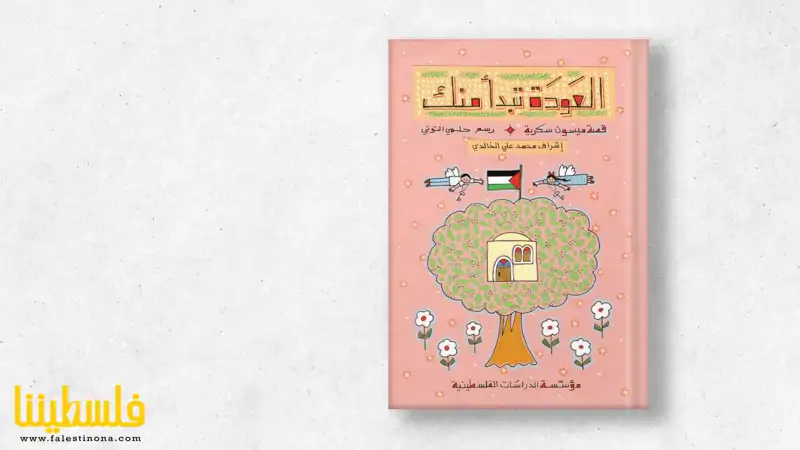



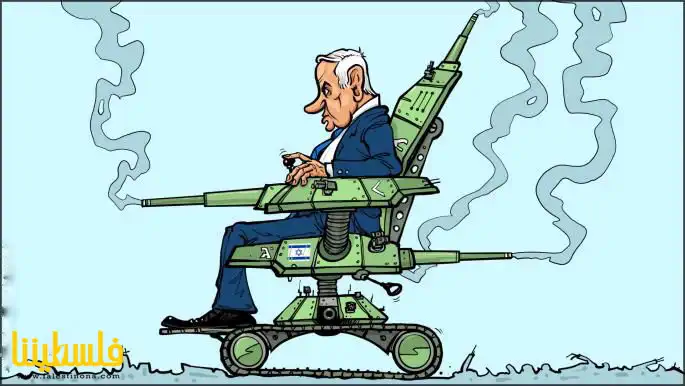


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها