خاص الفدس- تحقيق/ غادة اسعد
هي مأساةٌ أكبر بكثير من أن يتجاهلها التاريخ أو يقفز عنها المسؤولون ويمروا بقربها مرور الكِرام، لكن في دولةٍ قامت على القتل والمجازر، لم يكُن مُستهجنًا بالنسبة لأهالي صندلة والمنطقة إسكات الصوتِ والصرخة والبكاء وحتى النحيب على مَن قُتلوا بقذيفةِ من مخلّفات الحرب، لا ذنب لهم فيها سوى أنّهم أطفالٌ بعمرِ الورد، يُحبون الحياة، ويلهوْن بكل جديد، يدفعهم إلى ذلك حُب الاستطلاع الطفولي البريء.
في قلوب أبناء القرية حزنٌ وحسرةٌ وجراح لا تمحوها أيّ تفاصيل جديدة - منذ أن وقعت المأساة/المجزرة في السابع عشر من أيلول عام 1957، فخلّفت 15 طفلاً شهيدًا وثلاثة جرحى، بعضهم لا يزالُ حيًا، يبكي المشهد الذي يُرافقه مدى الحياة.
وصندلة قرية تقع في مرج ابن عامر، وبقربها المقيبلة أيضاً، وهما تابعتان لنفوذ مجلس "جلبوع" الإقليمي. أما تعداد سكان القرية في حينه، فكان يُقارب الـ350 نسمة، فيما يصل عدد السكان اليوم إلى ما يتجاوز الـ1600 شخص.
عمل سكانُها قبل الاحتلال وبعده بالزراعة والفلاحة وتربية المواشي، كمصدرٍ أول للعيش، قبل أن تتطوَّر الصناعات المهنية الأخرى. ومنذ وقوع الاحتلال الإسرائيلي، سلبت إسرائيل مساحاتٍ مِن الأراضي التي كانت تابعة للقريتَين (المقيبلة وصندلة)، وصادرتها لصالح المستوطنات اليهودية.
أم يوسف عمري: يوم في حياة ابني أعزّ علي من هذه الدنيا!
في بيتها المحاذي للشارع الرئيس في قرية صندلة، التقيتُها، الحاجة رسمية ذياب المحمد عمري (أم يوسف)، عجوزٌ تجاوزت الـ85 من العمر، تتطالعك ببسمة يُخالطها الحزن الشديد على رحيل ابنها قبل 65 عاماً على استشهاد ابنها يوم كان في الثامنة من العمر.
وعن مأساتها تقول: "خسارةُ الأطفال في المجزرة ليست خسارة للأجساد فقط، بل خسارة لأولادٍ أذكياء كانوا يحبون التعليم، وقد أسمينا ابن ابني عبد المجيد، على اسم "يوسف" الغالي علينا. واليوم كبر يوسف وتزوج وهو يعمل صيدلانياً في تل أبيب، وحين ألمحه، يذكّرني بيوسف الحنون الذي كان جبارًا قويًا وحنونًا إلى يوم استشهاده رغم صغر سنه ، فأبكي لكن بصمت".
أمَّا حول ردة فعلها يوم علمت بالخبر فتقول: " كنت صاحية ومش صاحية، واعية ومش واعية، بس متخيلة ملامحه، كان وجهه حلو، كان شاطراً في المدرسة، حنون، الحمد لله انه الله أعطاني أربعة، كلهم بحفظ الله، والله يستر على اخواتهم، ويكفينا شر اللي شفناه، وعندي لحظة من يومه بتسوا كل الدنيا. يومها جابولي إياه يا ميمتي بكيس، يا ويل حالي، استعجلنا وما قدرنا نستنى روَّحولي اياه ع البيت للصبح دفناه مع بقية الشهداء".
لتضيف بلهجتها: "الإم يا بنيتي مش مثل الأخت والخالة والعمة ولا حتى الأب. الإبن بالنسبة للأم هو قلب القلب، كان غالي عليي كتير، وسبحان الله ولا بخلق ربنا ولد في حنيته، كان فهمان، وكنت لما أزعل ع غيابي عن أهلي، كان يقعد جمبي ويواسيني، ويقللي اعتبريني سيدك واخوكي وأمك وكل عيلتك، يمسح ع وجهي بحنية، الله يرحمك يا يوسف يا حبيبي". تتنهد ثم تصمت، كأنّما حمل ثقيل يجثم فوق قلبها الموجوع.
مصطفى عمري (أبو ناظم): بالإرهاب منعونا مِن إحياء ذكرى المجزرة
أبو ناظم، واسمه الكامل الذي يُحب أن يؤكِّده حفاظًا على شجرة العائلة (مصطفى حسن أحمد عُمري)، شغل وظيفة مُدرّس لأطفال قريته، حتى وصل إلى التقاعد، ليتفرّغ للقراءة والتثقُّف، والتحقيق المنفرد ونقل رواية مجزرة صندلة، بلسانِ مَن عايشها، فكانَ يصحب أحد أبنائه ويُسجّل اللقاءات بآلة التصوير صوتاً وصورةً، ليحفظ تاريخ القرية، ومأساتها مدى الدهر.
وأبو ناظم من مواليد العام 1938. أنهى دراسته الثانوية في مدينة الناصرة، والتحق بدار المعلمين في تل أبيب، فكان لوقع استشهاد شقيقه الأصغر يحيى حسن أحمد عُمري، مدلّل العائلة ومحبوبها، أثرٌ كبير في مسيرة حياته واهتماماته.
يتحدَّث أبو ناظم عن المدرسة التي هُدمت بعد الحادث وتحولت إلى حاجزٍ عسكري (نقطة ارتباط)، إذ يقول: "في 17 أيلول عام 1957، وأذكُر تمامًا أنّ الحادثة وقعت يوم الثلاثاء، عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، عاد التلاميذ لمدرسة "التتر" الابتدائية، وهي قائمة منذ زمن الانتداب، بعد أن كان الأطفال قد بدؤوا بمسيرتهم التعليمية في العام 1952، بعد توقفٍ دام عامين، بفعل الاحتلال، وعُيّن عدد من المدرسين من بينهم: صالح عبد القادر محاجنة، د. سامي دبيني، فوزي جرايسي، سمير ورور، نعيمة سمعان". يومها غادر معظم الطلاب صفوفهم ولكن 17 طالبًا، بينهم 15 طفلا رحلوا في دقائق. أنا كُنتُ أدرس في الناصرة، وسمعتُ النبأ في ساعةِ باكرة من صباح اليوم التالي، الأربعاء، لكنّ جميع أبناء القرية تناقلوا التفاصيل المؤلمة ذاتها: "على بُعد 200 متر من مدرستهم، وُجَد الأطفالُ جسمًا غريبًا لامعًا، على حافة الطريق، ومِن شدة حُب الاستطلاع الطفولي، اقتربوا منه وظنوه شيئاً مسلياً، ينشغلون باكتشافه، وفي لحظةٍ انفجرت القنبلة، واستشهد معظمهم، وبقي ثلاثة من الجرحى يئنون وجعًا، وخوفًا وقهرًا، تطايرت الأشلاءُ في لحظةٍ وانعقدت في المكان سحابةٌ سوداء كثيفة من الغبار الـمُشبع برائحة الدمِ الساخِن والبارود. منظرٌ رهيبٌ ومفزع لكُل مَن عايشه ولمحه من بعيد، وصوتٌ وصلَ كُل بيوتِ صندلة، حيثُ لا مصادر إزعاج، ولا وسائل نقل، سوى الحكام العسكريين الذين يُراقبون المواطنين ويفحصون تصريحاتهم طوال الوقت، بعضُ الطلاب تأخروا في مدرستهم، وفي طريق عودتهم رأوا مشهداً مرعِباً، أحشاء زملائهم مقذوفة بعيدة عنهم، ورؤوس وأطراف متناثرة في كل الأرجاء، ففقدوا وعيهم، وضلوا طريقهم".
النساء رقصن وهُن يحضن جثث أطفالهن!
مِن بين شهود العيان الذين لا يُمكنهم نسيان المشهد الرهيب الذي صادفهم، الأستاذ د. سامي دبيني، الذي كان عائدًا من المدرسة، حين رأى طلابه متناثرين في المكان، أجساداً ممزقة، وأحشاءً خارج الجسد، وأطرافاً متناثرةً، وبقايا أجسام في حفرة يصل عمقها إلى المتر ونصف المتر. كانوا وعلى ظهورهم بلا حراك، فيما بعضُ الأقدام تنتفض، وفي المكان دفاتر مبعثرة، وأقلام رصاص، ودفاتر يغطيها السواد، مشهدٌ لا يفارقُ أساتذتهم.
أمَّا عن شقيقه فيقول أبو ناظم: "وجدوه ممزق البطن، وأحشاؤه خارج جسمه. كذلك حدثتني صبية من بنات القرية، استشهد ثلاثة من أشقائها (آمنة وطالب وغالب)، فقالت أنها كانت أول من شاهد الحادث، إذ انها كانت ترعى العجول والماعز، حين سمِعت الانفجار، فذهبت في الحال، ووجدت شقيقها هناك، فقال لها: "بدي أموت يا اختي"، تحدث وأحشاؤه ممزقة، فحضنته شقيقته، وفارق الحياة".
يتابع أبو ناظم: "مشهدٌ مؤلم، حينَ عُدت إلى البيت في صندلة، يوم الأربعاء، ووجدتُ أبي وأمي في أسوأ حالاتهما، والقرية كلها تئن، وتصرخ، استقبلت العائلات أبناءها في أكياسِ الموتِ ومِن هول الصدمة، رقصت النساء وزغردن وهللن بطريقةٍ هستيرية، لا يُمكن وصفها، إلا صعقة المُصيبة المفاجِئة. وعِند المقبرة، كانت الأمهات تَنُحْنَ، وتُعددن مناقب أمواتهن، ووقتها سمعتُ أمي تقول: "ثوبَك جديد يا يحيى بعدك ما لبستو، الدفاتر جديدة، أبوك جبلك دفترين، ما كتبت عليهن يا حبيبي يا يحيى، اكتب يا يحيى، وشو بدو يسع الدفتر والكتاب من هالحياة".
مبررات واهية وكذبٌ مبطَّن
رغم المأساة التي أصابت البلدة، ظل الحاكم العسكري يقف عند مدخل البلد، ويفتش البطاقات، ولا يسمح لغير أبناء القرية بدخولها، وطالب العائلات بالصمت وقبول قضاء الله، وكتبت الصحافة العِبرية عن الحادث باعتباره عاديًا بفعل مخلفات حرب العام 1948، كما غطَّت "الاتحاد" اليومية تفاصيل المجزرة وتابعته باهتمام وظلّ الحكم العسكري جاثمًا على صدر الفلسطينيين، في كل مكان حتى العام 1968، أي بعد 11 عامًا من وقوع الحادث.
وفي ردٍ على سؤال حول سبب عدم كشف الحقيقة قال أبو ناظم: "أهالينا كانوا كبار السِن، واعتادوا على الحرب والخوف ومعاملة الحكم العسكري الصعبة وتضييق التحركات، إضافة إلى محاولة تبرير المُصيبة، من خلال بيان وزعوه جاء فيه أنّ الحادث قضاء وقدر، وأنّ القذيفة هي من مخلفات الحرب، (مدعيًا أنّ الجيش الأردني يتحمل المسؤولية عن القذيفة باعتبارها تابعة لهم) وكأنّ الجيش الأردني كان يملك قذائف متطورة، كالتي جنت على أطفالنا. وعلمنا أنّ قوات الأمن والجيش قامت في اليوم التالي للحادث بتمشيط المنطقة وعثرت على قذائف أخرى، تمّ تفجيرها، وقد سمعنا التفجيرات أثناء توديع أطفالنا الشهداء".
وعن سبب صمت والديه قال أبو ناظم: " تأثر كلا والدي بوفاة شقيقي يحيى، وبكياه طويلاً، حتى آخر يومٍ في حياتهما، لكني لا أعتب عليهما لأنهما صمتا ولم يفعلا شيئًا للبحث عن الحقيقة، بل أعذرهما لأنهما عاشا حياة قاسية طوال حياتهما، فقد ذُقنا وإياهما الأمريْن، بفعل التهجير واللجوء، حين ذهبنا إلى الجنوب عام 1948، وشهدنا معركة جنين، التي جرت فوق رؤوسنا، وكانت والدتي رحمها الله، تطلبُ مِنا وضع أحذيتنا تحت الوسادة، لننتعلها سريعًا، عندما تشتد الحرب، ويبدأ الاحتلال بإطلاق القذائف دون رحمة".
المتسبِّبون بالقتل تناسوا فعلتهم
يقول أبو ناظم: "مؤخرًا علمتُ بتفاصيل جديدة مختلفة تمامًا عن حديثهم السابق، وتبريرها بمخلفات الحرب لعدم محاسبتهم محليًا ودوليًا. ونحنُ نتحدث عن منطقة تابعة للجلمة في الضفة الغربية، استولى عليها الاحتلال وصادر الأرض التي اعتُبرت أملاك غائبين، ومساحتها 3000 دونم، وقد حُوّلت إلى مزرعة تابعة للوكالة اليهودية، ومِن حُسن حظي أنني وصلت إلى بيت مدير الوكالة اليهودية في العام 1957، عندما وقعت المجزرة، فقد زُرته في بيته ووجدته يستعد لنزهة مع زوجته مشياً على الأقدام، وقد بدا وزوجته في الثمانينات من عمرهما، عرَّفته على نفسي، فأصرّ على دخولنا بيته، وقال لنا بكل ثقة: "انتو معرفتوش؟!"، وبدأ بسرد ما حدث يوم وقوع حادثة الانفجار – قائلاً: "كُنت أنتظر العمال (الحصادّين)، في موسم زراعة الذرة الحمراء، (سُرغم بالعبرية)، أردتُ عدّ الأكياس الجاهزة، صعدتُ إلى الجرّار، مع العمال، ورأيتُ القنبلة بين الأكياس، قلتُ للسائق: ما هذا؟! قال أنه جرن حجري يُستعمل لدق البليلة (وهي مِن طقوس الاحتفالات اليهودية أيام السبوت)، فقلتُ له بحزم: هذه قنبلة، تنفجر، تعمل (بوم)، وتقتُل ارمِها بسرعة، وكان السائق عراقياً (كردياً)، فوقف بسرعة على جانب الطريق، وقام برميها على جانب الطريق. وتابع مدير الوكالة اليهودية سابقًا (بيسح) شهادته التي حدثني إياها: "في اليوم التالي جاءت الشُرطة، باحثةً عني، ونبهتني ألا أذهب إلى صندلة خوفًا مِن الاعتداء علي وعرفتُ أنّ 15 طفلاً قتلوا في الحادث، حيثُ ألقينا القُنبلة"، سألته (يقول أبو ناظم)، عن سائق الحصادة فأعطاني عنوانه وأخبرني أنّ اسمه "افراهام أهارون"، وقد التقيته فحدثني بنفس الرواية أنه أراد استخدام القنبلة (الجرن الذي عُثر عليه) لنقع قمح البليلة فيه، والأخير أهارون، أبلغني أنّ العامل الذي رمى القُنبلة تُوفي منذ فترةٍ".
وأضاف أبو ناظم: "هكذا تكشفت الحقيقة أمامي كاملةً، إذ تأكدْتُ أنّ مدير الوكالة اليهودية وعماله مسؤولون بطريقةٍ أو بأخرى عن جريمة قتل الأطفال، وان أحداً منهم لم يتحمّل مسؤولية فعلته، ولم يكشف عن تفاصيل ما حدث للرأي العام اليهودي أو العربي. وفي العام 2008، تمّ تشكيل لجنة من أهالي الشهداء وكنتُ أنا واحدًا مِن أعضائها، حيثُ توجهنا لمركز عدالة القانوني، لفتح ملف ضد المسؤولين في الحكومة، وقد أُرسلت نُسخ لكافة الأجسام في الحكومة الإسرائيلية، لكن بعد المداولات أمام القضاء تمّ إغلاق الملف مِن قبل مركز عدالة، بادعاء أنّ قانون التقادم يسري على هذا الملف، وهكذا تنصَّلت الحكومة وتنصَّل المتسبِّبون بالكارثة مِن فعلتهم".
قريبًا نصبٌ تذكاري، ومسيرة سنوية في صندلة
في الثالث عشر من أيلول الماضي، جرت في قرية صندلة مسيرة إحياءً لذكرى الشهداء في مجزرة صندلة، انطلقت من 13 أيلول 2013، وقام الأهالي بمشاركة عدد من الشخصيات الاعتبارية وعلى رأسها الشيخ رائد صلاح، وبعد الصلاة، تمّ التوجه إلى المدافن، حيثُ قُرئت الفاتحة لأرواح الشهداء، بانتظار أن يتم قريبًا إقامة نصب تذكاري إحياءً لأرواح شهداء صندلة.
*أسماء شهداء المجزرة
آمنة عبد الحليم عمري (10 سنوات)، طالب عبد الحليم عمري (13 سنة)، غالب عبد الحليم عمري ( 8 سنوات)، محمد عبد الله عمري (13 سنة)، فؤاد عبد الله عمري (8 سنوات)، اعتدال عبد القادر عمري (9 سنوات)، رهيجة عبد اللطيف عمري (8 سنوات)، سهام زكريا عمري (8 سنوات)، وصفية محمود عمري (8 سنوات)، عبد الرؤوف عبد الرحمن عمري (8 سنوات)، فاطمة أحمد يوسف عمري (10 سنوات)، فهيمة مصطفى عمري (8 سنوات)، محيي الدين سعد عمري (9 سنوات)، يوسف أحمد محمد عمري (8 سنوات)، يحيى أحمد حسن عمري (9 سنوات).
















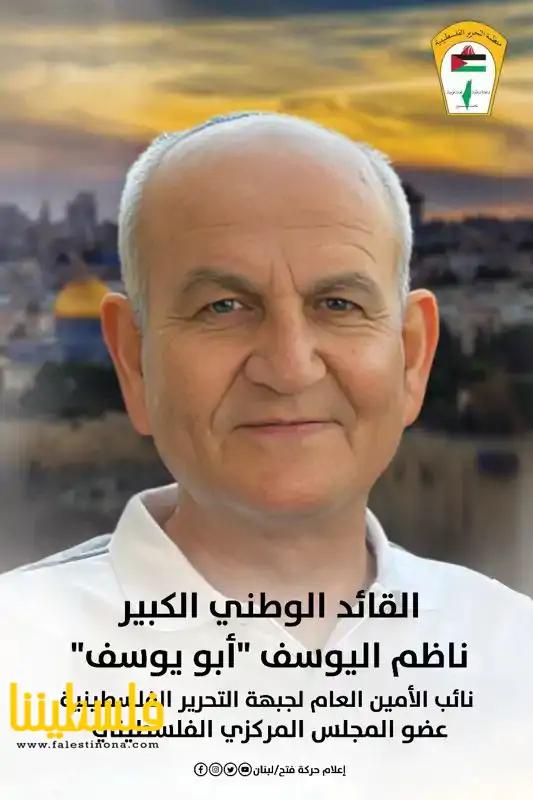

تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها