ربما تكون هذه، هي البشرى الخامسة والعشرين، التي زُفت الينا، محمّلة بالنبأ اليقين، عن خطوات وشيكة على طريق المصالحة. في المرات السابقات، كنا نستذكر طيراً لئيماً يسمونه في الأرياف والبوادي العربية «مْلهّي الرُعيان». وكانت قناعتنا أن «حماس» تخادع وتأخذ الطرف الوطني بعيداً عن مسؤولياته وتنغص حياته وتحبطه. وقد شرحنا مراراً كيف أن الطير مضرب المثل، يتدرج في قفزاته ومشيته، ويقلل من طيرانه. فعندما يراه الراعي على هذا النحو، تأخذه الغواية ويتملكه التفاؤل، فيهمُّ بإمساكه ولا يمسكه. لكن الطير لا يغادر بعيداً، بل يتدرج أو يقفز قفزة صغيرة، كأنما يدعو الراعي الى المحاولة مرة أخرى، بدافع الظن أن عدم الإمساك كان بسبب خطأ منه. وبحكم بقاء «مْلهّي أو مسهّي الرعيان» قريباً كأنما هو في المتناول، يقع المسكين في غوايته مرة أخرى، فيقفز اليه فيما الطير على بُعد ذلك المتر القريب. هكذا دواليك، حتى يرتسم واقع آخر بالمحصلة: يبتعد الراعي عن ماشيته التي ربما يسلبها لصوص الحلال، وهي مسؤوليته، فيما يتسلى الطير بمراحل انتقاله القصيرة المتتابعة، من موضع الى آخر، بقفزات تُغري بملاحقة لا جدوى منها!
ربما هذه هي المرة العاشرة، التي استذكر فيها ذلك الطير، الذي جئنا باسمه العلمي وبأوصافه وعاداته وعلاماته الفارقة، ضمن ما يسمونها فصيلة «طيور السيّد» Nightjars الشفقيّة البارعة في التمويه، والناشطة قُبيل الغروب.
في ثنايا البُشرى الأخيرة، قيل إن اتفاقاً توصل اليه الوفدان الفتحاوي والحمساوي برعاية مصرية، على أن تُمنع التصريحات السلبية من جانب الطرفين. وفي كل مرة، وبدون الاتفاق على هذه النقطة، كنا لا نكتفي بكتم توقعاتنا السلبية وحسب، وإنما نختلق توقعات إيجابية لعل قلوب الحمساويين ترق للمصالحة ويكون لنا شرف نيل الرضى ممن تعاطينا معهم كأنهم صناع التاريخ، الذين لم يتركوا وادٍ ولا جبلاً ولا معركة ولا مرحلة ولا معسكراً ثورياً، دون الحضور المدهش فيه، وتعطيره بالفرقانات الحاسمة، فيما نحن متفرجون ولم نبذل شيئاً. لقد وضعناهم في المستوى الرفيع، وتجازونا عن آثامهم، وتناسينا أنهم بالمعيار التاريخي للنضال الفلسطيني ما زالوا عابري سبيل، وخطّائين غير توابين. وعلى الرغم من ذلك ظل هؤلاء يستأنسون بموجة صعود «الإخوان» وكأن الموج هو واقع الشطآن الراسخ، لا العابر المتبدل!
لا أعلم ما إذا كانت قد تبقت بعض الأغنام في حوزة الراعي، لكي نسترعي انتباهه مرة أخرى لطبائع الطير. كما لا نعلم، ما إذا كانت مستجدات السياسة، قد اضطرت «حماس» لأن تتمثل مخلوقاً نبيلاً لا طيراً مخادعاً. إننا نأسف فعلاً، لكون «الجماعة» في فلسطين، لا تتعلم الدرس المفيد إلا عن طريق «جماعة» شقيقة، علماً بأن العلوم هي العلوم، ودرس الحساب هو درس الحساب، في نيكاراغوا وفلسطين والسعودية والهند، وفي أربع جهات الدنيا!
ففي درس مبكر، قلنا لإخواننا الحمساويين، إن السياسة هي غير الخطابة. والمسؤولية هي غير البلاغة من فوق المنابر. ها هم يرون ويسمعون بأنفسهم، كيف وقفت السياسة بكل وقاحة، لكي تحاسب الخطابة وتجبرها على شطب بلاغتها والتراجع عن تزيّدها وشرحها. قيل في الخطابة ما قيل عن اليهود، بلسان الرئيس محمد مرسي قبل نحو ثلاث سنوات، أي قبل أن يتسلم دفة المسؤولية. ليت ما قيل كان كلاماً سياسياً، يضع النقاط على حروف الحقائق التارخية والراهنة، ويتمسك بموقف صلب تبرره السياسة نفسها. عندئذٍ لن تكون هناك مشكلة، طالما أن المحتلين ما زالوا يعربدون. بعد ثلاث سنوات، أطل الأمر الواقع برأسه، لكي يحُاسب السياسي على تفوهات الخطيب الذي كانه، فيلحس الأول مقاصد الثاني، في لقطة أخرى من لقطات محرجة تتوالى!
ما قلناه قبل سنوات نتمسك به. نريد كياناً سياسياً ديموقراطياً، يحتكر الحق الحصري في الإكراه أو في القدرة على الإكراه، لصالح المجتمع ولمصلحته، وبالقانون، ويستند الى دستور يكرّس العقد الاجتماعي، على أن تكون الإرادة الشعبية هي التي تحسم خيارات الناس في أشكال ووسائل النضال والحياة والبناء. ولا يشترطن أحد بمفرده، طبيعة الكيان الفلسطيني وطبيعة المصالحة. بل ننوّه حصرياً الى ضرورة أن يمتنع الجميع عن المزاودة التي تعادل الهروب الى الضبابية والتمحك بالمقاومة. فالحقوق المستلبة حقوقنا، والاستقلال الذي نسعى اليه هو شقيق روحنا جميعاً، والمحتلون الأعداء جاثمون على صدورنا جميعاً، فلا يزاودن أحد على أحد، ولا يتذرع طرف بألم أو بمظلمة، لكي يخلع من واجبات المصالحة واستحقاقاتها. إما أن نبدأ بهذا المنطق الذي يسري على الجميع، أو أن نعود لكي نتسلى بالكتابة عن «ملهّي الرعيان» الى أن تقرر الإرادة الشعبية، ربيعاً أو أمراً كان مفعولاً. إن هذه هي البشرى الأخيرة. ما سيجيء بعدها في حال ظهور نقيضها، لن نعتبره بُشرى، وإنما نبأ ينذر بأن لا أغنام تبقت في حوزة الراعي.









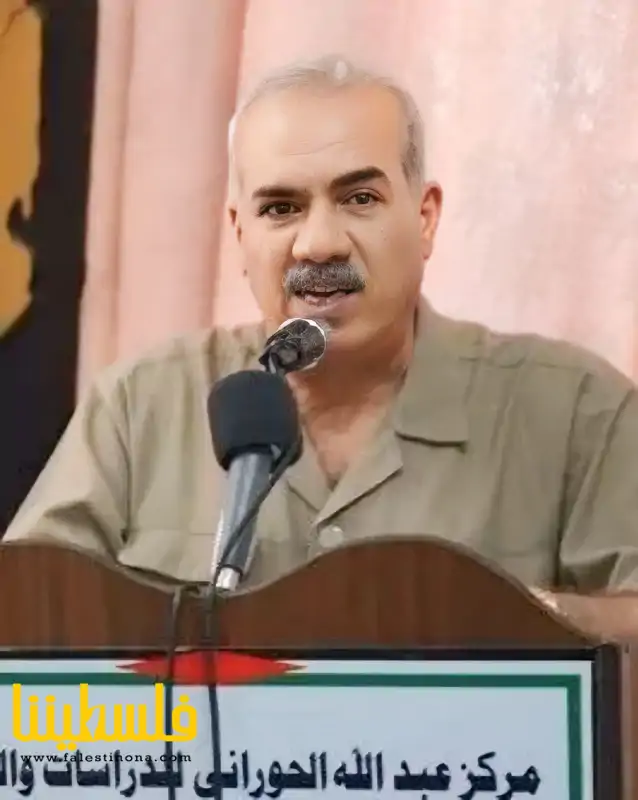






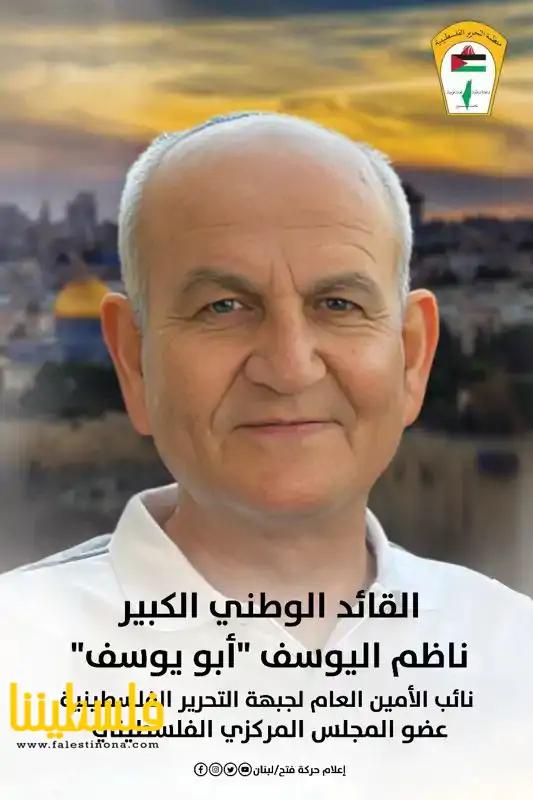
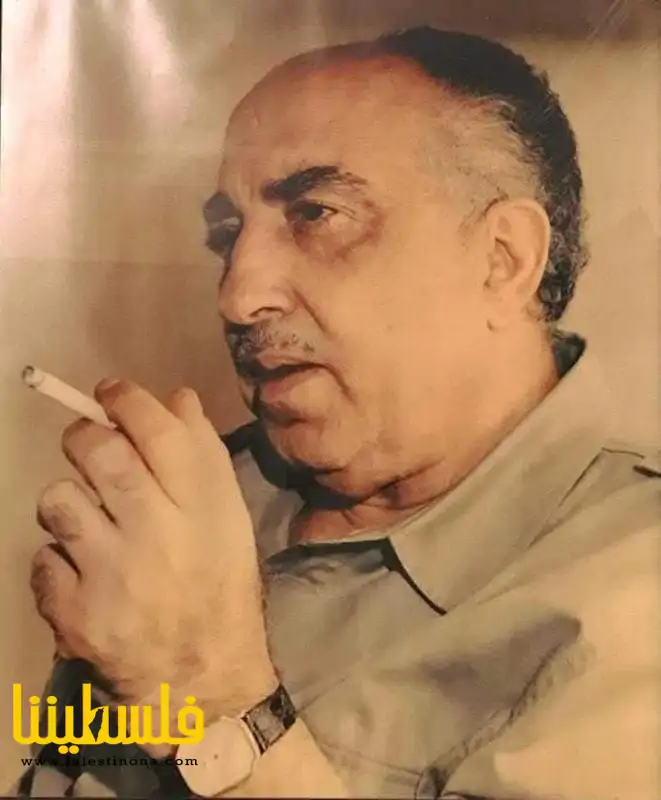
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها