تأتي الذكرى كما هي العادة السنوية في أجندة المناسبات الفلسطينية، ويأبى أيلول إلا أن يحمل معه ذكرى بشاعة القتل، وممارسة الذبح، وإبداعات السطو على الجسد الفلسطيني، والإمعان بتمزيقه بشتى السبل والوسائل.
وأيلول هذا قد صار شهرًا ينزف فيه الجرح منذ أن اعتلى القاتل منصة السادة الكبار، وصار يلوح بقبضته متوعدًا فقراء العصر، والمطاردين بين أزقة أحلامهم، والمطرودين من جنتهم، واللاجئين إلى جنان أرض الغير ليتشكل المشهد الإنساني الجديد، فلا يمكن أن تستقيم دنيا الإنسان دون لجوء الفقراء من جنان أرضهم إلى جنان الأخرين، وحيث ذلك فلابد من شهر للذبح والقتل وممارسة بشاعة المجزرة حتى يستوى فعل القتل وحتى نتذكر أن للإنسان اللاجئ أرض وربما جنة يبحث عنها وسط معاني التذكر والتذكير بالهم البشري، وللباحث عن وطن يستقيم معه فعل صراخه وممارسة ألمه وحبه ، والقليل من فعل الشياطين.
تأتي ذكرى المجزرة والسؤال مازال مطروحًا، وإجاباته معلومة ولا مجاهرة بالحديث أو كشف اللثام عن واحدة من أروع وأبشع الإبداعات في القتل والهمجية. وعلى لوحة لم يستطع غبار الزمن إخفاءها ولم يستطع التاريخ طمس معالمها، رغم القهر، رغم المعاناة، رغم الألم مازالت صبرا وشاتيلا على قيد الحياة وها هي المجزرة رغم السنون مازالت شاهدة لم تستطع النسيان.
مجزرة صبرا وشاتيلا، الجرح النازف، جرح شعب مازال يجمع أشلاءه، جرح أرض مازالت تأن وتصرخ كما هي الحال في مجازر الفعل اليومي لممارسات اخوة القيد والمعاناة وحلفاء الشيطان الجديد، التي نشهدها بالظرف الراهن في أزقة ما يسمى بالوطن الفلسطيني المحروم من استكانة ولو قليلة للملمة ذاكرة بشاعة القتل الذي كان في كل أمكنة لجوء من يحاول أن يحيا فوق الأرض وأن يمارس فعله الإنساني وحقه بأن يصرخ بأن له وطن وجنة على الأرض تسكن هناك بين ثنايا أنياب الشيطان.
بعد كل هذه السنوات نمارس فعلنا الأولي والمتواصل بأن نكتب مرثياتنا من جديد وبلغة قد نفهم أبجدياتها وربما نتوه بالمعاني وأساليب صياغة المفاهيم، بالعرف الفلسطيني يرتبط مفهوم القتل والذبح وفعل المجزرة بممارسة العدو وهذا العدو قد يكون ذاك الشيطان أو من يتحالف مع سدنته وخدامه المتطوعون في بلاط سادة القتل ووأد الحلم أن حاول أن يتشكل، أو أن يعبر الذاكرة وأن كان كمحاولة لاستكانة الذات أو إرضاء غرورها بأن تطوف عند قبور الأولين الذين صنعوا مجد أسطورة الزمن الجميل.
تبدأ القصة حينما تسللت الأنوار والأضواء الكاشفة بذاك الليل الحالك عتمة وسوادًا لتخترق العتمة ليبدو مشهد القتل والذبح أكثر وضوحًا، وأكثر إيلامًا للضحية وللمقتول ولمعصوب العينين وكأن المشهد الدرامي لابد من تسجيله وسط صرخات الثكالى ما بين الأضواء الكاشفة، وهنا تكمن حقيقة الأشياء الصارخة، القتل لابد أن يكون تحت الأضواء الكاشفة والفاضحة لكل العورات، وسيد القتل لابد له من أن يراقب تفاصيل التفاصيل لكشف المستور وتوجيه القاتل وادواته المغروزة باللحم الحي. كان لابد لهم من أن يرعبوا الضحية ورعب الضحية لا يستوي إلا بفعل نصل السكين والذبح بالسيوف والبلطات. وحتى تستوي الأمور أكثر لابد من شهود ليخبروا من بقي حيًا من أبناء وسخ المخيمات، فكان النجاة الذين عزفوا شهادتهم على دفاتر أزمانهم عويلاً وبكاء وصراخًا والشيء من الضجيج لعل مضاجع سادة العرب والعجم يتنبهوا أن ثمة مجزرة ترتكب هنا ورائحة الموت تنتشر بالمكان ولا ضير أن كان القليل من عطر الموت قد أزكم الأنوف. فالقاتل بحاجة لمن يوقفه عن القتل ويستصرخ كل ضمائرهم أن تعالوا واقفوني عن ممارسة القتل لذلك لا ضير أن تسلل القليل من أبناء الوسخ في ذاك المخيم.
هنا جلس من كان في المكان على تلة من الجثث محاولاً أن يستعرض المشهد من جديد، وفي محاولة لأن يفهم مجريات النسق السياسي الذي تبدل، وحيث هو يتفكر يأتيه من يلقي على مسامعه بيان العصر الجديد، وأساطير حكاية الضحية والجلاد، وتغير الأزمان، وكيف يصبح من ينطق بلهجة الفقراء على هامش البيان الرشيد.
وهنا حاول من حاول من أطفال البزازة ان يتنزعوا حلمات امهاتهم ليأخذوا منها قطرات من حليب، فكان للقتل الفعل الرحيم لأمهات سئمن الصراخ والعويل وكان أن جاءهن القتل بغفلة وهن يرضعن أطفال البزازة بذاك المساء حيث كن يحاولن سرد حكايا أقاصيص الرجال الراحلين للتو ببواخر كل اقاصي الدنيا، وقهقة من يعتلي منصة المكان تختصر كل بلاغات اوامر فعل التنفيذ.
وكان أن يأتي القائد المرصع بكل نياشين الأطفال الرضع أن استنكر وأنكر فعل المجزرة، وما هي إلا سنوات حتى عاد بطلاً من أبطال تلك الأزمنة، ليكون أحد لاعبي لعبة الرئاسة من جديد في بلد المجزرة وحاضنة الوسخين بوسخ مخيمات الشقاء والبؤس. وما هي إلا سنوات حتى يعود من جديد من تولى إضاءة الأضواء الكاشفة ليقرأ علينا الشيء اليسير مما كان يتوعد ويتهدد في ظل إنفلات وانقلاب موازيين الحلال والحرام في بلد الجبل والبحر والنساء الجميلات والكثير من عنفوان مقاومة الأشباح المتسترين خلف الأسماء ليهوذا الساكن بالمكان منذ أن بدات المجزرة تؤتي ثمارها.
حيث توالت ما بعدها كل المجازر وصار القتل للوسخين من أبناء المخيمات مشروعًا وممكنًا. بل لا تستوي حسابات ذاك البلد الطائفية وتلك المذهبية وحتى الأثنية والجمالية إلا من خلال ضرائب الدم التي لابد من أن تدفعها مخيمات الوسخين وهذا ما كان وما سيكون أيضًا حتى الأن.
هي قصة المجزرة وهي قصة ابادة الحالمين، ومحاولة لاستئصال فلسطين من ذاكرة المؤمنين بالأرض السمراء، وكل هذا من سفر تكوين حكاية المهاجرين باستمرار والقابضين على مفاتيح البيوت المعلقة بالصدور منذ أن كان العبور للزمن المجهول. وهذا الطبيعي فلا هجرة دون اشتياق، ولا عبور دون أن يتكون ويتشكل المجهول بالأذهان، ولكن أن نرتكب نحن المجزرة وتنقلب على ذاتها الضحية وتحاول أن تمارس فعل الجلاد، فهذا ما حاول أن أفهمه وأتفهمه هذه الأيام وأن نمارس القتل والذبح بحد السكين وعلى مرأى ومسمع من القاتل المتبختر الآن في شوارع البيروت والقادم إلى فعل السيادة والحرية والاستقلال، فهذا ما لا استوعبه الأن.
وما عسانا سنقول لكل من يحاول أن ينصر دماء شهداء المجزرة التي تكومت أجسادهم جبالاً بالطرقات ونحن نمارس أبشع أفعال القتل اليومي بحواري غزة وخانيونس ولربما أيضًا هنا حيث القدس الأقرب الى مرمى الحجر؟
بعد كل هذه السنين نعجز عن فضح القاتل من جديد، وممارسة فعل البكاء والعويل حيث أن الأحمر القاني ينزف الأن في حوارينا وعلى أرض البرتقال، وقد صار القتل محللاً باعتي الفتاوى الشرعية لجهابذة الخلوات الشرعية.
المجزرة الآن أصبحت خلف الحقيقة بعدما غابت تلك الحقيقة خلف الأفق كالشمس في ظل حقيقة القتل الأنية والراهنة لحملة بنادق ما يسمى (بالوطنية الجديدة)، فها هي المجزرة من جديد متواصلة بلا اسم، بلا عنوان، بلا قضية، محت أمواج الصمت الألوان ومات صدى الدماء في جوف الأرض، لنحاول أن نجمع تراث المجازر ونحصي أسماء القتلى ولربما أيضًا الشهداء.









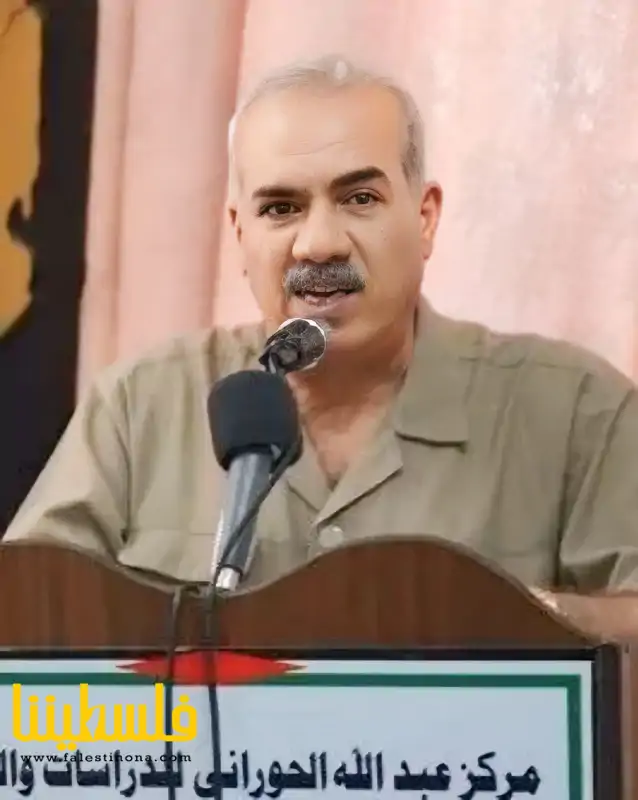







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها