بعد مضي شهر على بدء الاعتصام الطلابي في جامعة كولومبيا في نيويورك، ضد الحرب على غزة، تتصاعد حملات الاحتجاج الصاخبة في مئات الجامعات في العالم، منها عدد كبير من الجامعات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والسويد وألمانيا، إلى جانب جامعات في أستراليا وكندا والهند واليابان. وعبّر الطلاب في مظاهراتهم واعتصاماتهم عن غضبهم على حرب الإبادة الجماعية، التي تمارسها الدولة الصهيونية ضد أهالي غزة، وعلى الدعم الأميركي والأوروبي لها. ودعو جامعاتهم إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميًا واقتصاديًا، وإلى سحب الاستثمارات من الشركات التي تساهم في تزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد.
وفي كثير من الحالات تعرّض المتظاهرون والمتظاهرات إلى عنف الشرطة وقوّات الأمن الأخرى، واعتقل حوالي ثلاثة آلاف متظاهر. وحظيت المظاهرات الطلابية باهتمام إعلامي واسع، وأثارت نقاشا حامي الوطيس في الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية. وشن سياسيون، صمتوا على مجازر غزّة، حملة شعواء على الطلّاب واتهموهم بإثارة الفوضى وتعطيل الدراسة وحتى باللاسامية. ولم تجد قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة حرجا في أنّها تدعم حرب إبادة، ولكنّها لا تتحمّل ما تسميه «إثارة الفوضى» في الجامعات.
هناك إجماع بأن موجة الاحتجاجات الحالية هي الأضخم في الولايات منذ عام 1968، حين هبّ الطلاب دفاعا عن حقوق الإنسان ولاحقا ضد حرب فيتنام. وهناك اجماع أيضًا أن هذه هي أكبر حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي ـ الطلابي العالمي. ويستدل من شعارات الحملة أنّها ليست موجّهة ضد الفعل الإجرامي فحسب، بل إلى ماهية النظام المجرم أيضًا، فهي ليست محصورة بالتنديد بالحرب وبالدعوة لوقفها الفوري، بل تتطوّر لتطول عدم شرعية نظام الدولة الصهيونية، بوصفه نظام أبرتهايد، يقوم على الاستعمار والتهجير والإحلال والإبادة، فشعار «فلسطين حرّة من النهر إلى البحر»، هو مطالبة بتحرير قاطنيها من نظام قمعي ليصبحوا جميعًا أحرارًا، وهو بالتأكيد ليس شعارا «معاديا للسامية» كما تدعي أبواق الدعاية الصهيونية والغربية المتصهينة. تنطلق شعارات الحملة بالمجمل من الحافز الأخلاقي ولا تضبطها الحسابات والتوازنات السياسية، وما يزيد من وزنها وأهميتها أنّها تنطلق من نقطة قوّة الحالة الفلسطينية المركزية وهي السطوة الأخلاقية.
* ارتطام بالقيم
أصيب الطلاب، مثل غيرهم، بصدمة أخلاقية إزاء مشاهد الإبادة الجماعية في غزة، وثار غضبهم على الجريمة والمجرمين، وعلى كل من يدعمهم ويساندهم بشكل مباشر وغير مباشر. فكان ردّهم بالفعل الاحتجاجي المباشر ولم يكتفوا بالبوستات واللايكات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت خلال حملة الاحتجاج الطلابية من فرص «فش خلق»، إلى عامل مساعد في تحريك النضال. ومن الواضح أن الدافع الأخلاقي هو الأساس في هذا التحرك الطلابي، ليس أقل مما كان عليه في حراكات طلابية مماثلة، وقد استطاع الطلاب بشكل خلاّق تحويل المواجهة إلى الساحة المحلية، باتهام حكوماتهم بدعم الإبادة الجماعية في غزة، وبدعوة جامعاتهم لوقف الاستثمار في شركات مرتبطة بالحرب وبالاحتلال.
قبل عشرات السنين قال المفكّر الماركسي أرنست بلوخ، إن حركة الاحتجاج الطلابية تستند إلى مبادئ مشتقة مما سمّاه القانون الطبيعي القديم: «الناس الذين لا يعملون ليسوا بحاجة لتملّق مشغليهم» مضيفًا بأن هذا يختلف عن احتجاج بسيط على حالة اقتصادية صعبة. وفي الفترة نفسها، أشارت المفكّرة اليهودية الألمانية الأمريكية المعروفة حنا أريدنت إلى القانون الطبيعي الذي تحدث عنه بلوخ، الذي يتمثّل في «اللون الأخلاقي الواضح للحراك الطلابي»، وأضافت أن الاحتجاج في الجامعات جاء «تقريبا بدوافع أخلاقية خالصة.. وهذه حالة نادرة في حقل قوّة ومصالح فقط». ليس بالضرورة أن يعيد التاريخ نفسه، لكن شبح العدالة ما زال يخيّم على «الحالة الجامعية»، ولم يهجرها كما توهّم البعض. لقد كتب الكثير عن «الثورة الطلابية» في الستينيات، وما من شك في أن قسما من الطلاب المحتجين هذه الأيام، يستلهمون ميراث وروح تلك المرحلة وزادها الأخلاقي والسياسي والثقافي. وهذا يعكس طبيعة الحراك الطلابي الحالي، لأن هوية الحاضر تدفع للنبش عن دلائل لها في الماضي، وما تقتبسه من ماضٍ يصبح مكوّنا لها. والمشترك لحراك الطلاب اليوم والأمس هو البعد الأخلاقي المشترك، على الرغم من القضايا والسياقات المختلفة بشكلها المتعيّن. لقد هبت حملة الاحتجاج في الولايات المتحدة نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات حول قضيتي حقوق الإنسان وحرب فيتنام، وفي الوقت نفسه كانت «الثورة الطلابية» في أوروبا حراكا يساري المنحى حمل تمرّدا مزدوجا على سحق الإنسان تحت مدحلتي الرأسمالية والستالينية. وكان المشترك حينها والمتشابه معها اليوم هو «اللون الأخلاقي الواضح»، كما قالت حنا أردنت.
* نتائج ملموسة
تثير المظاهرات في الجامعات الأميركية قلقًا كبيرًا في الدولة الصهيونية وامتداداتها في الولايات المتحدة والغرب عمومًا. وينبع القلق من نجاح الحراك الطلابي في فرض نفسه على المشهد الإعلامي والسياسي، وفي تحقيق عدد من النتائج في غير صالح إسرائيل. ومن هذه النتائج التي حققها الحراك بسرعة منقطعة النظير: أولاً، المساهمة بشكل جدّي في إنهاء تهميش القضية الفلسطينية وفي رفع صوت المعارضة للسياسات الحكومية الأمريكية والأوروبية الداعمة لإسرائيل، وثانيًا، زعزعة الادعاء الإسرائيلي بأن النضال الفلسطيني هو «إرهاب»، وتصويره على حقيقته بأنه حالة تحرر، وثالثا، إثارة نقاش حاد حول تورط الجامعات في الاستثمار في شركات تزوّد إسرائيل بأسلحة الإبادة الجماعية، ورابعا، توسيع القاعدة الداعمة لفلسطين، لتضم المزيد من مئات آلاف الطلاب، وقسم من هؤلاء سيكون له دور سياسي واقتصادي وأكاديمي، قد يؤثر سلبًا على العلاقة بالدولة الصهيونية وبمؤسساتها.
أكثر ما تخشاه إسرائيل ومن يدعمها في الولايات المتحدة والغرب، هو نشوء جيل جديد يمقت القمع الإسرائيلي ويدعم مطلب الحرية الفلسطيني. والجيل هنا لا يأتي حصرا بمعناه البيولوجي، بل هو جيل تأثّر بحدث تاريخي كبير ساهم في صياغة وعيه ومواقفه. وتدل الدراسات على أن مرحلة «التأثّر» هي في عمر 17 إلى 25 سنة. ويخرج الجيل إلى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حاملا معه ما تبلور في ذهنه ووجدانه من توجهات ومواقف في «مرحلة التأثّر». وعليه ترى إسرائيل في الحراك الطلابي وما يعنيه وما يتبعه خطرا استراتيجيا من الوزن الثقيل، وهي تسعى لمحاربته بشكل محموم.
* تهمة اللاسامية
لم تجد الدعاية الصهيونية الإسرائيلية والأمريكية، ما تقوله في الرد على الانتفاضة الطلابية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية في غزّة سوى تهمة معاداة السامية، ووصل الأمر إلى طرح قوانين جديدة في الكونغرس لمحاربة اللاسامية كأداة لتسهيل تكميم الأفواه ومحاربة الحق في الاحتجاج.
وتدأب قنوات التلفزيون الإسرائيلية على بث مشاهد يومية للمظاهرات الطلابية المناهضة للحرب على غزة، ولكنّها تحشرها في خانة اللاسامية ومعاداة اليهود. ووفق المنطق الإسرائيلي تصبح المطالبة بوقف الحرب وبالحرية لفلسطين والتنديد بقتل الأطفال ضربا «خطيرا» من اللاسامية. ويأتي على المنوال نفسه، معظم ما تنشره وسائل الإعلام وما يصرح به الساسة والأكاديميون في إسرائيل. هم يعرفون أنهم يضللون ويكذبون، لكن بعضهم ومعظم الجمهور الإسرائيلي يصدق الكذبة. ويعود اللجوء إلى إلصاق تهم اللاسامية إلى جذور الصهيونية، التي قامت على دعوة اليهود للهجرة إلى فلسطين للتخلص من اللاسامية، ويتكرر ذلك اليوم بالاتجاه المعاكس لإقناع الإسرائيليين بعدم الهجرة لأن اللاسامية تسود العالم هذه الأيام. وهناك غاية مهمة أخرى وهي تقويض شرعية النضال ضد الجرائم الإسرائيلية وتشويهه بوصفه بأنه تعبير عن نزعة لاسامية، إضافة وكالعادة إلى استدرار التعاطف مع الدولة الصهيونية كضحية.
جاءت الردود القوية على هذه التهمة الباطلة، من شخصيات يهودية وازنة بينهم كبار الباحثين والمختصين في موضوع «الهولوكوست». وقال كينيث شتيرن، الذي صاغ بنفسه تعريف اللاسامية المعتمد دوليا، بأنه «ومن منطلق حرصي الشديد على استخدام مصطلح اللاسامية، أقول إنه يجب استعماله في الحالات الواضحة فقط، حتى لا يفقد حدّته، فعندما يصير كل شيء عداء للسامية، يصبح لا شيء معاديا للسامية، ما يضر كثيرا بمحاربة الظاهرة». وتحدث عومر بارطوف في جامعة، من أهم الباحثين والمحاضرين في العالم في موضوع المحرقة النازية عن تجربته الشخصية مع الحراك الطلابي وقال، إنه زار خيم الاحتجاج وقدّم المحاضرة فيها حول محاربة اللاسامية في أجواء أبعد ما تكون عن تهمة اللاسامية، وعبّر عن امتعاضه لتكرارها المسيء. الحراك الطلابي العالمي هو تطور مهم، بوزنه الثقيل حقّا وبما يشعه على المجتمعات والمؤسسات في الدول الغربية. والمطلوب التفاعل معه بشكل إيجابي بلغة سياسية مشتركة هي لغة العدالة والحقوق، وبفعل نضالي حازم ومسؤول، يزيد من حشد الدعم لقضية فلسطين العادلة.







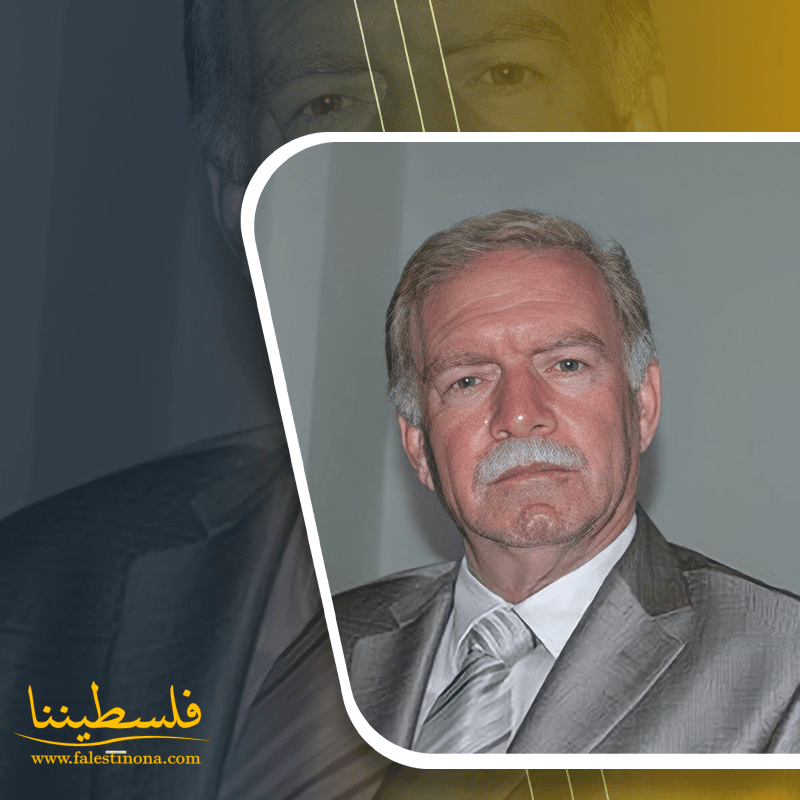
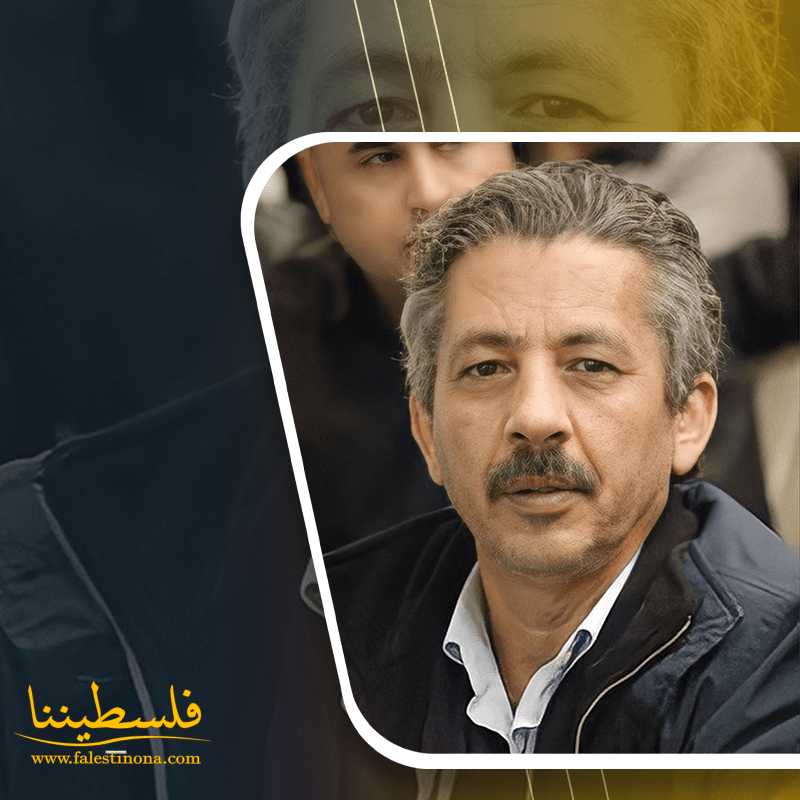




تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها