الشاعرة الفلسطينية نهى عودة
كنتُ أقِيم حدائقي الورديَّةَ بطريقتي التي أحبُّ، يتسللُّ مَخاضُ ما قبل العِلم بأنِّي لاجئةٌ دَخِيلةٌ على هذه البلاد، لذلك سميَّتُ مرحلةَ الطفولة: "المرحلة الذهبيَّة". أحمدُ اللهَ بأنَّه في تلك الفترة من عمري كنتُ طفلةً لا يشغلها سوى الحلويات التي ستشتريها واللَّعبُ الذي أقتنصه بعد انتهائي من واجباتي المدرسيَّةِ.
أغلبُ نساء الحيِّ، في ذلك الوقت، لم يكُنَّ مُتعلِّمات وخصوصًا من كنَّ في عمر أمي، ورغم ذلك فقد خرَّجنَ جيلاً مُتعلِّمًا واعيًا افتكَّ النجاحَ من براثن اللُّجوء. كان الصباحُ لا يهمُّ حرارُته من بردِه، فنحن نتهيَّأ بمحبَّةٍ عميقةِ الصَّفاء للذَّهاب إلى المدرسة التي لا تبعد كثيرًا عن بيوت جميع الطُلاَّب. كانت مدرستُنا (بيت جالاَ) تتوسَّط منطقةَ "وادي الزِّينَة" لذلك فإنَّ معظمَ الطُلاَّب كانوا يتوافدون إليها مشيًا على الأقدام.
لا أتذكَّرُ تفاصيلَ اليوم البارد أو المُمطر في المدرسة، فقد كنتُ أعتبِرُ بأنَّ الشِّتاءَ يداعبُ شعري بانثِيَال رذاذه العَذب، وبأنَّ نسمتَه تستأذنُ لتقبيل وجنتيَّ. لم أحمل يومًا همَّ الدِّراسة أو الواجبات، فقد كانت الدراسةُ وتحقيق النجاح المتميِّز، بالنسبة لي، شيئًا مألوفًا وطبيعيًّا، ولا أذكرُ يومًا أنَّ أمِّي أتت لتُذكِّرني بمراجعة دروسي، أو تعاتبني على تحصيلي لعلامات مُتدنِّيَة في الامتحانات..
محبَّةُ الدِّراسة أمرٌ مُقدَّسٌ وأصيلٌ فينا كأنَّما رضعناه في حليب أمَّهاتنا، وربَّما تلك المحبَّة صارت من عاداتنا وتقاليد حياتنا، فلا مفتاح آخر نفتح به أبواب المُستقبل لأنفسنا وأهالينا إلاَّ مفتاح الدِّراسة.. لا أذكرُ كم كان عددُ الطُّلاب في حيِّنا، ما أذكُره أنَّنا كنَّا نستعجلُ الخروجَ من بيوتنا فورَ إنهاء واجباتنا وفروضنا المنزليَّةٍ، فنجتمعُ في ساحة الحيِّ، وكلُّ مجموعةٍ تلعبُ ما تهوى من ألعاب ذلك الوقت.
ونستمِرُّ في اللَّعب حتى يُرفَع أذانُ صلاة المغرب، فتَرانا نركضُ عائدين إلى بيوتنا خوفًا أن تُنسينا مُتعةُ اللَّعبِ توقيتَ الدُّخول إلى البيت قبل أن تُسدِلَ الشَّمسُ غروبها، فحينها نتلقَّى عقوبةً من أهالينا غالبًا ما تكون ضربَنا وتوبِيخَنا على عدم احترام توقيت العودة إلى البيت.
نأخذُ حمَّامًا سريعًا ونتوجَّهُ إلى سُجَّادة الصلاة. أحيانًا كنتُ أؤدّي الصَّلاةَ كحركاتٍ روتِينِيَّةٍ خوفًا من أمِّي فقط، وأحيانًا أخرى أحبُّ أن أكون قريبةً من الله، فاستغرقُ في الصلاة بكلِّ كينونَتي الجسديَّة والروحيَّة.
بعد أداء صلاة المغرب، يتجمَّع أفرادُ عائلتي وينتظرون ما تُغدقُه أمِّي من مأكولات وحلويات، ثمَّ تطفو الجلسةَ اللَّيليَّةَ ضحكاتٌ جميلةٌ ونقيَّةٌ. نستمع إلى حكايا أمي، وما حدَث مع أبي خلال النهار، وما أعظَم الحظَّ إن اعتزمت جدَّتي (لوالدتي) المَبِيتَ في منزلنا، فتصيرُ السَّهرةُ أكثرَ مُتعةً وتشويقًا وتدفُّقًا بالحنين إلى الماضي، حيثُ تُسافر بنا جَّدتي في ذاكرتها إلى قريتها (البروة) في قَضَاء عَكَّا، فنعيشُ بمشاعرنا وخيالنا في وطننا فلسطين، وكثيرًا ما تغلبنا الدُّموع عندما يتحشرجُ صوتُ جدَّتي وهي تحكي عن تفاصيل انقلاب الحياة المُطمئنة في (البروة) إلى حياةٍ أخرى مُوغِلة في المواجع..










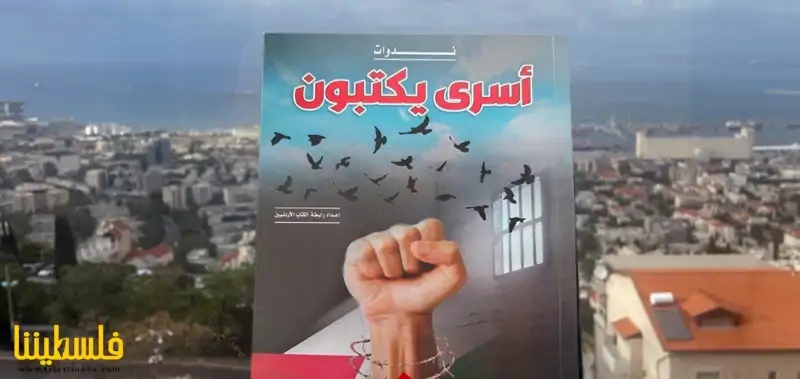
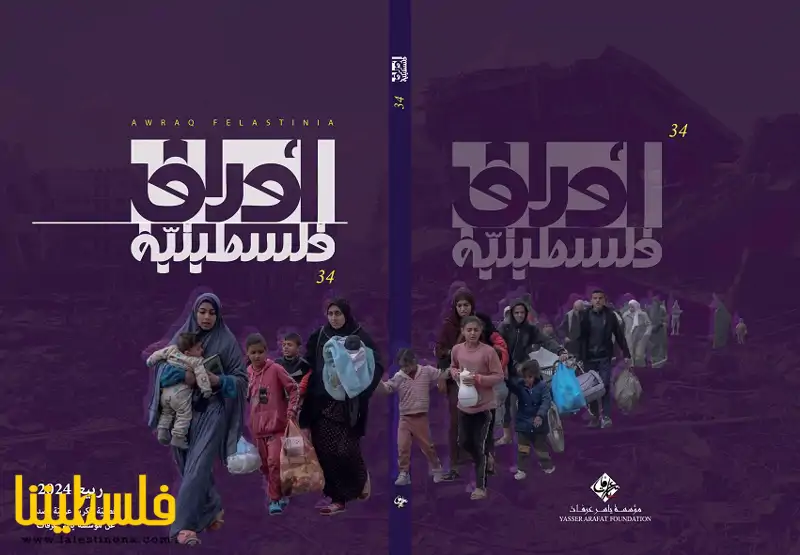





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها