يلعب الموروث الثقافي دوراً أساسياً ومهمًا في ثقافة الاختلاف في الأمة العربية والإسلامية، وخاصة دور فصيلتهِ والقبيلة والعائلات، فيورث الآباء الأبناء، ما ورثوه عن الأجداد وهكذا فتصبح بعض العادات مسلمات لا يمكن التغير فيها سواء كانت ايجابية أم سلبية، فعادةً ما يكون سيد القوم والقبيلة رأيهُ نافذاً لا يقبل الجدل أو الخلاف، وطبيعة البشرية كلها قامت على التنوع والاختلاف. وإن الله جل جلاله خلق الناس جميعًا من ذرية أدم عليه السلام ومنذ أن خلقهم، وجد الاختلاف بينهم، وإن الناظر والمتأمل في سيرة رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يعلم بأنهُ عليه السلام يؤمن بثقافة الاختلاف والتي هي مناقضة لثقافة الخلاف حيث أنه كان عليه الصلاة و السلام يشاور صحابتهُ الكرام، ويستشيرهم ويأخذ بآرائهم ومقترحاتهم والأمثلة تاريخياً على ذلك كثيرة. ولقد وجد الاختلاف منذ الأزل بين ولدي أدم عليه السلام وهما: هابيل وقابيل؛ حيث أن هابيل برغم أنهُ كان قوياً بّبنُيانهِ الجسدي لكنهُ لم يبسط يده لقتل أخاه قابيل، بل حاوره بالتي هي أحسن وكانت لديه ثقافة الحوار النابعة من التقوى والإيمان، ولكن أخاه قابيل كان جاحداً فجعل الاختلاف بينهم إلى خلاف، أدى به إلي قتل أخاهُ هابيل، والمتأمل في القرآن الكريم في قوله تعالى: " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"، لماذا هم مختلفون ؟ لأن الله أعطاهم حرية الاختيار، ولو ألغى هذه الحرية لما اختلفوا، فاختلافهم دليل حريتهم، إلا من رحم ربك، فالاختلاف دليل الاختيار، أما لو مائة إنسان اختاروا الله ورسوله يتشابهوا، أخلاق رفيعة، صدق، أمانة، استقامة، دخل حلال، إنفاق، إحسان، فعدم الاختلاف دليل المشرب الواحد، إذا في مشارب متعددة في اختلاف، فالإنسان مُخير فاختلاف الناس دليل أنهم مخيرون، واتفاقهم دليل أنهم ينهلون من مشرب واحد؛ فالمؤمنون مبادئهم واحدة، قيمهم واحدة، أهدافهم واحدة وسائلهم واحدة، يتلاقى مؤمن في فلسطين مع مؤمن في الفلبين أو الصين مثلاً، فيشعر أنه أقرب له من أخوه في الدم، في توافق عجيب مبادئ واحدة، هدف واحد، استقامة، طهر، عفاف، حياء، خجل أدب، ذوق، إحسان، رحمة، إنصاف، عدل. لأنهم مخيرون، واختاروا أشياء متفاوتة، أما لو أنهم اختاروا شيء واحد وهو: قوله تعالي:﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، أي أن الله سبحانه وتعالى لو ألغى اختيارهم، وألغى تكليفهم، وألغى الأمانة التي حملهم إياها، وطبعهم على شكل واحد، وطريقة واحدة هذا الهدى الذي يلغي اختيارهم لا قيمة له، ولا يسعدهم؛ وأوضح مثل على هذه الفكرة، أن مدير مدرسة، لو أراد أن يجعل كل الطلاب ناجحين، ووزع عليهم الأوراق وعليها الإجابة التامة، مطبوعة ومحلولة، وكلف الطالب أن يكتب اسمه ورقمه والعلامة مطبوعة مائة على مائة، ما دام وزع أوراق وعليها الإجابة معناها كل الطلاب ناجحين، لكن هذا النجاح لا قيمة له إطلاقاً لا عند الطلاب، ولا عند الناس، ولا عند رئاسة المدرسة، نجاحهم تافه لأنه لا علاقة له بجهد الطالب ولا باختياره، فربنا عز وجل كان من الممكن أن يلغي اختيار الإنسان ويلغي الأمانة التي حمله إياها، ويلغي التكليف الذي كلف به، وأن ينزع من نفسه الشهوات وأن يجعله على طريقة واحدة متشابها مع كل المخلوقات، إذاً هداهم جميعاً كالملائكة، ولكن هذا الهدى عطل فيهم الاختيار وعطل فيهم التكليف، وعطل فيهم الأمانة، ولم يجعل منهم أناساً بذلوا جهداً، ولا اختاروا عبادةً، ولا طاعةً، إذاً هذا الهدى ألقصري لا قيمة له إطلاقاً؛ كما أن ذلك النجاح، الذي يصطنعه مدير المدرسة لطلاب المدرسة من دون جهد، ومن دون دراسة، من دون امتحان، من دون تصحيح علامات أوراق، من دون تفاوت بين الطلاب، هذا النجاح الاجتماعي ما له قيمة إطلاقا، مثلما يتم منح شخص ما دكتوراه فخرية يكُتب له دكتور، لكن لا تشعر بأن هذه الدكتوراه لها أي قيمة، لأنها عملية برتوكولية شكلية؛ أما حينما يؤلف الإنسان رسالة دكتوراه فريدة من نوعها، يبذل فيه أربع أو خمس سنوات دراسة، وتنقيب، وبحث، وكتابة، وتصحيح، وطبعات، ثم تنجح هذه الرسالة وتؤلف إلى كتاب، ويقول الناس عنه دكتور، تحس هذا اللقب يتناسب مع هذا الجهد، وهكذا من الجميل أن نتحاور دون إقصاء أو تهميش، والأجمل أن نتبادل المعرفة والرأي دون ترهيب..!، في ظل واقعنا العربي المرير والربيع الدموي الذي تحاكمنا في الخلاف فيه إلى السلاح فقتل بعضنا البعض ولم نحتكم لثقافة ولغة الحوار والتفاهم بسبب الظلم الذي وقع على الناس من قبل بعض الأنظمة الاستبدادية والقمعية المعادية للحرية في الوطن العربي والإسلامي في كلِّ مجالاتها، مما يتطلب ضرورة التوقف عن التربُّص أو الانقضاض على عناصر هذه الحرية ولوازمها، وعلى رأسها حق الاختلاف واحترام ممارسته في الحياة اليومية للناس في البلدان العربية، لآن الحوار، يحل الاختلاف في وجهات النظر. إن الوطن العربي في الآونة الأخيرة، أخذت تترسخ وتتجذر في حياة المواطنين الاختلافات وتطورت إلى خلاف وشقاق ونزاعات وصراعات وحروب!؛ وتقلُّصت ألوان الحوار المجتمعي لتحل محلها الثقافة الفونولوجية، ثقافة الصوت الواحد واللون الواحد التي لا تقبل الاختلاف، بل تُلقي بالمختلف الأخر في حظيرة التآمر أو الخيانة، فغابت الحوارات حول القضايا الصغيرة والكبيرة في شتى المجالات العلمية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافة حتى الأدبية، والدينية، والسياسية؛ ولم يكن ليحدث ذلك لولا ضعف ثقافة الحوار والديمقراطية والمواطنة في المجتمعات العربية وانعدامها في كثير من الأحيان، ليس فقط في بنية الأنظمة الحاكمة، بل في بنية التوجهات والحركات والمنظمات السياسية والفكرية القائمة على الساحة العربية، التي نتجت أساساً عن صراعات لا عن حوارات، وأمتد ذلك الأمر حتى بين الناس العاديين أنفسهم الذين تحولوا إلى وقود للصراعات العرقية والطائفية بعد أن أصبحوا مجرد صدى ومتلقي للتوجهات الفكرية والسياسية التي تصدر سواء عن الأنظمة أو الحركات السياسية والفكرية القائمة دون أي تفاعل معها أو تأثير فيها؛ والناظر لطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان العربية، سوف يجد أن السمة الغالبة عليها تظهر بوضوح من خلال انتشار مظاهر سيادة الرأي الواحد واللون الواحد وطغيان الاستبداد، والانتهاك الواسع للقانون وغياب العدالة، وتدني مستوى التعليم، وارتفاع نسبة الأمية، والتمييز في حقوق المواطنين، وقمع الآراء والأصوات المعارضة، وطغيان ثقافة الاستهلاك على حساب ضعف الإنتاج إن لم يكن منعدماً، باستثناء اللهو وراء إشباع الرغبات الجنسية، والانتشار الواسع لمظاهر الإتباع وغلبتها على مظاهر الإبداع، وشيوع نزعة التقليد في مقابل انحسار رغبةُ الابتكار، وتجريم حق الاختلاف بصفته خروجاً عن رأي الدولة أو الجماعة، وغدا الخطأ في الاجتهاد نهاية "ضلالة البدعة المفضية إلى النار"، وصعود لغة العنف، لا الحوار، والنظر شررا إلى الخروج عن رأي السلطة أو الجماعة، فضلاً عن العداء السافر للتجريب الذي يعصف بالقيود، فابتعدت الناس عن الاجتهاد والاختلاف وأثاره، فآثرت السلامة من خلال الإذعان لما هو سائد من أفكار تلك الدولة أو تلك الجماعة وعاداتها ونواهيها، وكل ذلك أدى إلى انتشار مناخ الاستخفاف برأي الأخر المختلف وتفضيل السمع والطاعة على التفكير والحوار الذي أصبح غير مرغوب فيه؛ وإن تلك المظاهر والمعوقات، التي إن بقيت فسوف تقودنا في نهاية الأمر إلى الهاوية، ولن يكون بمقدورنا التخلص منها، وإزالة أثارها التي حفرت عميقاً في حياة الناس، إلا من خلال نشر ثقافة الحوار المبنية على التسليم بحقّ الاختلاف والتنوع، وترسيخ أدبيات الحوار لدى الحكام والمحكومين على السواء، والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي تأكيد حقِّ الاختلاف ليس على مستوى الشعارات فحسب، بل وعلى مستوى الممارسة الفعلية، بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والمعمل وأماكن العبادة وصولاً إلى البرلمان والحكومة والرئاسة.. إلخ. وتشجيع الكبار للشباب على التميُّز والاختلاف، وتقبُّل الاختلاف بين الأجيال المتعاقبة، بصفته سُنَّة الحياة؛ بل تقبُّل الاختلاف بين المتحاورين من أبناء الجيل الواحد، بصفته الأمر الطبيعي والشرط الأول لاغتناء المعرفة والإبداع. ولن يكتمل معنى هذه الخطوة إلا بإشاعة الممارسة الديمقراطية في كلِّ مستوياتها ومجالاتها وبالأخص منها في المجال السياسي، والقضاء على كلِّ أشكال التعصب، وإشاعة قيم التسامح والمرونة والانفتاح على الجديد، خصوصًا لدى الأجيال الشابة التي ينفر الكثير من أفرادها اليوم من الحوار لأنهم نشأوا في غيابه، واعتادوا على ثقافة اللون الواحد، ولم يجدوا أمامهم سوى ثقافة العنف والقهر والتسلط، ولا سبيل إلى مواجهة هذه الثقافة التي تجذرت في حياة الناس على مدى مئات السنين من الاستبداد والقمع ومصادرة الحريات، إلا عن طريق نقيضها الذي يفيض بالتسامح، ويَعْمُر بالانفتاح على الآخر، ويؤمن بالتقدم الدائم إيمانَه بالمعرفة التي تزدهر بحرية التفكير والتجريب، من خلال تأسيس ونشر أخلاق الحوار، وممارسة حقّ الاختلاف، بصفته مبدأً أصيلاً من مبادئ الديمقراطية، والشورى وعلامةً دالَّة على حيوية الثقافة الصاعدة إلى الأمام، لا المنحدرة إلى الوراء؛ ولا يمكن لأي دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات القائمة على هذه الأرض، أن ينهض أو يتقدم إلى الأمام من دون أن تتوفر فيه ثقافة الحوار، وحرية الفكر والتفكير وحق الاختلاف في الرأي، وفي الوقت نفسه نبذ العنف والتخلي عن ثقافة التهميش والتغييب والإقصاء والاستئصال. يجب فتح أبواب الحوار والاجتهاد الحر على مصراعيه، واستبدال ثقافة الإتباع بثقافة الإبداع، وممارسة التجريب الذي لا يتوقف في كلِّ مجال. وضرورة الانفتاح على كلِّ العوالم والثقافات التي يمكن لها أن تؤدي إلى ازدهار المعرفة والتفاعل معها، بما يؤدي إلى الإفادة منها، والإضافة إليها– وترسيخ ثقافة تقبُّل الآخر المختلف أو المغاير عنا في كلِّ مجال، وعلى كلِّ مستوى، بصفته الوضع الطبيعي للحياة في هذه الدنيا، والشرط الضروري للثراء الناتج من التنوع، وتحرير العقل من كلِّ قيوده، ليمضي في أفقه الواعد، متحررًا إلا من التزامه مبدأ المُساءلة الذي يُخضِعُ له كلَّ شيء، بما في ذلك العقل الذي لا يكفُّ عن مُساءلة نفسه قبل مُساءلة غيره، أو حتى في فعل مُساءلة غيره. إن عملية نشر ثقافة الحوار والاختلاف وتشجيعها في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لا يمكن أن تكون عملية موسمية أو منحصرة في جانب معين، بل هي عملية متكاملة مترابطة ومستمرة، وشاملة لمختلف نواحي الحياة وميادينها، ولن تتحقق هذه العملية دفعة واحدة، بل تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتي ثمارها، في ممارسة حرية الحوار وحق الاختلاف، وباختصار، يمكن القول إن الحوار لا يمكن أن يقوم بقرارات أو أوامر من فوق، ولا يمكن فرضه بالقوة، فهو كالحب والصداقة لا يولد بالضغط ولا بالترغيب، إنما يولد بالتسامح والانفتاح على الأخر المختلف عنا واحترام وجهة نظره، وتفهمه وعدم رفضه، وقبوله كما هو وكما يحب أن يعيش وكما يرغب أن يكون، لا أن نجعله صورة عنا أو ندمجه فينا، وأن نبتعد نهائياً عن التمرس وراء آراء ومواقف واجتهادات مسبقة، وكأنها مقدسات ثابتة غير قابلة لإعادة النظر فيها أو النقاش حولها. فلن نستطيع استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف وآراء بعضنا البعض بدون الحوار والتلاقي, ولن نستطيع نحن أبناء الوطن الواحد أن نتقارب أو نتفاهم دون أن نتحاور في مواقفنا وآرائنا ونتقبل أراء بعضنا لبعض، ويجب علينا أن نغرس في أطفالنا منذُ نعومة أظفارهم الطفل ثقافة الاختلاف والنقاش والمساءلة، وتوفير لهم كل الإمكانيات لينشأ في بيئة سليمة تعترف به وبأفكاره وتشجعه على التميز و الاختلاف، كما يتم تلقينه احترام الرأي والرأي الآخر واعتبار الاختلاف في الآراء و المعتقد والفكر من سنن الحياة ومن طبيعة الكائن البشري، فإذا لم يكن هناك حوار بيننا، فسوف ينطوي كل واحد منا على ذاته وتقع القطيعة بيننا، لأن البديل الوحيد عن الحوار هو القطيعة بلا أدنى شك، التي سوف تؤدي إلى انتشار ثقافة الشك والحذر، التي سوف تقود نتيجة حتمية واحدة، هي العداء والتصادم والتقاتل، لأن الاختلاف يعني التباين والتنوّع؛ فكما خلق الله أشكالنا وقدراتنا متباينة مختلفة، كذلك خلق لنا طبائعنا متنوعة؛ والله عز وجل خلقنا أحراراً وحتى جعل لكل إنسان الحرية في المعتقد وفي الدين،" لا إكراه في الدين"، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أُمهاتهم أحرارًاً، فعلينا أن نتقبل أراء بعضنا بعضاً وأن لا نحول الاختلاف إلى خلاف ونزاع، وأن نستمع لبعضنا ونتفهم حاجات الأخرين وأن ننزع الغل والحسد والحقد من قولبنا، فالوطن ليس إما أنا ورأي، وإما رايك أنت؛ بل الوطن أنا وأنت ورأي ورأيك، فلكل مجتهم نصيب والخلاف لا يفسد للود قضية؛ وعلينا أن نفعل ثقافة الاختلاف فيما بيننا، تلك الثقافة التي تعني احترام كل وجهة نظر ورأي واختيار مخالف لآرائنا وأفكارنا وسماعه ومناقشته في أجواء يسود فيها الاحترام والهدوء وسعة الصدر، تحت شعار اختلاف الآراء والأذواق والأفكار في حد ذاته رحمة للأمة، ونعمة من نعم الله علينا، وبصيرة لا يفقهها إلا العقلاء، كذلك هو درجة من درجات التفكّر والتعقل، ولولا الاختلاف في أنماط التفكير وطرح الآراء لما تطور الإنسان؛ وكما يقولون اختلاف الأئمة رحمةً بالُأمة، ففي الاختلاف عقل وعلم ورحمة، وفي الخلاف هوى ومصلحة ونقمة، وفي الاختلاف العلمي تنمو الطاقات وتتفجر القدرات في أجواء حرة إيجابية ونحن نعاني اليوم من الانغلاق الفكري لبعض الجماعات الإسلامية التكفيرية، التي لا تؤمن بالاختلاف ولا بالحوار، فأصابتها الأمية الفكرية، بسبب التعويل منهم على الثقافة الجاهزة (المعلّبة) دون التدقيق وإعمال الفكر في وسطية وسماحة الشريعة الإسلامية، والأخذ من طرف فقهي وكأنه مسلمات قرآنية وعدم احترام الآراء الأخرى للفقهاء أو العلماء مما أدى للصدام والاقتتال؛ مع أن القرآن الكريم يرفض هذا المسلك المشابه لمسلك الاقتداء السلبي، سواء الانغلاق الفكري والتشدد والتعنت، أو الاقتداء بالآباء والأجيال السابقة ورفض الفكر وتفعيل دور العقل هذه الطاقة المودعة عندنا، بينما القرآن الكريم ونبي الرحمة جاء متممًا لمكارم الأخلاق والدين كله أخلاق، والتعامل مع المختلفين معهم فكرياً يجب أن لا يتعدى القيم الأخلاقية النبيلة في التعامل الغير، وليعلم هواة الطعن والتجريح والتقسيط والتكفير والتخوين أنهم بعيدون كل البعد عن الشرع المقدس وعن القيم الأخلاقية الثابتة وعن الأطر الإنسانية!؛ لذا يتوجب علينا أن نغرس في الأبناء منذ الصغر ثقافة الحوار واحترام حرية الرأي والتعبير وأن الاختلاف يجب أن لا يفسد للودِ قضية.
ثقافة الاختلاف والخلاف: بقلم جمال عبد الناصر أبو نحل
28-01-2017
مشاهدة: 2384
جمال ابو النحل


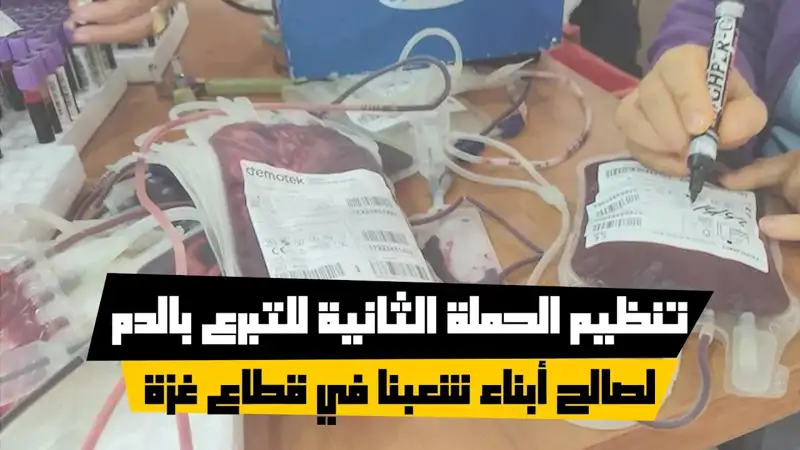
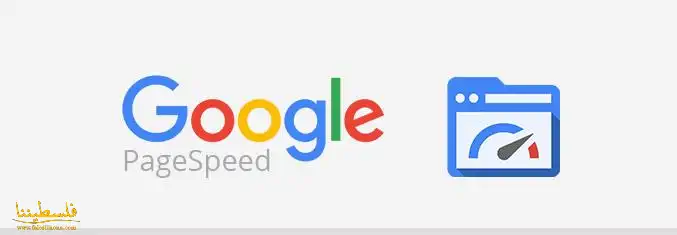






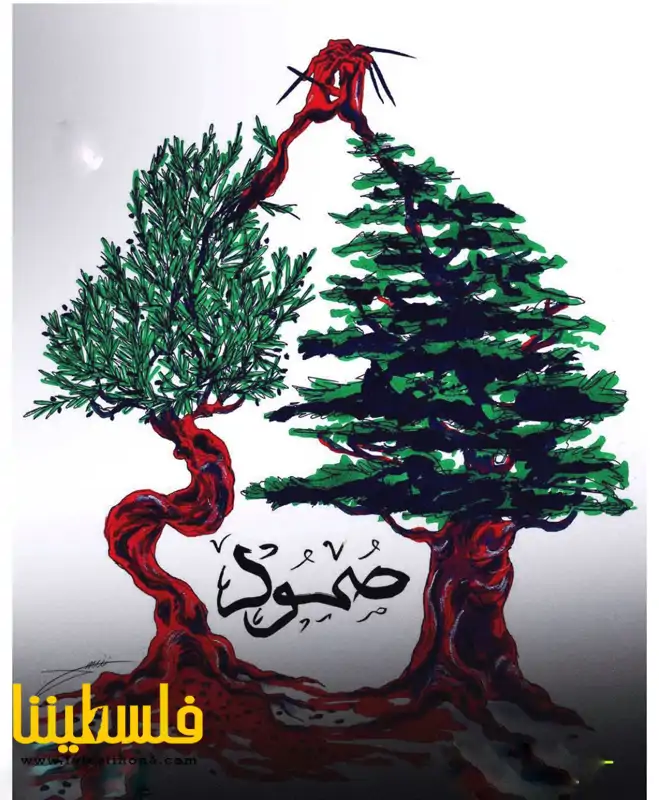



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها