لقد تعوّد اليهود عبر قاعدتهم الصهيونية التي تجلّت فيما يُسمّى "إسرائيل"، على احتكار صورة الضحيّة، وها نحن نراهم يحتكرون الساميّة لأنفسهم.
تقول المراجع: إن مصطلح "معاداة السامية" أو "اللاسامية" قد انتشر في ألمانيا لأول مرة عام 1879 كمصطلح يرتبط بـ"كراهية اليهود"، وتمّ تعميم المفردة بطرق عديدة تتراوح ما بين التعبير عن الكراهية أو التمييز ضد أفراد يهود، وصولاً إلى مذابح منظّمة أو حتى هجمات عسكرية على "جيتوهات" اليهود، حتى أصبح سلاحاً مُشرعاً في وجه كلّ من يشكّك بـ"الهولوكوست"، أو يمسّ أي أمرٍ يتعلق - حقّاً أو باطلاً - باليهود أو بإسرائيل.
وأسأل: لماذا لا يقال بوضوح وصراحة وجرأة أن المسيحية الغربية وجدت جذرها في اليهودية حتى أنّ الثورة التنويرية التي أحيت الجذر الروماني والإغريقي للحضارة الغربية لم تستطع أن تتجاوز ذلك الجذر اليهودي.
وعليه فإن الغرب المسيحي وهو يختلف كل الاختلاف عن الشرق المسيحي وفي محاولة تأصيل تجربته العلمية والعلمانية أزّم علاقته مع الجماعات اليهودية من خلال العزل أولاً ثم الانفتاح والدمج ثانياً، وذلك ضمن آليات تراوحت ما بين اليهودي الملعون ثم اليهودي المبارك، ومع ما رافق ذلك من تغيرات اجتماعية واقتصادية، وانهيار الإقطاع وظهور المدن ثم القوميات ثم التوسع الإمبريالي وانهيار كل البنى الفكرية القروسطية، ونشوء بنى فكرية أخرى، اعتمدت في مجملها على إشباع الحاجات لذةً واستهلاكاً، وعلى فكرتي التطور الداروينيّة واللاوعي الفرويدية وأشباههما. ومن المثير؛ ملاحظة أن كل ذلك جعل من الجماعات اليهودية أكثر قوة وأكثر حضوراً وأكثر فعالية. إن أوروبا على اختلاف طفيف هنا أو هناك والتي ضمّت في دولها المختلفة "جيتوهات" قيل إنها عوملت بقسوة وعنصرية، هي ذاتها التي حولت "الجيتوهات" إلى أكثر الأماكن قوةً وحضوراً. ويمكن القول: إن كل ما قيل عن إساءة معاملة اليهود في تلك "الجيتوهات" قد يدخل في دائرة التساؤل؟ فلا يعقل أن ينفتح هذا "الجيتو" فجأة ليتحوّل أفراده إلى أكثر الناس نفوذاً وغنى وشهرة، ومن الغريب حقاً أن ينجب هذا "الجيتو" باباوات وسياسيين وفنانين وشعراء واقتصاديين، فَعَنْ أيّ معاملة سيئة نتحدّث؟.
- وهل هذا يتطلب رؤية جديدة أو كتابة أخرى للتاريخ الأوروبي؟
وهل يمكن ردّ فكرة العداء للسامية وليس لليهودية هو تعبير عن ذلك الدور الخفيّ الذي كان "الجيتو" يقوم به؟ بمعنى أن العداء للسامية هو الدعاية الشعبية وغير الشعبية ضد دور بعض الجماعات اليهودية في المجتمعات الأوروبية بعد أن تخلّصت هذه المجتمعات من بنى فكرية قروسطية رأت في اليهودي - كل يهودي- قاتلاً للمسيح.
لا بد من الإشارة هنا إلى أزمة الفكر الغربي المسيحي في العصور الوسطى من حيث تعامله مع اليهود؛ فمن جهة كان هذا الفكر بحاجة إلى العهد القديم ليثبت رؤية المسيحية، ومن جهة أخرى كان يرى في اليهود وكل اليهود قتلة للمسيح، ومن هنا نشأ هذا الاحتقان في تعامل الأوروبيين كاثوليكَ وأرثوذكسَ مع اليهود، حتى حدثت القفزة الكبرى، بتجاوز هذه النظرة إلى ما يشبه الاستسلام إلى تجاور المسيحية واليهودية من خلال العمل في منطقة أخرى هي الأفكار العلمانية المعروفة: الديموقراطية والمواطنة والقانون المدني وفصل الدّين عن الدولة، ومعنى ذلك تماماً أن المصالح فوق العقائد، وأن المواطنة فوق الدّين، وعلى هذا انمحت الفواصل والفروق بين الناس، وتساووا أمام الدولة وقوانينها.
والعداء للسامية وإن كانت بهذا المفهوم سلوكاً أوروبياً- إلا أن العداء لليهود -كونهم يهوداً- لها ما يفسرها- ولا نبرّرها نحن أبداً، وتفسير ذلك أن جماعات يهودية كثيرة تحلّت بمزايا (ظرفيّة) جعلتهم محطّ الكراهية والنفور.
مرة أخرى؛ فإن العداء للسامية التي ترافق والعلمانية، رغم أن هذا يناقض ذلك، وجد تعبيره الأكثر بروزاً والأكثر غموضاً في الوقت ذاته مع صعود النازية في ألمانيا، نقول إنه الأكثر بروزاً من حيث استهداف جماعات اليهود في عدد من البلاد الأوروبية، ونقول الأكثر غموضاً لأن العلاقة أو مجموعة العلاقات التي كانت بين النازية والصهيونية أو زعمائها ما تزال محلّ بحث وتمحيص من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما قيل عن أعداد مَنْ قتلوا وكيف قتلوا محطّ تساؤل عميق، ومن جهة ثالثة، فإن استثمار ما جرى حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل وابتزازها الشعب الألماني والعالَم يثير غير سؤال حول كل ذلك، ولكن كل هذه الأسئلة لا يجب أن يمنعنا القول إن ما جرى كارثة حقيقية بحق كل الشعوب، وإن النازية هي جريمة عصر بأكمله، وإن الحرب على النازية يعني إنكارها وإنكار مرتكبيها وأفكار أساليبها وإن كل من يفعل فعلها فهو مثلها.
وبعيداً عن هذا، فإن مفهوم العداء للسامية كان ذا خيرٍ عميم للحركة الصهيونية ولدولة إسرائيل فقد أصبح هذا المفهوم سيفاً مسلطاً على رقاب السياسيين والمفكرين والمثقفين الذين قد يتجرأون على انتقاد إسرائيل أو سياساتها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى هذا فإن نقض هذا المفهوم أو دراسته وتعميق الحوار حوله سيفيد تماماً لجعله مجرد خدعة أخرى من خدع آلة إعلامية ضخمة، مهمّتها تضخيم ما يمكنها الإفادة منه،وتحقير ما يمكن أن يضرّها.
أوروبا هذه، وجدت أخيراً حلاً لمشكلة الجماعات اليهودية، وذلك بإيجاد أو خلق وطن لهم في فلسطين على حساب شعب فلسطين الأصلي، إن حلّ هذه المشكلة بهذا الشكل يتلاءم تماماً والفكر الاستعماري من جهة والتوجهات العلمانية الأوروبية من جهة أخرى، وكلا الفكرين يقوم على إشباع الحاجات أولاً والبراغماتية ثانياً، وبهذا- ومهما كان شكل العلاقة بين الأوروبيين والجماعات اليهودية- انتهت في النهاية إلى إقامة وطن مدّعى في فلسطين على حساب شعب فلسطين، وبهذا تنتهي تلك العلاقة الطويلة من الحذر والتشكك والتأثير الخفي والتشابك السطحي والعضوي إلى أن تقرّر أوروبا وهي هنا القوى الاستعمارية إلى أن ترى في دولة يهودية حلّاً لكل الأزمات السياسية والأخلاقية وحتى الدينية، يجب هنا أن لا ننسى قوة العهد القديم.
ويبقى السؤال الاستنكاري الأكثر نفاذاً وأصالةً وهو: أننا نحن العرب ساميّون بامتياز، فلماذا نُتّهم بالعداء للسامية؟ ونحن عنوانها وجوهرها؟ هل معنى ذلك أنّ الجماعات اليهودية، والتي جزء منها غير ساميّ، يريدون الاستحواذ على جينات العِرق السامي، لكي يجدوا لأنفسهم جذوراً وأصولاً ليست لهم بالضرورة، أو ليست لهم وحدهم بالفعل.
أما الموقف أو السياسات في المجتمع المدني الغربي، فقد بدأت تتغيَّر ببطء تدريجياً نحونا نحن العرب والمسلمين، لكنّ هذا التغيّر، وفي ظل الترهيب باسم معاداة الساميّة، ما زال يفتُّ في صورتنا ويظلمنا، ويساعده في ذلك الجماعات الداعشية التي تقدّم نفسها ممثلة للإسلام. وهذا ظلمٌ، وهنا؛ علينا الإفادة عرباً ومسلمين، من الفضاء الحرّ المَعيش في الغرب، وخصوصاً أن لديه مُتّسعاً لما يُسمّى بالأسئلة اللامتناهية، على رأي بعض المفكرين، اللامتناهي في الأسئلة والإجابات والنقد قولاً وممارسةً. وأن أحد سلبيات إعلامنا أنّه يتوجّه لنا أكثر مما يخاطب الرأي العام الغربي، بهدف ترميم صورتنا وتقديم صورة تمحو الرُّهاب عن الإسلام (الإسلاموفوبيا) في ظلّ سيطرة انتشار حرّاس الكذب، الذين يمرّرون مقولاتهم، في ظل الفوضى الخلاّقة والعولمة والاحتلالات، لتعميق صورتنا السوداء المغلوطة في الغرب. على الرُّغم من تشقق الجدار، الذي فصل ما بين ما كان يحدث عندنا من مذابح وفظاعات من قبل الاحتلال وقوى الاستكبار، وبين متلقيات الوعي والإعلام الغربي، ما أحدث تحوّلاً في الرأي العام الغربي، لكنه ما زال بطيئاً وضعيفاً جداً. لهذا بقيتْ الثقافة الغربية الجمعية ثقافة عنصرية تّجاهنا، بسبب موضوعة الاستعمار. وبسبب الاستعمار كان لا بدّ للخطاب المستعمِر إلاّ أنْ يصِفنا بالدونيّة وبأنّ ثقافتنا خرافات وخيالات، وهذا جزء من مرافعته لتوفير الأعذار والمبرّرات لما يقترفه ضدنا.
إنّ هذا مقياساً عنصرياً ما زال متحكّماً ومستمراً ورافضاً لنا. إنّ الثقافة الغربية ثقافة هيمنة وذرائع، لكنّ ديننا أنتج ثقافة مساواة وقبول للآخر وثقافة حوار وعدالة.
ويبدو أنّ البعض يريد أنْ يُحْكَم المجتمع بثقافة غير ثقافته حكم المجتمع خارج ثقافته هل هذا معقول؟.
المعقول هو المطالبة بإنهاض وتحديث هذه الثقافة وليس اجتثاثها، لأن ذلك عين المستحيل. وربما يطيب للكثيرين القول بأنه لا توجد رسالة إنسانية في ثقافة الغرب، وهذا صحيح إلى حدّ كبير، لأن الثقافة الغربية مكّنت الأقوياء فقط من فرض وعيهم وثقافتهم ومصالحهم خمس دول يتحكّمون في مجلس الأمن، عدا عن تصاعُد النازيّة والفاشيّة الجديدة وجماعة كارل الثاني عشر في الدول الاسكندنافية، ما يدلل على أن الثقافة الغربية، منذ اليونانية، هي ثقافة السيّد الأبيض، وبظنّي أن الغرب لم يغادر هذه الثقافة حتى الآن، لأنها تعمّقت خلال ممارساته الفظيعة فيما اقترفه في العالم الجديد من فظاعات وإبادة، عداك عن محاكم التفتيش وضحايا الحربين العالميتين. بينما نجد العقيدة الإسلامية الصحيحة التي لم ينشأ في حضنها أيّ ظاهرة فاشية، قد أسقطت العِرق واللون والجنس، والأَخطر من كل ذلك أن الغرب استبدل، في العصر الحديث، سيادة العدالة بسيادة القانون، لأن العدالة قانون عام، أما القانون فيتمّ وضعه تبعاً للمصالح ورؤية النظام. وأرى أن الإسلام قد أعلى العدالة باعتبارها أساس المُلك أي أساس الحكم.
واللافت أن الدكتورة أريلا أوبنهايم، من الجامعة العبرية، قد قامت بأول دراسة موسّعة للحمض النووي في عام 2001 على الإسرائيليين والفلسطينيين، وخلصت إلى أن المهاجرين على متن السفن إلى فلسطين قبل أن تصبح إسرائيل كانوا 40٪ من المنغوليين و40٪من الأتراك، لم يكن هناك دم سامي مرتبط بالعبرانيين الأصليين في الشرق الأوسط قبل 4000 سنة في القدس أو "الأراضي التوراتية". وهذا ما أكده مشروعٌ آخر، من قبل د. إيران الحايك في معهد ماكوسيك نامان للطب الوراثي، في كلية الطب بجامعة جون هوبكنز، 2012 وكانت استنتاجاته هي نفسها.
مَن يسمّون باليهود الأشكناز لم يهاجروا قطّ من الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، كشفت أدلة الحمض النووي واسعة النطاق أن الفلسطينيين كانوا أكثر أو أقل بنسبة 80٪، ودماء ساميّة في أسلافهم.
اليهود البيض الذين صعد أسلافهم على متن السفن عام 1882 متّجهين إلى فلسطين قبل تسميتها إسرائيل، ليسوا إسرائيليين، الحقيقة تؤلم مرة أخرى. هؤلاء البيض من أوروبا الشرقية المتحدرون من الألمان والروس والبولنديين والنمساويين والجورجيين وغيرهم، هم المحتالون الذين يدعون أنهم مختارو الله، لكنهم أحفاد الخزر القدماء من التجمع الخزري. وقد أنكروا هذا الدليل العلمي لأنهم لقد اخترعوا أساطير حول تاريخهم، وهو ما آمن به العديد من الأميركيين بالفعل طوال القرن، وهو الكتاب المقدّس لسكوفيلد. بالطبع، كنا جميعا نعرف هذا بالفعل.. لكن نتائج هذه الدراسة التي اعدتها جامعة جون هوبكنز لا بد أن تكون محرجة بالنسبة للصهاينة وأتباعهم المتصهينين.
* وشهد شاهدٌ، اسمعوا ما يقوله عالم الآثار الإسرائيلي زائيف هرتسوغ:
سبعون عاماً من الحفر والتنقيب في إسرائيل، وصلنا إلى طريق مسدود، الأمر كله مختلق، لم نجد دليلاً واحداً يؤكد وجودنا التاريخي على هذه الأرض، فنحن لم نهاجر إلى مصر ولم نرحل إلى هناك إطلاقاً، ولم نجد أي ذكر لاسم داوود وسليمان هنا، لم نجد نجمة داوود ولا الشمعدان المقدس. الباحثون والمختصون يعرفون هذا الشيء جيداً، ولكن العامة لا تعرف، إما أننا في المكان الخطأ أو أن كل ما ورد في التوراة عن الملك داوود سليمان هو مجرد خرافات وأساطير.












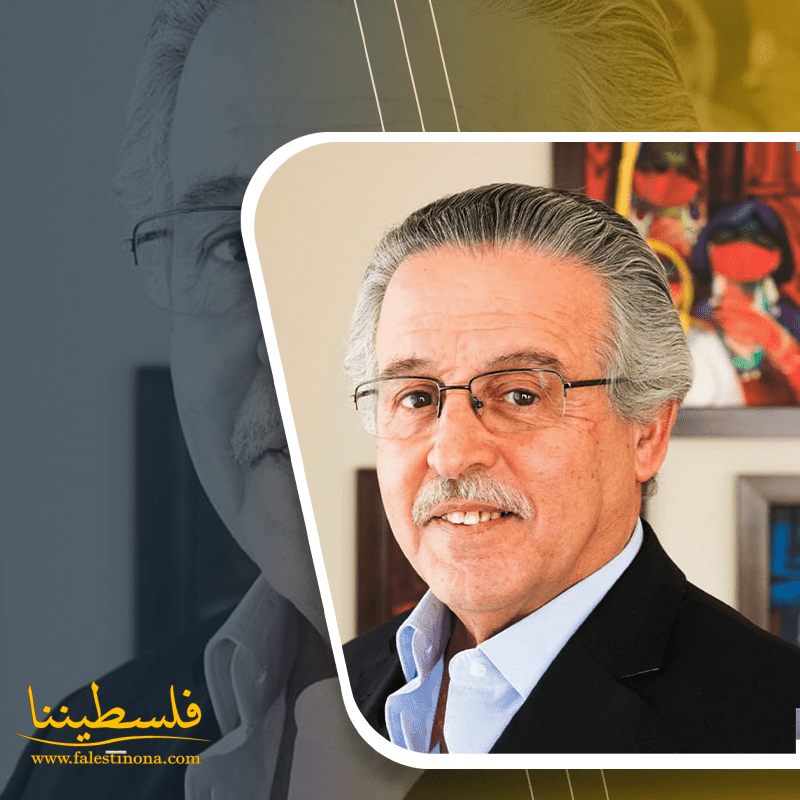





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها