تقرير: زهران معالي
شكل الـ15 من مايو/أيار عام 1948 يوما استثنائيا للفلسطينيين بأحداثه الكبرى التي فقدوا فيه أراضيهم، وشردوا فيه عن ديارهم منذ 72 عاما، وأعلن فيه عن إقامة دولة الاحتلال وإحلال الغرباء مكانهم.
وبعد شهرين من أكبر حدث بتاريخ الشعب الفلسطيني، فجر الثالث من رمضان عام 1948، كانت البداية لفصول من المعاناة والتشرد لقرابة 1500 فلسطيني من قرية طيرة دندن قضاء اللد، امتدت واستطالت حتى وصلت لـ72 عاما، فيما لا تزال نهاية تلك المعاناة مجهولة حتى اللحظة.
أربعة عشرة عاما كان عمر سعيد حسين الطيرواي، ابن القرية الذي اضطر برفقة عائلته للرحيل قسرا عن قريتهم إلى الضفة الغربية، خوفا على أرواحهم من عصابات القتل الصهيونية.
يروي الطيرواي (87 عاما) الذي لجأ برفقة عائلته لمخيم بلاطة شرق نابلس، تسارع الأحداث التي قادت لهجرة أهالي القرية بحسرة على البلاد المسلوبة، قائلا: "الإشاعة أضاعت البلاد وهجرت العباد".
بداية التهجير بالقرية بدأت بأعداد قليلة من عائلاتها بعدما سمعوا عن بشاعة جرائم العصابات الصهيونية في مجزرة دير ياسين غرب القدس في ابريل/نيسان، لكن سرعان ما اضطر أهالي القرية بعد أشهر للفرار لجبالها بعد أن هاجمت تلك العصابات القرية فجر الثالث من رمضان، وسط إطلاق كثيف للنيران، وفق ما يوضح الطيراوي.
فر الطيراوي حاملا شقيقه ذو الأربع سنوات برفقة عائلته وأهالي القرية سيرا على الأقدام نحو قرية دير طريف القريبة، ثم لقرية دير عمار غرب رام الله، كانت خلالها الأرض فراشهم والسماء غطاءهم، وفق قوله.
وامتاز أهالي طيرة دندن بالعمل بالزراعة وتربية المواشي كبقية الأرياف الفلسطينية، وبينهم عائلة الطيراوي الذي حاول العودة للقرية لإحضار خرافه السبعة التي اعتاد على رعيها في أراضي وجبال القرية، إلا أن اشتداد القصف دفعه للتخلي عنها.
لكنه يؤكد أنه تمكن من العودة مرتين بعد أيام من التهجير لقريته على دابة برفقة قريب له، استطاع خلالها استرداد مونة البيت من الزيت والأواني ومئة كيلو من الطحين كان طحنها بمطحنة دير طريف القريبة قبل ثلاثة أيام من سقوط القرية، بعد أن سار بين جثث أعدمتها العصابات الصهيونية.
ويتحدث أبو نبيل عن أرض والده المسلوبة، واصفا إياها بالجنة ففيها القمح والصبار والزيتون والتين والذرة والعنب، قرابة أربعين دونما كان يملكها والده تاجر الماشية في القرية، مضيفا: والدي كان تاجر ماشية معروف بالمنطقة لكنه لحق بنا حافيا سيرا على الأقدام وبحوزته مبلغ صغير من المال، وقطعة المرتينة (بندقية تحوي 20 طلقة) فقط.
ويتابع: "لو خيروني بين القصر في المخيم والخيمة في طيرة دندن، لاخترت الخيمة بمسقط رأسي، 72 عاما لم أر فيها يوما الراحة، حياتنا كلها كد وتعب، لم نتنفس هواء البلاد النقي على شط بحر حيفا منذ 72 عاما، الله يذل من ذلنا".
"حكاية اللجوء تورث جيلا بعد جيل، خرجنا خمسة أبناء لوالدي، لكن اليوم كل منا لديه عشرات الأبناء والأحفاد، أبنائي وأحفادي اليوم 83 فردا، ولابد من العودة يوما ما".. يشدد الثمانيني.
وفي مخيم جنين، تتأكد مقولة أن حكاية اللجوء تورث جيلا بعد جيل، بما يتحدث به رشيد منصور (64 عاما) الذي يعد من الجيل الثاني للنكبة، والذي لجأت عائلته عام 1948 إلى المخيم، من قرية اجزم قضاء حيفا.
يوثق منصور النكبة كشاهد سمعي على أحداثها لما سمعه من روايات الأجداد عن البلاد المسلوبة والمعارك التي خاضها الثوار ضد الانجليز والعصابات الصهيونية في الوادي الذي يفصل قريتهم اجزم عن حيفا.
"منذ تفتحت عيوننا على الدنيا، كان حديث الجدات في المساء عن التهجير والقتل والتدمير الذي لحق بأهلنا في بلادنا المسلوبة".. يضيف منصور.
ويروي منصور أن اجزم تميزت بتربية المواشي والزراعة، وأن جده رشيد كان يملك 500 رأس من الماشية وقت سقوط البلاد، و50 دونما يحتفظ بكوشانها حتى اليوم بين أراضي القرية البالغة 46 ألف دونم، مقسمة مناصفة بين أراضي ميرة حكومية ومثلها أملاك خاصة للفلسطينيين فقط.
ووفق ما روت عائلته له فإنها اضطرت آخر الثلاثينيات لترك اجزم بعد الحرب العالمية الثانية والانتقال للعيش بمدينة حيفا، والعمل كعمال في البلدية والميناء، وعندما بدأت أحداث النكبة عام 1948 اضطروا للانتقال بقوارب أحضرها الانجليز والاتجاه إلى عكا.
ويتابع: مكثوا في عكا شهرا ثم انتقلوا عبر البحر إلى الطنطورة القريبة من إجزم حيث استقبلهم أهلها لعدة أيام، وعادوا سيرا على الأقدام لبلدهم أجزم وبعدها بأيام وقعت مذبحة الطنطورة التي استشهد فيها 250 فلسطينيا بينهم مختار القرية وأبناؤه السبعة.
ويضيف: استقر بهم الحال بإجزم حتى نهاية شهر تموز، حيث اشتدت المعارك بين أهالي القرية التي تحصن الثوار فيها بواد قريب، لكنهم لم يصمدوا فترة طويلة إثر تدخل الطيران البريطاني حينها وتنفيذه غارات عدة على البلدة لعدة أيام أدت لاستشهاد 33 من أهل القرية.
عاد منصور منذ النكبة لإجزم مرتين الأولى كانت عام 1983 بعد تحرره من الأسر بثمانية سنوات برفقة والده، والثانية عام 2012 برفقة زوجته وأبنائه وأمه كزائر فقط، لكن يؤمن بأن العودة ستتحقق يوما ما، وأن هذه حقيقة مطلقة كإيمانه بالله تعالى، وفق قوله.
أتمسك بالعبارة التي ثبتها والدي على مدخل منزلنا بالمخيم "عيدنا يوم عودتنا".. يؤكد منصور.
ويضيف "خلال أيام والدي الأخيرة قبل وفاته كان يسقط كثيرا عن سريره أثناء نومه، عندما نسأله كان يجيب كنت أركض بالحليصة بحيفا، كنت ألعب بأحياء حيفا، وعندما خرجت روح والدي إلى بارئها كانت كلماته الأخيرة "لا إله الا الله، قلعة شنة.. قلعة شنة" وهي المنطقة التي عاش فيها والده في إجزم.
ويؤكد منصور أن المخيم الذي يسكنه قرابة 11 ألف نسمة لجأوا للمخيم من 70 قرية وبلد من الأراضي المحتلة عام 1948، أنه محطة العودة، التي تترسخ بالأجيال جيلا بعد جيل، باعتبار حق العودة ثابت لا محالة لشعبنا.
"حفيدي عمره 5 سنوات عندما أسأله من أين أنت يجيب أنا من زرعين، فحتى لو مات الكبار فالصغار لا ينسون بل بحق العودة يتشبثون".
ويصف الشاب فارس بسام صقر (28 عاما) وهو من أبناء الجيل الثالث الذين ولدوا بمخيم جنين، النكبة بأنها "غصة العُمر التي ورثناها غصبا وتعايشنا معها قسرا، لنصل إلى يوم العودة المُبجل".
ويعّرف صقر نفسه بأنه "لاجئ من قرية المنسي 31 كم عن مدينة حيفا، لم أعش تفاصيل اللجوء؛ ولكن عشتها افتراضيا من كلام أجدادي الذين حدثوني عنها في كل جلسة كُنت معهم بها، حدثوني عن البلاد التي لم تبخل يوما في عطائها".
ويتابع: النكبة أصبحت وصمة تلاحقنا أينما حللنا، ولم أعش في المُخيم بل في واد برقين القريب لكنني عشت تفاصيله في دراستي التي كانت في مدارس وكالة الغوث.
"قال لي جدي ذات يوم أن حيفا أجمل مدن العالم، ودائما كان يردد بأن العودة قريبة مهما طالت، اللاجئ صبور عنيد ليصل إلى ما يريد" يؤكد صقر.
ويضيف "المخيمات تكتظ بالسكان، فنحن الآن الجيل الثالث إذ صح التعبير عن النكبة، بات الوضع صعبا، لكن مع كل ذلك لم نفقد الأمل يوما بالعودة".














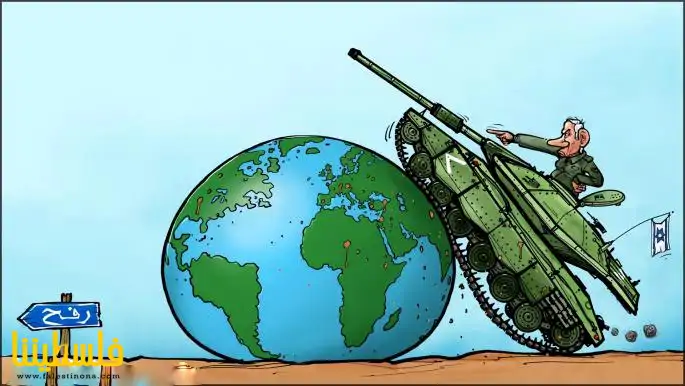


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها