توقفنا عن التململِ والعَتَب.... لا تنهُّدَ لا شكوى.
النكبةُ نعستْ والنكسةُ في السرير، يُهدهدُها الأخوةُ والجيرانُ وأبناءُ السبيل... يُدلِّعونَها بلغاتِ العالم كلها، فيما غرباء يعبثون بملامح الأمس، بذاكرة التراب والأزقة ومفايتح الديار... كل الديار.
بدأت الأسئلة تلذع، كجمر السنديان الغضّ تلذع، ما نفع الصكوك ومفاتيح أبواب البيوت العتيقة؟ أيُّ فصام أصاب الأحلام، فكم هم الحالمون بالعودة، وكم هم الحالمون بالتشظي في متاهات العوالم البعيدة؟
أشواقنا بدأت تترمَّد، وأعيادنا صارت احتفاء بفردٍ ترك الحجرة الضيقة... تركها للدعاء والبحث عن غدٍ مختلف... عن غدِ بعيد بعيد.
وما ليومنا المثخن بالجراح من غد. أي غد في ظل تهاطل كالجراح على الجراح ؟!
وهمٌ هو الغد !
وهمٌ هو انتظار صبح لن يتنفسه ليل أدمن الإقامة في دمنا.
التسكُّعَ على أرصفةِ المدائن أصبح غدنا، والبحث عن ملامح جديدة لجلودنا بات حرفة وأمنية... إننا الآن نجدُّ في البحث عن ألوان وعن لهَجات وهويات جديدة. لم يعدِ الرصيفُ بعض رجاءِ خطانا العابرة... الرصيفُ الآن، كتاب المصير الذي نتصفَّحُه. لم يعدْ مَرصداً لقراءةِ الوجوهِ ولا السفر في ملامحِها، كأنه مساحة للعبثِ الطفوليِّ أضحى... لم يعدْ موسم الهجرةِ إلى الديار... الديار لم تعدْ تحمل ملامحهم الأولى.
الحديثُ عن الذات، لم يعدْ عاطفياً، فثمة قوم سرقوا مكاننا، سرقوا حتى لحومِنا وعظامِنا وتفاصيلِ هويَّاتنا الشخصيّة وفولكلورنا وتراثنا وفننا، سرقوا الزيتون والنخل والليمون، وزهور البيارات وقناطر البيوت العتيقة... وبخور المقابر ومطاحن البن، سرقوا الفرس ورسن الحمار... كل شيءٍ سرقوا، حتى وسائد الأسرة وابتسامات الأطفال وتنهيدة الجدود في حقول التعب.
كل شيء سرقوا، حتى الأحلام والقناديل ومحادل السطوح وأجران الحجر، وادعوا أنهم أول من صنع التبولة والكبة النيَّة والفلافل، وأول من طبخ المجدرة والبيسارة، وأنهم السباقون إلى تحضير وتموين المكدوس والقورمة وورق العريش...
ادعوا امتلاك كلَّ شيء، حتى إسطبلات الفدادين وقطعان الغنم والماعز وأقنان الدجاج... وآثار الأسلاف والكوفية.
الشكوى غدتْ بلا إيقاعٍ، والدندنات بلا حنين...
يتراكمُ فينا وجعُ اللحظات، هو غَلة هويّة لا تكفُّ عن إدانةِ معتنقيها. فكم يتكثَّفُ هذا الوجعُ، وماذا سيغدو بعدَ حين؟
أترانا تمادينا في ولعِنا إلى أن تشظّينا في زَحامِ الارصفةِ والمنافي؟
ألأنَّنا لهثنا كثيراً وراءَ نزوةٍ، تدفَّقنا إليها كمياهِ الجداول؟
ألأنَّنا صوّبنا أوردةَ عِشقِنا إلى غُدرانِها، ذبنا كالأشواق في دِنانِ الذكريات؟
تقول يومياتنا نيابة عنا: نحن حبر الألم المحروس في قيعان الجراح، نحن العسل المسموم في صحون أحلامنا... أمنياتنا نشيدٌ يطوي بطاح الذاكرة، وحداءٌ على مفارق اللهفة.
تقول يوميَّاتُنا: أضعنا نكهةَ السؤالِ عن أحوالنا، عن أجسادِنا، عن قاماتِ ظلالِنا. صَدئتِ الوعودُ والخطبُ. صدئتِ الرماحُ وأقواسُ النصر، تلاشتْ خصوصياتُ أصولِنا وفروعِنا، فاجتمعنا على أملٍ أضناه الإنتظار.
تسألُ: هل لا زلنا هدير الحقدِ المنقوعِ في المِرجل...؟ تجيب: ما الحقدُ، ما الحبُّ... أصفتانِ نُذرّيهما على شموسِ الجهات، أم شهوتانِ نقطفهُما عن أفنانِ الضلوع؟
لا بأس، فللحقدِ نرجسُهُ الملذوع بجمرِ الفصولِ العاقرة. للحبِّ عصافيرُهُ المحلِّقة بين المخالبِ المسنونة....
تجيبُ يوميّاتُنا: فوق راحاتِنا نوقدُ مشاعلَ الملحمة، ولا ضَيرَ إن اكتوتْ أصابعُنا بلهيبِ القسَم.
تخاطبُ يوميَّاتُنا الرصيفَ: أيها المتسكِّعُ على خصور المدائنِ والعواصم، اعتقدنا أنك تشبهُ أحلامَنا! وحدكَ تطرّزُ اليمامَ على مناديلِ العاشقين، تمسحُ الحزنَ بأطرافِ قمصانِ الملائكة، ثم تضمُّ يديكَ على نارِ الوعد المتبقي من نُتَفِ الوجوهِ الحائرة.
أيها الرصيفُ: أنظرْ إلينا، تمعَّنْ في الأسرار التي تتوهَّجُ بين ضلوعنا... نحن شعبُ المؤقَّت يا صديقي...
أنظرْ:
وُلِدنا في ظرفٍ مؤقَّت.
أقَمنا في بيوتٍ مؤقَّتة.
كبِرنا وهرِمنا مؤقَّتاً.
أشعلنا قناديل السَّمر المؤقتة... وحدها الطعنات في قلوبنا، أصيلة... أصيلة.
الزواجُ مؤقت، والتوالد والإنتظارُ... والذلُّ المسلولُ فوق أعناقِنا... المؤقَّتُ صنعتنا.
نحن ممنوعَون من الإنتماء إلى الأماكن... ثقيلة على أجسادنا الأماكن.
وأحلامنا ممنوع أن ترتاحَ من التيه... من التشظي.
نحن الذين لا ظلال لقاماتنا... آخر ودائع المنافي.
تُقلقُنا أنصافُ الأحلام... تخيفُنا إن لم تتَّسعْ لها غفوةُ الآخرين ويقظتهم!...
حتى شواهد قبورنا مؤقَّتةٌ يا صاح.
ما أهونَ تجوالنا بين الأمكنةِ... ما أصعبَها، كلٌ مِنَّا يمتطي جسدَهُ وطنًا ومركبًا، يجري به إلى ميناء يشتهيهِ أو يختلسُ منهُ موطِئاً... ولو مؤقَّتاً.
ما أصعب أن نهرِّبَ أجسادَنا، وما أسهلَ أن نخافَ من ألوانِها! شهيٌّ مذاق المنفى على موائدنا... طريٌّ لحمنا على الأسنَّة.
إقرأ أيها الرصيفُ حكايتَنا، تفرَّسْ في وجوهِنا وملامِحِنا، حكاياتِنا وشعرِنا... بيوتُ الصفيح حضارتنا... قصورُ وحينا وإبداعِنا... المَللُ يُرتـلُ أهازيجَه في أزقَّةِ مخيَّماتنا، إقرأ عن زواريبَ تضيقُ بأنفاسِ عابريها... تضيق على الموتى العابرين إلى مثاويهم... المؤقتة.
إقرأ أيها الرصيف ملاحم الحارسينَ بقايا كبريائِهم... إن الكبرياء سجين أجسادٍ غريبة..
قال صديقي الفلسطيني:
فجأة تكتشفُ اليوميَّاتُ غُربَتها عن الرصيف. تُصابُ بدوّار الحقيقة، فتشرِّعُ للتنهُّدِ حناجرَها. تكتشفُ الفارقَ بينها، فالرصيفُ ينتسبُ غالباً لهمسٍ لذيذٍ بين ساعِدينِ متشابكين، لقُبَلٍ بكرٍ تنضجُ على شفاهٍ شقيَّة. تكتشفُ إيقاعاً مُنسَّقاً بين الخُطى وشهقةِ الشمسِ الأخيرةِ حين يشفـُّها النعاسُ، بين الخُطى وبدرٍ تجلبَبَ هالتَهُ لكي يبعثرَ على الوجنات أريجَ مراياه.
كم قلت للرصيفَ: هنيئاً لكَ وأنتَ مزيّنٌ أعناقَ المدائن وجهاتها، إنك المسافة بين النور المغنج بالبلّور وبين أبراج حمام المخيّم الزاجل في هدأةِ انتظاره. يكفينا معانقةَ زُهدِنا المعتَّقِ في مؤقَّتنا الملعون... في دهاليزِ انتظارنا.
شحَّتْ حكاياتُنا الجميلة، بعضُ نتفٍ صارت، نحكيها لأطفالِنا وأحفادِنا عن قوّةِ الأحلام، عن سحرِها الذي أدمنَّاهُ، هي زهورُنا الشامخةُ بزهوِها الناريِّ، تُغازلُ مقاليعَ الفتيةِ وشررَ الغضبِ الناشبِ من حَدقاتهم...
أحلامُنا سنابلُ أشواق الحقول، ثرثرةُ الصباحاتِ للبراري الكَتوم، هي أسطورةٌ أخرى عنا- عن فلسطينيٍّ يُشجّرُ يوميَّاتهُ... يبتكر جنَّة وعدهِ، يكتبها على رُقَع الجوارح... ثم يمضي إلى يوم آخر...
لعنة المؤقت
19-05-2016
مشاهدة: 9014
محمد سرور












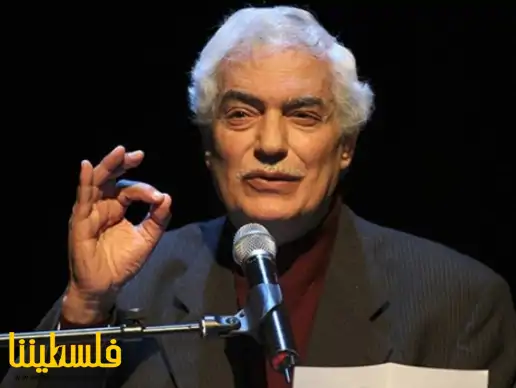





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها